شهوة التصحيح القاتل عند محمد بن عبد الوهاب
3 نوفمبر، 2025
الوهابية ومنهجهم الهدام
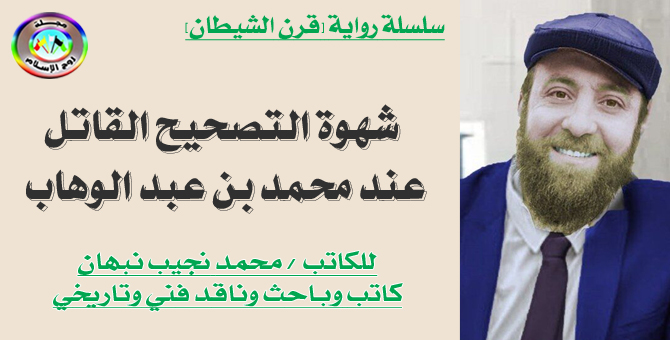
المقال الثانى عشر من سلسلة رواية (قرن الشيطان)
للكاتب / محمد نجيب نبهان
كاتب وباحث وناقد فني وتاريخي
سكين العقيدة:
لم تكن السنوات الأولى من تحالف محمد بن عبدالوهاب مع آل سعود سوى بداية لانحدار طويل في منحدرٍ شديد الانحدار، حيث امتزجت النصوص الدينية بالسيوف، والعقيدة بالدولة، والتوحيد بالدم.
في تلك المرحلة التي تبعت إعلان درعية الدعوة رسميًا، بدأت ملامح رجل جديد تتشكّل في وجه الشيخ. لم يعد ذلك الفقيه الغاضب الباحث عن نقاء العقيدة فحسب، بل رجلٌ يُصغي للأرض وهي تميد تحت قدميه، ويستشعر نشوة من يملك الكلمة التي تصدر الأوامر وتُحرّك الرجال وتُبقي النساء خلف الجدران.
كل ذلك، وكان أبناؤه من حوله، يراقبونه عن قرب.
كان عبد الله، أكبر أبنائه، يحفظ مؤلفات والده عن ظهر قلب، يُعجب بها، لكنه يتردّد أحيانًا في قلبه حين يرى كيف تُستعمل.
وكان حسين، أكثرهم تهوّرًا، يحمل سيفًا أكثر مما يحمل محبرة، يرى في دعوة والده سلطة يجب حمايتها بأي ثمن.
أما إبراهيم، فكان متديّنًا هادئًا، شديد الولاء لوالده، لكنه أقلهم اقتناعًا بالعنف.
وكانت زوجته – امرأة من آل مشرف – قد أصبحت نادرة الظهور، بعد أن ضاق عليها البيت بالزوار والفتاوى والنقاشات التي لا تهدأ.
وأخوه سليمان، ذلك الفقيه الذي خالفه لاحقًا، كان في تلك السنوات لا يزال مترددًا، يميل مرة نحو النصوص، وأخرى نحو السكون.
الشيخ لم يكن يرى في بيته عائلة بقدر ما رآه مَدرسة. كل منهم كان تلميذًا، أو جنديًا، أو مشروع قاضٍ في دولته الوليدة.
لكن خلف الأبواب، لم تكن الحياة كما تبدو في خطبه.
في أحد أيام صيف 1747، بينما كانت الدرعية تتقلّب بين الجفاف ونذر الغارات، كان محمد بن عبدالوهاب جالسًا في مجلسه، يكتب بخطّ واضح: «باب في وجوب هدم القباب المبنية على القبور».
دخل عليه أحد خواصه من التلاميذ، يحمل رسالة من أحد شيوخ الإحساء، فيها نقد لاذع لما سمّاه «التسرّع في التكفير، ونزع القدسية عن رموز الأمة».
قرأها الشيخ، ثم وضعها جانبًا، وقال لتلميذه: – «أكثر ما أخافه على هذه الأمة: الشرك في صور المحبة».
ثم نظر في عينيه مباشرة، وأضاف: – «إن لم نقطع هذا الداء من جذوره، سيعود علينا بلونٍ جديد، قد يلبس التشيّع أو التصوّف أو حتى الزهد، لكنه يبقى شركًا».
هزّ التلميذ رأسه، لكنه لاحظ ارتعاشة خفيفة في يد الشيخ. كان ذلك المرض الخفي، الذي بدأ يزحف على أعصابه، وإن لم يعترف به.
في نفس الليلة، استدعاه محمد بن سعود، الذي بدأ يُظهر بوضوح حاجته إلى دعم أكبر من رجال القبائل المترددة، فأراد من الشيخ إصدار فتوى تُكفّر كل من لم ينضم إلى سلطته، مستندًا إلى «البيعة الشرعية».
هنا، وقف الشيخ طويلًا عند حدود خطيرة.
فبين الدين والدولة كان هناك جدارٌ رقيق، قد يُهدم بفتوى واحدة. لكنه كتبها.
في فتوى قصيرة، قال فيها:
«من دعا إلى طاعة غير الإمام الشرعي، فهو باغٍ، ويُقاتل حتى يعود».
ولم يُسمِّ الإمام، لكنه أرسلها مع رجال ابن سعود.
في البيت، كانت زوجته تقرأ كتابًا في العتمة، تهمس بدعاءٍ طويل، يتقاطع فيه اسم الله واسم زوجها. كانت تعرف أن محمدًا صار رجلًا آخر. تراه في المجلس يحكم، ويُقسّم، ويُدير الرجال كما لو كان نبيًا، لا شيخًا.
وفي إحدى الليالي، سألته: – «ألا تخشى أن تختلط عند الناس دعوتك بالله نفسه؟»
فردّ دون أن يلتفت: – «إنما نخاف أن يختلط عندهم الشرك بالطاعة».
فقالت: – «لكن الناس يخافونك، لا الله.»
صمت.
وفي الصباح، طلب من أحد أبنائه ألا تجلس أمهم كثيرًا مع الخادمات. «الكلام الذي يُقال يُنقل».
كان يشعر أنه مُحاصر من جهتين: من أعداء الخارج، ومن الداخل الذي لا يفهم حماسته.
ثم جاءت حادثة القصيم.
أرسل أحد تلاميذه إلى هناك لينشر الدعوة، فقابله أحد القضاة المحليين بردّ عنيف، ورفض علني لفتاويه.
جاء الرد من الشيخ سريعًا:
«من لم يُنكر الشرك، فقد رضيه. ومن رضي الكفر فقد كفر».
فوقعت أول معركة دموية هناك. قُتل العشرات. قيل إنها معركة توحيد، وقيل إنها أول فتنة داخلية باسم الدين.
وبينما كانت الرسائل تنهال عليه تأييدًا أو رفضًا، كتب في دفتره:
«إن الشرك أوسع مما يتصور الناس. وربما يدخل الرجل فيه دون أن يدري».
ثم أضاف هامشًا:
«ولا يُشترط إقامة الحجة على كل فردٍ فرد، إذا عمّت البلوى، وصار المعروف منكرًا والمنكر معروفًا».
كانت تلك الجملة قنبلة موقوتة، ستنفجر لاحقًا في كل عقل متشدد.
في زاوية البيت، كان عبد الله يُعيد نسخ كتب والده بخط جميل.
همس مرةً لأخيه: – «هل تظن أن كل هذا الحق؟»
فقال حسين: – «من قال إن الحقّ لا يكون في السيف؟»
ضحك عبد الله وقال: – «لكن أبي لا يحمل السيف، فقط القلم».
فردّ حسين: – «لكنه يُشير بالسيف حين يكتب».
وكانت تلك العبارة تلخّص كل شيء.
في نهاية ذلك العام، أعلن الشيخ أن كل من لا يُجدد بيعته للدعوة، فهو في حكم الجاهلي.
كتبها في منشور، وعلّقه على أبواب المساجد.
ثم جلس في عزلته، ينظر إلى يده التي تكتب.
كانت ترتجف.
تذكّر قول والده عبدالوهاب قديمًا: – «إن أعظم سكين تُغمد في الدين… هي سكين المغرور بعلمه.»
لكنه أطفأ المصباح، وقال في نفسه: – «بل المغرور هو من رأى الباطل وسكت.»
ثم نام، وفي الحلم… رأى نفسه واقفًا على جبل، تحته نار، وفوقه سماء، والناس بينهما. وكان هو يصرخ: – «إني أُنقذكم!»
لكنهم كانوا يهربون منه، لا إلى الله.
الدين أم أنا؟
حين أغلق محمد بن عبدالوهاب دفتراً من دفاتر الشك، لم تكن النار قد خمدت. بل لعلها ازداد اشتعالها، نار لا تُرى في العين، لكنها تتآكل في الجوف. تلك الليلة، غفا متعبًا على الأرض الطينية لغرفته، شبح القلم في يده، وعباءة ملقاة فوق كتفيه كأنها أثقل من كل ما كتب. لكن النوم لم يدم. كان ضجيج الأسئلة في رأسه أعتى من صمت الليل.
قام في الفجر وقلبه متخم بصوتٍ واحدٍ يتكرر: “هل أقاتل من أجل الله، أم من أجل نفسي؟ هل دعوتي هذه دين… أم رغبة في أن أكون فوق الجميع؟”
منذ أن كان صغيرًا في العيينة، كان مختلفًا. أخوه سليمان، الفقيه الحنبلي، كان أكثر اعتدالًا، أقل توترًا في حسم القضايا. لطالما دار بينهما جدل حول التكفير، حول التدرج في الإنكار، حول فقه المقاصد. لكن محمد كان يميل دائمًا إلى الحسم، إلى الحدود الواضحة. كان يقول: “الدين لا يحتمل الميوعة. الوحي حاسم، فلماذا نغرقه في التأويل؟”
في شبابه، قرأ كتب ابن تيمية حتى حفظها عن ظهر قلب، وانبهر بصلابته، بجرأته في مواجهة السلطة، ولكن أيضًا بقدرته على أن يجعل من العلم سلطة. لاحقًا، كان يشعر أن تلك القدرة قد انتقلت إليه. ومع كل فتوى يصدرها، ومع كل تلميذ يكتب عنه، كان يشعر أنه يكبر. يكبر على العلماء، على الفقهاء، على القضاة. يكبر حتى على الملوك. وكان يسأل نفسه: “هل أنا صاحب فكر… أم مشروع دولة؟”
بدأ في تلك الفترة ينظر إلى من حوله نظرة المراقب، لا المشارك. حتى أهله تغيّروا في عينه. زوجته فاطمة، التي كانت تستمع له وتصغي لتقلباته الفكرية في البداية، بدأت تنأى. كانت تخاف من تصاعد حدة نبرته، من تلك النظرة التي في عينيه كلما تحدّث عن “تطهير الدين”. كانت تقول له أحيانًا: “يا محمد، الناس بشر، لا نصوص. وقد يعبدون الله من حيث لا تدري.” فيسكت، ويقوم إلى زاويته، كمن يخشى أن يسمع أكثر.
أبناؤه أيضًا بدأوا يشعرون بأنه أكثر أبوةً للفكرة من الأبوة لهم. كان يغيب أيامًا، ينتقل بين القرى والواحات، يتحدث في المساجد والساحات، يكتب الرسائل إلى الأمراء والفقهاء، يناقش ويكفّر ويحرّض ويشرح ويؤسس. كل شيء في حياته صار دعوة. وكل ما ليس كذلك، بدا له فائضًا عن الحاجة.
حتى أخوه سليمان، الذي كان يجلّه ويحترمه في طفولته، انقلب عليه لاحقًا. كتب فيه رسائل يرد عليه فيها، ويحذّر من غلوّه. كتب يقول: “إن أخي يرى الكفر في كل مخالفة، ويهدم أعمدة المذاهب الأربعة، ويجعل من نفسه مرجعًا وحيدًا لا يزاحم.”
ذلك الجرح الأخوي لم يكن عاديًا. محمد كان يعرف أن سليمان لا يجهل الدين، ولا يطعن في التوحيد. لكنه اختلف معه، فقال فيه ما قال. وكان يبرر ذلك في قلبه بأن الدعوة أكبر من الإخوة. ولكن الحقيقة التي لم يكن يريد الاعتراف بها هي أنه كان يرى نفسه مركز الدائرة.
في تلك الأيام، بدأت تصل إليه أخبار عن تلاميذه الذين ذهبوا ينشرون دعوته: بعضهم أصبح يقيم الحدود دون إذن، وبعضهم كفّر أئمة المساجد، وبعضهم منع الناس من زيارة قبور آبائهم، وبعضهم أحرق كتبًا بأكملها. وكان كل ذلك يُنسب إليه. وكان أحيانًا يرفض، وأحيانًا يصمت. وكان يقول في نفسه: “هل صنعتُ هذا بيدي؟ هل كانت كلماتي وقودًا لنارٍ لا أستطيع الآن إطفاءها؟”
جلس إلى تلميذه حسين بن غنام، وكان من أذكى من تتلمذ عليه. قال له: “يا شيخ، أنت دعوتنا إلى توحيد الله ونبذ البدع، ولكن الناس يروْننا اليوم نكفّر كل من خالفنا. ألا ترى أن الأمر اتّسع؟”
فأجابه محمد: “إذا لم يُغلق الباب، دخل منه كل فساد.”
فقال حسين: “لكننا أغلقنا كل الأبواب، ولم نترك سوى نافذتك.”
لم يُجب محمد. كان يعرف أن كثيرًا من مريديه بدأوا يرونه لا مجرد داعية، بل مرجعية مطلقة. وكان أحيانًا يشعر بنشوة لذلك، وأحيانًا بخوفٍ عظيم.
في إحدى ليالي تلك الفترة، كتب في دفتره:
“اللهم إن كنتُ جعلتُ الدين وسيلةً لأعلو، فاكسرني. وإن كنتُ ظننتُ أني أحمي دينك، فذكّرني أن دينك لا يحتاج إلى عبدٍ ضعيف مثلي. وإن كان قولي حقًا، فاجعلني لا أضلّ به أحدًا، ولا أُعجب به نفسي.”
ثم طوى الدفتر.
خرج في الصباح إلى المسجد، الناس ينتظرونه. ألقى درسًا في التوحيد، لكنه كان أقل حدة من المعتاد. حدّثهم عن الرحمة، عن النية، عن أن الله يُمهل ولا يُعجّل. قال له أحدهم بعد الدرس: “يا شيخ، خفتَ؟” فأجابه: “بل خفتُ أن أضلّكم وأنا أحسب أني أهديكم.”
ذلك الصباح، لم يشعر أنه ينتصر. بل شعر أنه بدأ يفهم.
لكن السؤال الذي ظل يلازمه كل يوم:هل أنا أدعو إلى دين الله؟ أم إلى صورة الله التي رسمتها في نفسي؟
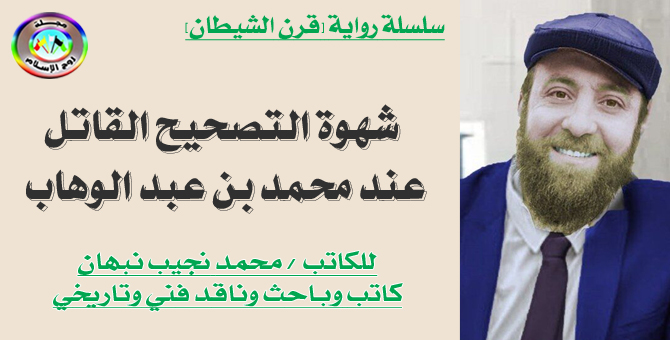
 مجلة روح الاسلام فيض المعارف
مجلة روح الاسلام فيض المعارف