المعتزلة والوهابية، عقلٌ كفّر الأمة وسيفٌ ذبحها
26 أغسطس، 2025
الوهابية ومنهجهم الهدام
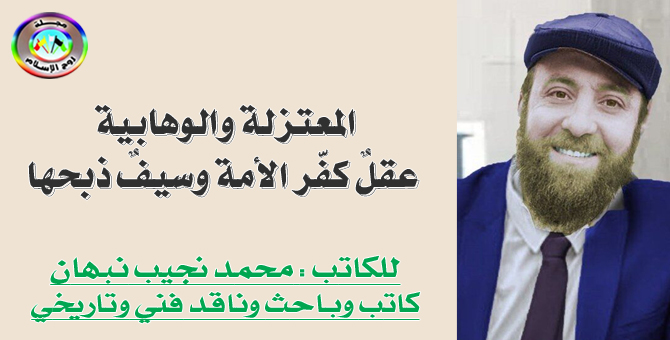
بقلم : محمد نجيب نبهان
كاتب وناقد و باحث تاريخي
حين نتأمل تاريخ الفرق في الإسلام، نجد أن بعض الحركات التي نشأت بدعوى الإصلاح، لم تلبث أن تحولت إلى فتنة عظيمة قلبت موازين الاجتماع الإسلامي، وأحدثت انشقاقات فكرية وسياسية ما زالت الأمة تعاني من تبعاتها إلى اليوم. ومن أبرز تلك الحركات: المعتزلة في العصر العباسي، والوهابية في العصر الحديث. فالمعتزلة كانوا أبناء البصرة العقلانيين الذين رفعوا راية التوحيد والتنزيه حتى غلوا في التنزيه فوقعوا في النفي، والوهابية أبناء نجد الذين رفعوا راية محاربة الشرك والبدع حتى غلوا في الظاهر فوقعوا في التشبيه والتكفير. وبين المدرستين تتقاطع الخيوط وتتشابه النتائج، على اختلاف الأدوات والظروف التاريخية.
بدأت المعتزلة مع واصل بن عطاء حين خرج من حلقة الحسن البصري، معلناً أن مرتكب الكبيرة لا يُعد مؤمناً ولا كافراً بل في منزلة بين المنزلتين، فانشق عن أستاذه واعتزل مجلسه، فسموا هم وأتباعه “معتزلة”. من تلك اللحظة الصغيرة التي قد تبدو عابرة في مدرسة من مدارس البصرة، انطلقت فكرة ستصبح تياراً فكرياً منظماً يحمل أصولاً خمسة صارت فيما بعد دستوراً لمذهب كامل. أخذ المعتزلة ينحتون فكرهم من تزاوج العقل بالوحي على طريقتهم، فغلب عندهم سلطان العقل حتى صار حكماً على النص، فإذا تعارض العقل مع ظاهر الكتاب أو السنة قدّموا العقل وأولوا النصوص بما يوافقه. هذا المنهج جعلهم يدخلون في معارك طويلة مع خصومهم من أهل الحديث والأشاعرة لاحقاً، وفتح أمامهم أبواب الجدل مع الفلاسفة والزنادقة وأهل الملل الأخرى.
أما الوهابية فقصتهم مختلفة من حيث النشأة، متشابهة من حيث النتيجة. محمد بن عبد الوهاب، رجل من نجد، تأثر بالآثار الظاهرية وبمدرسة ابن تيمية وابن القيم، ورأى أن الأمة غارقة في الشرك والبدع من زيارة القبور والموالد والتوسل، فرفع شعار “تجريد التوحيد”، وجعل من تكفير المخالفين من المسلمين وسيلة لتمكين مشروعه الديني. لم يكن ابن عبد الوهاب وحده في الميدان، بل عقد حلفاً مع محمد بن سعود أمير الدرعية، فتحول المذهب إلى سيف مسلول، وصار الدين غطاءً للمشروع السياسي التوسعي الذي مزّق الجزيرة العربية وأسال الدماء في الحجاز واليمن والعراق والشام. وكما وجد المعتزلة سندهم في السلطة العباسية، وجد الوهابيون سندهم في آل سعود، فكان السلطان هو الساعد الذي مكنهم، وكانت العقيدة هي اللافتة التي تشرعن سفك الدماء وقمع المخالفين.
المعتزلة بنوا عقيدتهم على خمسة أصول، ظاهرها الحرص على صفاء التوحيد والعدل الإلهي، لكن باطنها أفضى إلى نتائج خطيرة. قالوا إن الله لا يوصف إلا بما هو من ذاته، فلا صفات قائمة به زائدة على ذاته، فنفوا الصفات القديمة كالقدرة والعلم والإرادة، وجعلوا إثباتها تعدداً في القدماء. ومن هنا جاء قولهم بخلق القرآن، إذ لا يعقل عندهم أن يكون القرآن قديماً مع الله في الأزل. كذلك بالغوا في عدل الله فقالوا إن الإنسان حر مختار بالكلية، وإن الله لا يخلق الشر ولا يقدر على ظلم أحد، فكانوا أقرب إلى الجبرية المعكوسة؛ أي جعلوا قدرة العبد مطلقة حتى سلبوا الله مشيئته في أفعال عباده. ثم تمسكوا بالوعيد فجعلوا العصاة من أهل الكبائر مخلدين في النار إن ماتوا بلا توبة، ولم يجيزوا الشفاعة إلا بشروط ضيقة. ومن هنا جاءت “المنزلة بين المنزلتين” التي أخرجت مرتكب الكبيرة من دائرة الإيمان، ولم تدخله في دائرة الكفر، بل جعلته في منزلة برزخية. وأخيراً جاء أصلهم الخامس “الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر” ليبرر لهم الخروج على الحكام إذا رأوا انحرافاً، فصار مبدأً للحراك السياسي بقدر ما كان قاعدة أخلاقية.
الوهابية على الجهة الأخرى، لم تكن عقلانية ولا فلسفية، بل كانت ظاهرية خشنة، تنزع النص من سياقه وتطبقه بظاهره دون فقه أو روح. أثبتوا لله صفات الأعضاء والجوارح: اليد والوجه والنزول والاستواء المكاني، وقالوا إنها “حقيقية لا مجاز فيها”، وإن كانت “بلا كيف”، فوقعوا في التشبيه الذي زعموا أنهم يحاربونه. ضيقوا مفهوم التوحيد إلى أقصى حد، فجعلوا كل مظاهر التوسل أو طلب الشفاعة شركاً أكبر يخرج من الإسلام. كفّروا عامة الأمة من الصوفية والأشاعرة والماتريدية، بل ورأوا دماء المسلمين حلالاً، فاستباحوا الطائف وكربلاء وهدموا القباب والقبور، وأزهقوا أرواح الآلاف تحت لافتة “الجهاد”. جعلوا الشفاعة منكرة إلا على نحو ما يوافق مذهبهم، وأنكروا كرامات الأولياء، وحوّلوا الإسلام من فضاء رحب مليء بالتنوع الروحي والفكري إلى سجن ضيق تحرسه سيوف التكفير.
وإذا كانت فتنة المعتزلة قد تجلت في محنة خلق القرآن، حيث أُجبر العلماء بالقوة على القول بخلق القرآن، فإن الوهابية كانت فتنتهم أوسع دموية وأشد فتكاً؛ إذ لم تقتصر على سجن العلماء وتعذيبهم، بل تعدّت إلى استباحة المدن والقبائل وإراقة الدماء بالجملة. المأمون العباسي رفع راية المعتزلة ليضبط العقيدة الرسمية للدولة، فصارت المذاهب الأخرى عرضة للاضطهاد. ومحمد بن سعود رفع راية الوهابية ليبسط سلطانه في الجزيرة، فصار كل من يخالف دعوة محمد بن عبد الوهاب مشركاً يقتل وتستباح أمواله ونساؤه. وهكذا التقت المدرستان في جعل العقيدة مطية للسلطة، وإن اختلفت طبيعة العقيدة نفسها.
وجه الشبه العميق بينهما هو احتكار الحقيقة. المعتزلة زعموا أن العقل وحده هو الميزان الصحيح، ومن خالفه وقع في التجسيم والشرك. والوهابية زعموا أن فهمهم الخاص للنص وحده هو الميزان، ومن خالفه وقع في الشرك الأكبر. كلاهما نصب نفسه حارساً على العقيدة، ومنح نفسه الحق في تكفير الأمة وإخضاعها بالقوة. كلاهما استند إلى حاكم قوي يمنحه الشرعية ويحميه بالسيف. كلاهما أوجد فتنة جعلت الإسلام في نظر الآخرين دين قهر وإكراه، لا دين رحمة وسعة.
وإن كان المعتزلة قد غلوا في العقل حتى أنكروا ظواهر النصوص، فإن الوهابية غلوا في الظاهر حتى أنكروا العقل. وإن كان المعتزلة قد ابتلوا الناس بمحنة فكرية، فإن الوهابية ابتلوا الناس بمحنة دموية. وكلاهما أضرّ بصورة الإسلام، فأمام الفلاسفة وخصوم الدين ظهرت صورة الإسلام عند المعتزلة ديناً متناقضاً مع نفسه، يعذب العلماء ويقسرهم على قول لا دليل عليه إلا تأويل عقلي. وأمام العالم الحديث ظهرت صورة الإسلام عند الوهابية ديناً متوحشاً يهدم القبور ويقتل الأطفال والنساء باسم التوحيد.
والفارق أن المعتزلة بقوا نخبة فكرية مرتبطة بالسلطان، ولم يتغلغلوا في وجدان العامة إلا بقدر محدود، وسرعان ما تراجعوا مع سقوط دولتهم الحامية. أما الوهابية فقد تمكنوا من بناء دولة كاملة استمرت حتى يومنا هذا، وصار مذهبهم ديناً رسمياً في الجزيرة العربية، فأثرهم أشد رسوخاً ودماراً على المدى الطويل.
من يقرأ تاريخ المدرستين يلحظ أن الإسلام كان دائماً يتسع لمذاهب وآراء متباينة، لكن الفتنة لا تقع إلا حين يتحول الرأي إلى سلطة قاهرة، وحين يحتكر فريق واحد حق تفسير الدين ويفرضه بالقوة على الناس. المعتزلة كانوا عقلانيين فانتهوا إلى نفي صفات الله وإلى القول بخلق القرآن، والوهابية كانوا نصيين سطحيين فانتهوا إلى تشبيه الله بخلقه وتكفير عباده. كلاهما رفع راية التوحيد، لكن التوحيد عند الأول صار نفياً وتعطيلاً، وعند الآخر صار تشبيهاً وتجسيماً. وكلاهما رفع راية الإصلاح، لكن الإصلاح عند الأول تحول إلى محنة فكرية قاسية، وعند الآخر تحول إلى دماء مسفوكة وبلاد مدمرة.
وهكذا، فإن فتنة المعتزلة والوهابية معاً تمثل درساً بليغاً في خطورة الغلو والانغلاق، وفي ضرورة أن يظل الإسلام رحباً كما جاء به نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم، ديناً جامعاً لا يضيق بالاختلاف ولا يحتكر الفهم ولا يشرعن العنف باسم الله.
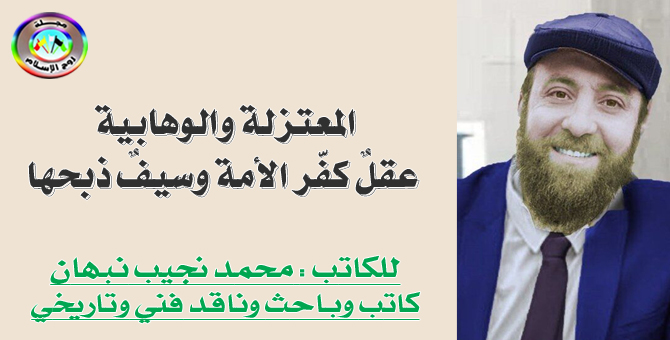
 مجلة روح الاسلام فيض المعارف
مجلة روح الاسلام فيض المعارف