مذهب ابن عبد الوهاب في ميزان علماء الجزيرة
14 أغسطس، 2025
الوهابية ومنهجهم الهدام
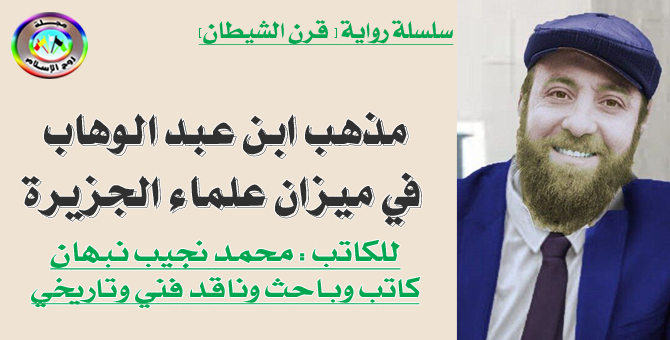
المقال السادس من سلسلة رواية (قرن الشيطان)
للكاتب / محمد نجيب نبهان
كاتب وباحث وناقد فني وتاريخي
مرآة الغربة ـ نداء الطريق :
كان محمد بن عبدالوهاب قد خرج من الدرعية، لا مطرودًا ولا مغلوبًا، بل هائمًا في فكرة تزداد قسوة كلما اتسعت رؤيته. رحيله لم يكن فرارًا، بل كان الخطوة الأولى في جهادٍ يتصوره داخليًا: جهاد ضد التراخي الديني، ضد التوسل، ضد الأضرحة، ضد «كل من لا يعبد الله كما أعبدُه». لقد شعر أن بقاؤه سيقتله من الداخل، ولن يشفي تلك الرغبة التي تنمو بداخله لتقويم الدين بأداة حادة.
في الطريق إلى الرياض أولًا، كان الغبار يغلف السماء، والبعير يهدر من الإرهاق، وهو ممتطٍ سروجًا قديمة، لا يرافقه سوى كتبه وقليل من الزاد. كان الليل يوشك أن يهوي على الأرض حين لمح قبة مسجدٍ بعيد، فقال في نفسه: “كم من الناس يسجدون تحت هذه القبة وقلوبهم معلقة بسواها؟”. ولم يكن في عبارته استنكار بريء، بل نزعة إلى القتال، حتى لو لم يظهر ذلك بعد.
دخل بلدة صغيرة على أطراف نجد، وحين سُئل من أين أتى، قال: “من الدرعية، أطلب العلم وأدعو إلى ما أراه صوابًا”. لم يكن في صوته حذر، بل بدا فخورًا بمهمته، وبدأ يفتح حلقاتٍ صغيرة في المساجد، يحدّث الناس عن الشرك في القبور، ويهاجم التوسل بالأولياء، ويشرح التوحيد على طريقة ابن تيمية لا على ما اعتادوه.
جلس إليه شاب اسمه سالم بن جابر، وسأله بعد أحد الدروس:
– يا شيخ، ولكن أمّي تدعو الشيخ عبدالقادر الجيلاني، وهي صالحة تحج وتصوم، فهل هي مشركة؟
نظر محمد إليه بعينين صارمتين، ثم قال:
– الشرك لا يُمحى بالصلاح، وما أكثر من يصلّون وهم على شرك، بل ما أكثر من يحجون ويعبدون غير الله.
– لكنهم لا يعبدونه عبادة، بل يتوسلون به.
– وهل يعلم الغيب سواه؟ وهل يُرجى أحد معه؟ كلّ من صرف شيئًا من الرجاء أو الخوف لغير الله فقد ضلّ.
لم يكن النقاش عند محمد بحثًا عن الحقّ، بل كان تثبيتًا لرؤية، وفرضًا لمنهج. وقد بدا له الشاب مستعدًا لأن يتغير، فقال له:
– اترك عنك ما وجدت عليه آباءك، واتبع ما أقول، فإن في ذلك النجاة.
ومع مرور الأيام، صار لسالم أتباع، وبدأت في البلدة الصغيرة حركة غريبة: حلقات تشتد، نقاشات تنقسم، أناس يهجرون المساجد ذات القباب، وآخرون يتوجّسون من القادم الجديد.
سمع أحد الشيوخ الكبار في البلدة، وكان ضريرًا يُدعى الشيخ مبارك، عن هذه الحركة الجديدة، فأرسل إلى محمد طالبًا لقاءه. لم يتردد محمد، وجاءه بعد صلاة العشاء. كانت الغرفة معطّرة بخشب العود، والشيخ يجلس على سجادة قديمة، يحيط به تلاميذه.
قال الشيخ:
– بلغني عنك يا ولدي أنك تُكفّر من توسل بالأولياء.
رد محمد:
– لا أكفّر الناس بأهوائي، بل بدليل.
– وهل ترى أن كل من قصد قبرًا للصالحين فقد أشرك؟
– إن قصد به الدعاء والرجاء، نعم.
– ولكن العلماء اختلفوا، وهذه مسائل اجتهادية.
– وهل الاجتهاد في التوحيد مباح؟ ألا ترى أن الاختلاف في أصل الدين خطر؟
هنا ابتسم الشيخ الضرير وقال:
– بني، لقد كنتُ مثلك في شبابي، أرى الأمور حادة كالسيف، ثم عرفتُ أن في الدين رحمة، وأنّ الله لم يجعلنا قضاة على عباده بل دعاة.
لكن محمد لم يقتنع. رأى في كلام الشيخ ضعفًا، وفي نبرته تمييعًا للحق. وشعر لأول مرة أن العلم وحده لا يكفي، بل يحتاج إلى سلطة تسنده، إلى قوة تفرضه.
وبعد أسابيع، غادر محمد تلك البلدة، وقد ترك خلفه شقوقًا بدأت تتسع. سار نحو الحجاز، لا للحج، بل للعلم ولرؤية الواقع. هناك، في مكة، صُدم بمظاهر الدين كما تُمارس: حلقات تحوي متكلمين وفلاسفة وصوفيين من كل صوب. رأى أناسًا يطوفون ويدعون قبور الأولياء، ويسألونهم الشفاعة، وسمع خطبًا لا علاقة لها بالتوحيد كما فهمه، فاشتد في قلبه الغضب.
في المدينة، حاول أن يدخل حلقة من حلقات علم الحديث، فطُلب منه أن يُعرّف بنفسه، فقال:
– محمد بن عبدالوهاب، من نجد، أطلب العلم، وأدعو إلى تنقية الدين من البدع.
فردّ عليه أحد الطلبة ساخرًا:
– وهل أنت وحدك من يعلم البدع من السنن؟
لكنه لم يرد، بل اكتفى بالابتسام.
أقام في المدينة شهرًا، ثم انتقل إلى البصرة، حيث رأى عجبًا من أمر الناس، وقد كثرت الطرق، وتعددت الرايات، وعلت أصوات الخلاف. دخل مسجدًا فوجده مزينًا بالألوان والرايات، فلما سأل عن ذلك، قيل له: “احتفال بمولد النبي”.
قال محمد: “ما هكذا كان دين محمد”.
وألقى في المسجد خطبة هاجم فيها الموالد والذكر الجماعي وزيارة القبور، فثار الناس عليه، وضربه أحدهم بعصا، وكاد يُقتل لولا أن أنقذه أحد شيوخ البصرة المعتدلين.
هرب ليلًا إلى خارج المدينة، ومكث أيامًا في خيمة بادية، يعيد ترتيب أفكاره. وهناك، على ضوء نار خافتة، كتب أول مخطوطة له، بعنوان: “كشف الشبهات”، كانت تحمل أولى ملامح منهجه المكتمل.
عاد بعدها إلى نجد، وقد صارت رؤيته أكثر وضوحًا: إن الإصلاح لا يكون إلا بالقوة، وإن الدعوة وحدها لا تكفي، وإن الكلمة ما لم تحملها السيوف، فهي صدى في صحراء لا تُنبت.
وكان في نفسه شيء لم يصرح به لأحد، لكنه عرفه تمامًا:
“أحتاج إلى أمير… وإلى جيش… وإلى بيعة تقلب وجه الجزيرة.”
وهكذا، لم يعد محمد بن عبدالوهاب مجرد شيخٍ من نجد.
بل صار مشروعًا ينتظر لحظة الانقضاض.
الرحيل إلى النار ـ شمس البصرة وأشباحها :
كان صباح البصرة ثقيلاً كأن الشمس فيه مريضة. حارة لكنها لا تضيء، عالية لكنها لا تمنح دفئاً داخلياً. حين وطئت قدم محمد بن عبدالوهاب تراب المدينة، لم تكن البصرة التي سمع عنها، ولا التي رسمها في خياله؛ كانت مدينة تعبث بها المتناقضات: فيها علم كثير، لكنها غارقة في الخرافة، وفيها مساجد كثيرة، لكن القلوب متشظية، وفيها وجوه عابسة تتكلم باسم الله، وقلوب خاوية تحوم حول القبور.
وصل محمد شاباً يحمل في قلبه غضباً دفيناً، وفي عقله معولاً يفتّش عن كل ما يمكن هدمه. لم يكن باحثاً عن معرفة بالمعنى التقليدي، بل عن وقود يُغذّي مشروعه الداخلي: أن يُصلح الدين كما يراه، أن يطهّره من الدنس الذي التصق به، كما كان يعتقد.
في أول أيامه، اتجه إلى حلقات العلم في المساجد، يتنقل من حلقة إلى أخرى. جلس إلى شيخ يُدرّس في الفقه المالكي، فاستمع لبعض الوقت ثم انسحب. لم تعجبه طريقة عرض المسائل، ولا النقاش المفتوح حول الخلافات. همس في نفسه: «الدين ليس حلبة نقاش… هو حسمٌ ويقين». وفي اليوم التالي، حضر حلقة في التصوف، وكان الشيخ يحدّث عن مراتب الذوق، وعن النور الباطني، وعن العروج الروحي إلى الحضرة. لم يكمل الساعة، إذ همس في أذن من بجانبه: «ما هذا؟ أهو درس دين أم قصة خرافية؟». همس الرجل: «يا فتى… هذا الشيخ من الأولياء، له كرامات مشهورة، الناس تُشفى على يده». فهز محمد رأسه بأسى، وقال بعد أن خرج: «بل الناس تمرض بعقله».
في أحد الأيام، جلس محمد في حلقة أحد كبار علماء البصرة، الشيخ عبدالرزاق الكباشي، رجل وقور، واسع الصدر، يُعرف عنه اعتداله وحكمته. وبعد الدرس، اقترب محمد وقال:
– يا شيخ، أراك تحدّث الناس عن المحبة والرجاء، ولا تذكر الخوف والعذاب إلا قليلاً. أما تعلم أن النار أقرب إليهم من جنّاتك؟
ابتسم الشيخ الكباشي، وقال بنبرة هادئة:
– بُني، إن الله جَعَلَ القلوبَ مفاتيح، لا أقفالاً. من دخلها بالحب ثبت فيها، ومن دخلها بالخوف فرّ منها متى هدأ الرعد.
فرد محمد:
– ولكن الناس غارقون في البدع، يطوفون بالقبور، ويطلبون من الأموات! ألا يستحقون أن يُرهبوا؟
رد الشيخ:
– نُرهبُهم من الغلط، لا من الله. الله أقرب إليهم من ظنهم، وعلينا أن نقرّبهم منه لا أن نطردهم.
لم يعجبه الرد، لكنه صمت. ومشى خارج المسجد يتمتم: «ما هكذا يُحمل التوحيد».
وكلما مرّ يوم، ازداد ضيقه. كان يرى الناس يُقبلون على قبور الأولياء بالدعاء والتوسل، وكان يشعر بغصة، كأنما تُذبح العقيدة أمامه. وفي أحد الأيام، وقف على مقربة من مقام مشهور في البصرة يُعرف باسم «مقام الشيخ علوان»، فرأى النساء تبكي، والرجال يتمسحون بالضريح. شعر أن الدنيا انقلبت.
قال في نفسه: «أي شرك أعظم من هذا؟ من يعبد الله لا يتوسل بميت، ومن أحب الله لا يبكي عند قبر مخلوق». ثم حدّق في الوجوه المبللة بالدموع، وبدأ يدوّن في ذاكرته: “أبناء الشرك ليسوا أعدائي، بل ضحايا. عدوي هو الذي علمهم هذا وسمّاه دينًا”.
لم يقتصر حضوره في البصرة على الحلقات، بل بدأ الناس يلاحظون حماسه وغرابة أفكاره. كان يناقش الشيوخ بحرارة، ويجادل الكبار دون وجل. وفي مجلسٍ حضره جمع من الفقهاء، دخل محمد في جدال طويل حول مشروعية التوسل بالأولياء. فقال أحدهم:
– التوسل جائز بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الأعمى: «اللهم إني أسألك وأتوسل إليك بنبيك». فما تقول؟
فرد محمد:
– كان حياً فيهم! أما التوسل بالميت فلا دليل عليه. والدين لا يُبنى على عاطفة أو موقف واحد، بل على التوحيد الخالص.
ضحك شيخٌ عجوز وقال:
– أراك صغير السن، لكنك تتحدث وكأنك شيخ الإسلام!
قال محمد بجدية مفرطة:
– بل أتحدث بما يرضي الله.
هنا بدأ الحضور يشعر أن هذا الشاب لا يشبه بقية الطلبة. البعض أعجب بجرأته، والبعض الآخر شعر بالخطر. وقد وصل صدى آرائه إلى بعض وجهاء المدينة، الذين أرسلوا في طلبه. في مجلس رسمي صغير، اجتمع بمحمد ثلاثة من وجهاء البصرة، بينهم شيخ متصوف، وقاضٍ معروف، وتاجر غني مهتمّ بالدين.
قال القاضي:
– يا بني، بلغنا أنك تُكفّر الناس وتطعن في المشايخ، فما شأنك؟
أجابه محمد:
– لا أُكفّر أحدًا بعينه، ولكن أُحذّر من الشرك. هل أنكرتم عليّ أن أقول: الله يُعبد وحده، ولا يُدعى غيره؟
قال الشيخ المتصوف:
– يا ولدي، لسنا في حرب معك، لكن طريقتك تُنفّر، والناس تُحب أولياءها، وتجد فيهم البركة.
قال محمد:
– وهل جعل الله البركة في غيره؟ وهل أمرنا أن ندعو الأموات؟ هذا دين جديد، وليس دين محمد بن عبد الله.
انفضّ المجلس دون نتيجة. وتكررت المواجهات. وبدأت أصوات تُنذر بأن هذا الشاب ليس مجرد طالب علم، بل ناقم يريد الهدم.
وفي أحد الأيام، جاءه رجل مسنّ من أهل السوق، معروف بتقواه، وجلس إليه طويلاً ثم قال:
– يا فتى، أعلم أنك غيور على الدين، لكن احذر أن تصير مثل النار، لا تضيء إلا بعد أن تحرق.
أطرق محمد رأسه وقال:
– النار لا تحرق المؤمنين.
قال العجوز:
– لكنها تحرق الحقول والبيوت إذا لم تُوجّه.
بعد تلك الحادثة، بدأ محمد يشعر بالعزلة. لم يجد من يستوعبه، ولا من يشاركه أفكاره. فبدأ يميل إلى الاختلاء، والكتابة، والمطالعة. ازداد تعلقه بابن تيمية، وراح يعيد قراءة مؤلفاته مرارًا. وذات ليلة كتب في دفتره:
«كل ما يفعله الناس بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لا بد من طرد الغبش من العقيدة، ولا مجال للهوادة. الله واحد، والدين واحد، والحق لا يتعدد».
وفي يومٍ شتويّ ممطر، بعد عام من وصوله، خرج محمد من المسجد، ووقف تحت المطر يحدّق في المئذنة القديمة. كانت تتآكل من الرطوبة، وتحمل شقوقاً في جسدها، فتمتم: «حتى المآذن في هذا البلد قد شاخت». وأكمل: «الناس يبنون الأضرحة، ولا يُصلحون بيت الله».
في تلك اللحظة، أدرك محمد أن البصرة، على عراقتها، لن تُنجب مشروعه. أنها أشبه بمقبرة للمعنى، وليست رحمًا لميلاد جديد. فبدأ يُفكر بالرحيل.
وفي المجلس الأخير له مع الشيخ الكباشي، جلسا سويًا في ظل نخلة عجوز قرب المسجد، وقال الشيخ:
– إلى أين ستمضي الآن؟
قال محمد:
– حيث أجد قلباً ينصت، وعقلاً لا يغلق الباب.
قال الشيخ:
– أم تخاف أن تُغلَق الأبواب كلّها، فلا يبقى إلا بابك؟
أجابه محمد:
– حتى لو أغلقت الأبواب كلّها… أنا المفتاح.
ابتسم الشيخ بأسى، وقال:
– المفتاح لا يفتح كل الأقفال، وبعضها إن فُتح… دمّر ما وراءه.
نظر محمد بعيدًا، ثم قام دون أن يودّع، ومضى.
هكذا غادر البصرة، وهو أكثر غضبًا، وأكثر عزلة، وأكثر اقتناعًا أن عليه أن يحمل النار معه إلى حيث سيُشعلها.
وكانت خطوته التالية… الأحساء.
المنعطفات الأولى ـ المذهب في الميزان:
منذ تلك اللحظة التي ودّع فيها محمد بن عبدالوهاب بيئته الأولى إلى العالم الرحب، كان في داخله صوت لا يهدأ، يقيس به كل فكرةٍ يسمعها، وكل مذهبٍ يطّلع عليه، وكل شيخٍ يجلس أمامه، بمسطرة صارمة: هل هذه عقيدة نقية أم مشوبة؟ هل هذا شرك مموه أم توحيد صافٍ؟
دخل البصرة مشبعًا بأفكار حنبلية جافة، مغروسة في تربة ابن تيمية وابن القيم، وعينه مسلطة على ما يسميه الانحرافات العقدية. هناك، في تلك المدينة العتيقة التي كانت يومًا ما ساحةَ صراعٍ بين المعتزلة والأشاعرة، بين الزهاد والمتكلمين، وجد أمامه خليطًا لا يرضي حماسه العقائدي: دراويش صوفية ينشدون المحبة، وفقهاء مالكية يميلون إلى الرخص، وعامة يتباركون بالمقامات، ويقبلون أيادي الأولياء الأموات.
كان طالبًا للعلم في الظاهر، لكنه في حقيقته كان يراقب الخصم، يدوّن سقطاته، يُعد عدته.
في البصرة، سمع لأول مرة عن عبدالقادر الجيلاني، واطلع على بعض أوراده، فهاله أن يكون الناس يعدّونه قطبًا روحانيًا تُقضى الحوائج باسمه. وذات مساء، دخل مسجدًا صغيرًا تابعًا لطريقة قادريّة، وهناك رأى جمعًا من الدراويش يهتزون ويصرخون ويرددون: “يا غوثَ الزمان، يا عبدالقادر!”، فأصابته قشعريرة. لم يُفصح عن امتعاضه، لكنه كتب في دفتره: “إنهم يدعون غير الله، وما ذلك إلا شركٌ ملبّس.” كان لا يزال في بداياته الفكرية، لكن بوصلته كانت تشير بثبات نحو تطهير العقيدة — أو ما ظنه كذلك.
جلس عند بعض العلماء، وأخذ عنهم شيئًا من الفقه والنحو، لكنه كان في الغالب متحفزًا، يتصيّد العثرات، لا يتلقّى بتواضع الطالب، بل بمنظار المصلح الذي يرى نفسه على بيّنة والناس في ضلال. وقد ذكر صاحب كتاب “الدرر السنية” أنه كان يسأل أساتذته أسئلة حادة عن التوسل، عن نذر القربى، عن حكم البناء على القبور، وكانوا يجيبونه بتسامحٍ معتاد، يُعلّلون للناس جهلهم أو تقليدهم، لكنه لم يكن يقبل ذلك. لم يكن في قاموسه شيء اسمه الأعذار، ولا منطق يُخفّف من الحكم.
وذات يوم، جلس في حلقة أحد الشيوخ الكبار بالبصرة، وكان الشيخ يشرح حديث الشفاعة، فقال: “إن الله يأذن لبعض عباده المقربين أن يشفعوا لعباده الصالحين، وهذا من كرامة الأولياء.” فقاطعه محمد بصوتٍ حاد: “وكيف تفرق بين هذا وبين إشراك المشركين الذين اتخذوا وسطاء؟!” فعمّ الصمت، وأجابه الشيخ بلين: “يا بني، ليس من الحكمة أن نكفّر الأمة بما اختلف فيه أهل العلم.” لكن محمدًا لم يكن ليرضى بتلك الأجوبة، وأخذ يدوّن ملاحظاته حول “تساهل العلماء” و”ترويجهم للبدع”.
لم يُطِل المقام في البصرة. يقال — وفق ما رواه حسين بن غنام — أنه اضطر للفرار منها بعد أن ضاقت به صدور الناس بسبب طعنه في المشايخ والتصوف وأولياء الله، حتى إن بعض الصوفية اتهموه بالإلحاد. وهناك روايات تقول إنه تعرض للضرب، أو الطرد، أو المقاطعة. لكنه خرج منها وهو مقتنعٌ أن العالم الإسلامي كله بحاجة إلى ما يسميه: “تجديد الدين على منهج السلف”.
بعدها، انتقل إلى الحجاز لأداء فريضة الحج، وهناك، في مكة والمدينة، ظن أنه سيجد السكينة بين الحرمين، لكنه فوجئ بمن يسميهم “القبوريين” يطوفون حول مقامات الأولياء، ويستغيثون بالأنبياء، بل رأى بعضهم يرفع يديه على باب قبر النبي ﷺ ويقول: “مدد يا رسول الله!”
ارتعد داخله، وازداد تشنجه العقائدي. والتقى في المدينة ببعض العلماء الحنابلة، فقرأ معهم شيئًا من كتب التفسير والحديث، لكنهم أيضًا لم يوافقوه في حدّيته، ورأى أنهم يميلون إلى الرأي والقياس، ويسوّغون التوسل. وهناك، التقى مرة بأحد قضاة مكة، وكان رجلاً مالكيًا متسامحًا، فقال له: “يا بني، ارحم الناس، فالله أرحم بنا مما تظن، ومن دعا نبيًا أو وليًا فهو يطلب بركته، لا يعبده.” فرد محمد بحدة: “لكن الله لا يقبل الشرك، ولو بدا مغلفًا بالنية الطيبة.”
ثم زار المدينة النبوية، وهناك، عند الحجرة الشريفة، أحس باضطرابٍ داخلي. وقف ينظر إلى الناس وهم يتوسلون بالنبي ﷺ، ويدعون عند قبره، فاشتعلت النار في صدره أكثر. سأل أحد المشايخ هناك: “هل يجوز التوسل بذات النبي؟” فأجابه الشيخ الأشعري: “بل هو جائز عند الجمهور، فعله الصحابة في حياته وبعد وفاته.” فلم يقتنع محمد، بل قال: “إنما التوسل المشروع هو بالدعاء، لا بالذوات.”
تلك اللحظات شكلت منعطفًا روحيًا وفكريًا لا يُستهان به. فهو عاد من الحجاز لا كحاجٍ مطمئن، بل كمجاهدٍ قرر أن يعيد تشكيل الإسلام برمته.
حين عاد إلى العيينة ثم الدرعية، كان قد نضجت في ذهنه مجموعة من المبادئ التي صاغها من خلال قراءاته ومشاهداته ورفضه لكل ما يخالف نظرته. وكان قد حسم أمره أن الإصلاح لا يتم إلا بالإزالة، لا بالتحسين.
قال لاحقًا في إحدى رسائله: “ما أدعو إليه هو دين الله الخالص، الذي بعث الله به نبيه محمدًا ﷺ، وأما ما عليه الناس فهو خليط من البدع، لا يقبل الله منها صرفًا ولا عدلًا.”
وهكذا، تكونت لديه رؤية تقوم على تكفير جماعي لمن خالفه، ولو كان المخالف من عامة المسلمين. لم يفرّق بين عوام جاهلين وعلماء متأولين. وكان يرى أن من لم يُكفّر المشرك فهو مشرك.
وفي جلساته الخاصة، بدأ يحدّث من حوله: “أترون هذا الذي يذبح على القبور؟ إنه مشرك. أترون هذا الذي يقول مدد يا رسول الله؟ إنه مشرك. ولو كان من أهل العلم.” وكان أحد الحاضرين يومًا ما أحد تلاميذ أبيه، فقال له: “لكنهم مسلمون يا شيخ محمد.” فأجابه بحدّة: “بل مشركون، ومن لم يكفّرهم فهو مثلهم.”
كانت هذه اللحظات بمثابة إعلان ميلاد العقيدة الوهابية، لا كتيار سلمي دعوي، بل كحركة إقصائية تؤمن أنها وحدها على الحق، وأن سائر الأمة في ضلال، وأن من لم ينضوِ تحت رايتها فمصيره أحد اثنين: الهداية أو الإبادة.
وهكذا، وُلد مذهب لا يعترف بالخلاف، ولا يرحم الضعف، ولا يصالح التاريخ، بل يحمل معولًا يُريد به هدم ألف سنة من التراث.
ولم تكن الجزيرة لتسلم من ذلك المعول…
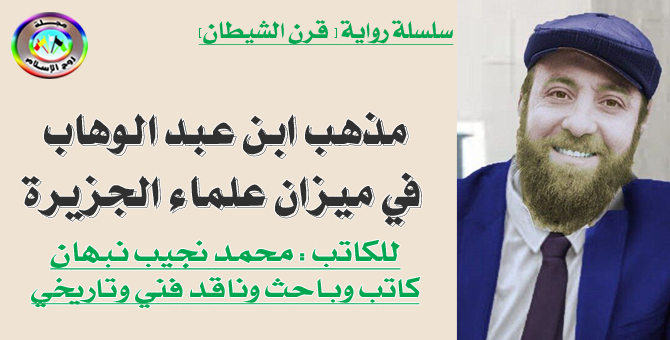
 مجلة روح الاسلام فيض المعارف
مجلة روح الاسلام فيض المعارف