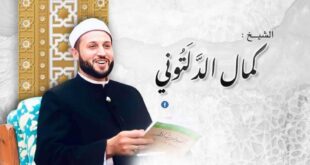تأثير البيئة النجدية فى شخصية محمد بن عبد الوهاب
29 يوليو، 2025
الوهابية ومنهجهم الهدام

المقال الثانى من سلسلة رواية (قرن الشيطان)
للكاتب : محمد نجيب نبهان
كاتب وباحث وناقد فني وتاريخي
الولادة من رحم القرون:
لم تكن الجزيرة العربيّة في مطلع القرن الثاني عشر للهجرة (الموافق للقرن الثامن عشر الميلادي) سوى بقعة ممزّقة من أطراف العالم الإسلامي، تسكنها العشائرُ قبل أن تحكمها، وتُسيّرها الغرائزُ قبل الشرائع، وتشدّها سلاسل الرمل والجهل أكثر مما تربطها وشائج العقيدة الواحدة.
في نجد، التي كانت قلب الجزيرة اليابس، لم يكن هناك عرش، بل مضارب متفرّقة. ولم يكن ثمّة سلطان راسخ، بل أمراء قبائل يتنازعون فيما بينهم على مجاري الأودية وحقول النخل وأصوات الرجال. لم تكن الدولة العثمانية، وإن ادّعت السيادة الدينية والسياسية، تملك من هذا الشطر سوى الاسم، وبعض الولاءات الشكلية، وكثيرٍ من اللامبالاة.
كانت المدن قليلة العدد، فقيرة المورد، محدودة الأثر، أشبه بالجُزر المتناثرة في بحرٍ من الرمل والفراغ. وكان للجهل سلطانٌ لا يُبارى، يسكن العقول كما يسكن البيوت، تتوارثه الألسنة والأنفس مع الأعراف والتقاليد. فالعلم الشرعي، حيث وُجد، كان محصورًا في تكرار المتون، وتقديس الحواشي، وإعادة الأقوال ذاتها كما لو كانت أركانًا لا تقبل الجدل، حتى صار الدين في نظر عامّة الناس مجموعة من الطقوس والممارسات الغامضة التي لا يُفهم منها إلا ما يتّصل بالرغبة في النجاة أو الخوف من الجن.
في قلب هذا المشهد، كانت بلدة العُيينة تلوذ بوضعها الهامشي، تتأرجح بين خضوعٍ شاحب لبني خالد – أمراء الإحساء – وبين محاولاتٍ للاستقلال على يد أسرتها الحاكمة. العُيينة لم تكن من حواضر العلم أو التجارة، بل من بلدات القبائل التي تنهض إذا اشتدّ بأس أمير، وتنهار إذا غضب سلطان قريب أو بعيد.
وفي هذه البلدة، وُلد محمد بن عبدالوهاب في عام 1115هـ (1703م)، لعائلة تنتمي إلى آل مشرف من بني تميم، وهي أسرة معروفة بين أهل نجد بأنها حنبلية النزعة، تشتغل بالعلم الشرعي، ويُضرب بها المثل في الصرامة والالتزام.
كان أبوه، عبدالوهاب بن سليمان، قاضيًا وفقيهًا، عُرف بالحدة والانضباط، وكان من جملة القضاة الذين لا يُداهنون ولا يسلكون طرق الليونة في إصدار الأحكام. وكان يرى في الفقه وسيلةً لحراسة المجتمع من الانحراف، لا بابًا للاجتهاد أو الرأي.
تربّى محمد في هذا البيت تحت ظل هذا الأب، فنشأ منذ صغره وهو يُلقّن المتونَ، ويحفظ نصوص الفقهاء، ويستظهر أقوال ابن قدامة وابن تيمية، حتى صارت تلك الأسماء جزءًا من وجدانه العقلي والديني.
وقد حفظ القرآن في سن مبكرة، قبل أن يُتم العاشرة، وشرع بعد ذلك في تعلم النحو والتفسير والحديث، على الطريقة الحنبلية التي تُشدّد على النص وتُضيق في التأويل.
لم يكن ذلك النشوء داخلًا في بيئة علمية واسعة، بل داخل بوتقة مغلقة، حيث التصور الديني ضيّق، والمذاهب محددة، والشك مرفوض، والاختلاف بدعة.
فقد تداخل الدين بالتقاليد القبلية، فتجلّت الممارسات الدينية في طقوس اجتماعية كالتبرك بالأشجار، والاستغاثة بالأولياء، والنذور على القبور، وتكاثر المشاهد والمزارات حتى صار بعضها قبلة للزائرين من كل مكان.
وكان بعض أهل القرى يبنون قبورًا مزخرفة، يطوفون حولها، ويطلبون منها قضاء الحوائج، بل ويُقسمون بها كما يُقسم بالله، دون أن يجدوا في ذلك تضاربًا مع دينهم أو كتابهم.
تلك المشاهد المتواترة كانت تُحدِث في نفس الطفل – الذي صار فتىً فيما بعد – حنقًا داخليًا لم يُفصح عنه مبكرًا، لكنه ترسّخ رويدًا رويدًا كجزء من يقينه بأن الخلل ليس في الناس وحدهم، بل في علمائهم، في سلطاتهم، وفي الطريقة التي آل إليها الدين نفسه.
خارج بيت أبيه، كانت البيئة لا تقل تأثيرًا:
فالجفاف يُطارد الزرع، والقبائل تتنازع الموارد، والغزوات الليلية تكرّ وتفرّ، والنظام السياسي هش، والسيادة لا تتجاوز المدى الصوتي لصاحب السلطة.
أما العلم، فمحدود الانتشار، والكتب قليلة، والحلقات مغلقة على أسماء مكرورة، بينما تتناقل العامة الحكايات والأساطير بتقديسٍ يتجاوز تقديس النصوص نفسها.
لم يكن محمد بن عبدالوهاب استثناءً في طلب العلم، فقد سلك المسار ذاته الذي سلكه فتيان عصره من أبناء الطبقة المتعلمة: حفظ القرآن، فدرس النحو على المتون الأساسية، وتعلّم شيئًا من المنطق والبلاغة، ثم انصرف إلى كتب الحنابلة، خاصة تلك التي تتصل بالعقيدة والفقه. لكن المختلف فيه لم يكن الطريق، بل الطريقة؛ فقد قرأ بنفسٍ جدليّ، وصار يرى أن كثيرًا مما يُدرّس ما هو إلا حشو، وأن بعضًا من ما يُمارس باسم الدين لا أصل له في الدين.
وفيما كان معظم أقرانه يرون في العلم طريقًا للمكانة، أو القرب من الحاكم، أو الجاه والوظيفة، كان محمد يتعامل مع ما يقرأ بقلق المصلح، لا طمأنينة الطالب.
تلك النشأة، التي جمعت بين حزم الأب، وصلابة المذهب، وضيق البيئة، وتناقضات الناس، صنعت في داخله رؤية لم تكن قد نضجت تمامًا، لكنها كانت أشبه ببذرة في جوف الصخر، تنتظر مطرًا قاسيًا كي تنبت.
كان يشعر – في قرارة نفسه – أن ثمّة خللًا عميقًا في التدين، وأنّ الناس قد نسوا “التوحيد”، ليس من جهة الإيمان بوجود الله، بل من جهة الممارسة والتصور، وأن العادات قد تسللت إلى الدين، والابتداع قد غطى على السنة، وأن من واجبه – إذا شاء الله له العلم والقوة – أن يُعيد الأمور إلى أصلها الأول.
لكن ذلك الطريق لم يكن قد بدأ بعد، إذ لا تزال مرحلة الطفولة والشباب محصورة في الدرس والقراءة والتتلمذ، ولم يكن بعد قد خطا خارج أسوار العُيينة… إلى العالم.
إلا أن البذرة قد زُرعت…
وما تلاها سيكون أمطارًا من نار، لا من ماء.
بيت آل عبد الوهاب :
لم يكن آل عبد الوهاب غرباء في نجد، ولا طارئين على بيئتها القاسية التي لا تحتفي إلا بالأقوياء. كانوا من بني تميم، قبيلة ذات صوت مسموع في تاريخ العرب، وإن اختلف الناس في فرعهم، فقد اتفقوا على هيبتهم في الدِّرعية ووسط الجزيرة. لم يكونوا أمراء قبائل، ولا سادة غزو، بل سادة فقه ومنابر؛ رجال عمائم، لا رجال سيوف، ولكنهم في بيئةٍ تُقيم للفقيه وزنَ المُفتي المُخوَّل، لا تُفرّق كثيرًا بين الكلمة والسيف.
كان والد محمد، الشيخ عبد الوهاب بن سليمان، أحد علماء الحنابلة الذين وُلدوا في حضن التقليد، وترعرعوا في ظلال المذهب، وتربّوا على تعظيم السلف، وتعليم الحلال والحرام كما فُسّر من مئات السنين، لا كما يُفهم اليوم. وكان صلبًا في فكره، محافظًا في نظرته، ملتزمًا بما توارثه من مدرسة ابن تيمية وابن القيم. إلا أن الرجل -على شدّته- لم يكن يهوى الصدام، ولا استسهال التبديع، بل كان عالمًا تقليديًا من طينة أولئك الذين يرون “النهي عن المنكر” شأنَ الدولة، لا شأن الأفراد.
سكن الشيخ عبد الوهاب الدرعية بعدما تنقل بين بعض حواضر نجد، وبنى له فيها بيتًا متواضعًا، لكنه واسع العلم والحضور. وعكف على التعليم والقضاء والوعظ، فصار من وجوه البلدة ومرجعياتها. في هذا البيت، وعلى ضوء الفجر الرملي الصامت، وُلد محمد بن عبد الوهاب، في سنة 1115 هـ/1703 م، وكان مولده حدثًا عادياً في سجلّ الصحراء، لم تتفتّح له أبواب السماء ولا اهتزّت له الرمال… بعد.
في ذلك البيت، فُتحت عينا الطفل على عالم مقسوم بين حروف العلم وصرخات القوافل. كانت المجالس الفقهية تحيط به، والنقاشات المذهبية تدور أمامه، والكتب تُقرأ وتُنسخ وتُحفظ عن ظهر قلب. حفظ القرآن وهو لم يتجاوز العاشرة، وهو أمر مألوف لأبناء العلماء، لكنه تفوّق في سرعة الحفظ، وحدّة الذهن، وحدة الطبع أيضًا. لاحظ والده فيه نزعةً للتمحيص لا للاتباع، وتشدّدًا في الحكم على العوام الذين يُظهرون ما يُسمّى في الفقه بـ”البدع الصغيرة”، كالتوسل وزيارة القبور والتبرك بالصالحين.
وكانت أسرته –وإن كانت علمية– لا تُخاصم المظاهر الشعبية للدين، ما دامت لا تُفضي إلى شرك بيّن. لكن محمدًا، وهو بعدُ صبيّ، كان يقطّب حاجبيه، ويظهر الامتعاض من النساء اللائي يُشعلن البخور على أضرحة الصالحين، ومن المساكين الذين يهمسون بدعائهم عند شباك أحد الأضرحة، ومن التجار الذين يُغلّفون بضائعهم بالتبريكات. وكان يصيح غاضبًا: «أهذا دين؟! أبهذا نعبد الله؟!».
لم يكن الأب مرتاحًا تمامًا لنظرات ابنه المتحفّزة، لكنه كان يرى فيه نبوغًا يحتاج إلى ضبط. أرسله إلى مكة والمدينة لاحقًا، آملاً أن يتهذّب في رحاب الحرمين، لكن الرحلة –كما ستُبيّن الأيام– لم تُطفئ جذوة الغلو، بل كانت وقودًا جديدًا، حيث التقى هناك بتلاميذ ابن تيمية المتأخرين، واستهوته مفردات التجديد الهجومي على العقائد الشائعة.
أما أخوه سليمان، فقد كان أكثر اعتدالًا، وأكثر نفورًا من اندفاع محمد، وسيقف لاحقًا على الضفة الأخرى في المعركة الفكرية.
في بيت آل عبد الوهاب، نشأ محمد وسط خليطٍ من التقاليد الفقهية الصارمة، والتدين الشعبي العميق، والجدل المتأجج حول الخلاص والضلال، وهو خليط سيكون فيما بعد التربة الخصبة التي ستنمو فيها “العقيدة الجديدة”، لا بوصفها بذرة إصلاح، بل بوصفها قنبلة فكرية ستُفجَّر لاحقًا على وقع الصيحات: “من بدل دينه فاقتلوه”.
لكن إلى ذلك الحين، لم يكن في الدّرعية من يدري أن هذا الطفل الصامت في مجالس والده، سيحمل في صدره فأسًا لا تهوى على الشرك وحده، بل على وجه التاريخ كلّه.
كان محمد بن عبد الوهاب –ابن هذا البيت الطينيّ في نجد– نبتة شاذة في بستان ظاهر التدين، ومخبوء الشك. وها نحن نغوص أكثر في طفولته، لنعرف كيف صار العالمُ نارًا، والتوحيدُ مشنقةً، والفقهُ فُرقةً…
لكن البداية، كانت هنا: في بيت علمٍ… خرج منه من أشعل حريقًا لم ينطفئ بعد.
طلب العلم… على قارعة النار:
لم يكن العلم في نجد ترفًا، ولا رحلاته حكاية محضًا تُروى في المجالس، بل كان العلم -ولا يزال- سلّمًا نحو الخلاص، ووسيلة للنفوذ الاجتماعي، وورقة عبور إلى مجالس الأمراء وأكفّ العامة على السواء. وكان “الطالب” في بيئة كبيئة محمد بن عبد الوهاب، لا يُنظر إليه كقارىءٍ للكتب فحسب، بل كقارئ لمصائر الناس، ومُوقّعٍ عن رب العالمين، كما كان يُقال.
انطلقت رحلته العلمية في سنٍّ مبكرة، تشبه سرعة نبوغه، واندفاع يقينه نحو تفسير الدين تفسيرًا جافًا صارمًا، لا يلين ولا يُهادن. وما إن أتمّ حفظ كتاب الله، حتى طاف على حلقات العلماء المحليين في العيينة والدرعية والرياض. لكنه لم يُشبع ظمأه بعد. كان يطلب المعرفة لا ليحفظها، بل ليُنقّب داخلها عن خلل ما، عن رائحة بشرية في وحيٍ مُنزّل، أو لمسة خرافة في حديثٍ شريف.
لم يكن مجرّد طالب… بل كان، ومنذ بداياته، يميل إلى التمحيص حدّ الوسوسة، وإلى الحكم حدّ التهديد، وإلى التفسير بما يراه هو “محض السنّة”، وإن خالفه سائر العلماء. فكانت عيناه حين يقرأ، لا تنظران إلى المتن، بل تنفذان من تحته كمن يبحث عن خيانةٍ كامنة في الحبر.
أرسل به والده إلى مكة، المدينة الأولى التي فيها البيت الحرام، قلب الإسلام النابض، عسى أن تهذب هذه الرحلة روحه، وترتّب نظرته الساخطة نحو مجتمعه. لكنه ما لبث أن اصطدم بما رآه بعينيه من توسل الحجاج، وبكاء العوام على جدران القبور، وتقبيلهم لمقامات الصالحين. لم يرَ في ذلك مظاهر عاطفية تعبّدية، بل رأى شركًا صريحًا يناقض أول ما نزل من القرآن.
عاد وقد تملّكته نفرة داخلية حادّة من “الإسلام الشعبي”، ذلك الدين اليومي الذي يخلط حبّ الله بحبّ الأولياء، ويجمع بين القرآن والحجاب، بين الصلاة والحرز، بين السنّة والمولد، بين الحشمة والمشرب، بين الخشوع والاحتفال.
ثم انطلق إلى المدينة المنوّرة، عاصمة النبوّة وعلم السلف، وهناك تتلمذ على أيدي علماء الحرم، وتعرّف على مذاهب أخرى غير الحنبلي، لكنه لم يكن متسامحًا مع الخلاف الفقهي، بل كان يراه تشظّيًا عن الأصل الواحد، وعلامة فساد أكثر منها علامة تنوّع. سكنَ وقتًا قصيرًا، لكنه طال بما فيه الكفاية ليزداد نفورًا من العلماء الذين يقفون “على الحياد”، كما وصفهم لاحقًا، ومن العوام الذين “يدينون الله بغير ما أنزل”، ومن المتصوّفة الذين “يمضغون الله بمحاريب الكلام”.
وفي المدينة، بدأت أولى شذرات “التحوّل الجذري”. هناك، طالع بشغف كتابات شيخ الإسلام ابن تيمية، ووجد فيها ضالّته؛ وجد فيها الفأس التي تُحطّم، والصوت الذي لا يعتذر. انجذب إلى فكرة “العودة إلى النبع”، ولكنه لم يعد، بل اقتحم الماء بعنف، وغاص في أعماقه وهو يطرد كل من حوله: المتسامحين، المولويين، الشعراء، الفقهاء المعتدلين، بل حتى العلماء الأقدمين الذين لم يجزموا ببدعة زيارة القبور.
عاد بعدها إلى الأحساء، واحتكّ بعلماءٍ مالكيين وأشاعرة، واحتدم النقاش هناك، وتحوّل إلى جدال، ثم إلى صدام صامت. لم يكن يجادل طلبًا للفهم، بل كان يُطلق فتاواه من موضع يقين صخري لا يتزحزح. بل إن بعض العلماء هناك، حذّروا من حدّة خطابه، ورأوا في طلابه الأوائل خطرًا على سكينة المجتمع المحلي. وبدأ يُنعت –بصوت خافت– بأنه “غليظ الطبع”، و”منكِرٌ على الخلق”، و”يتعجل في التكفير”.
وكانت الأحساء، حينها، أشبه بسوق مفتوح للعلماء والمذاهب، لكنها كانت أيضًا بؤرة لاحتقان طائفي صامت بين السنة والشيعة، وهو احتقان غذّاه محمد بن عبد الوهاب لاحقًا في مؤلفاته، حين ربط التصوّف بالشرك، والشيعة بالبدعة، والعقيدة بالإقصاء، والرحمة بالقسوة، و”لا إله إلا الله” بـ”اقتل المشركين”.
أما النجف، أو البصرة، أو بلاد الشام، فلم تطأها قدماه. كانت رحلاته محصورة في رقعةٍ ضيّقة، لكنها عميقة، وفي قلب نجد تحوّل العلم إلى وقود. وكل عالم التقاه، كان كأنما يُضيف حطبًا إلى هذه النار التي بدأت تتأجج في قلبه، نار لم يُرد بها إصلاحًا وحسب، بل تغييرًا جذريًا للدين كما يُمارسه الناس، لا كما نُزّل.
ولم تكن هذه الرحلة العلمية منقطعة عن طموح شخصي. فقد بدأ –على صغر سنّه– يُبشّر بأفكاره، يُجادل بها أهل بلده، يُنكِر على والده في بعض المسائل، ويتّهم العامة بالضلال، والفقهاء بالتساهل، والمجتمع كلّه بالانحراف.
وكان قد كتب في تلك المرحلة بعض الرسائل القصيرة، فيها نَفَسٌ قتالي ضد ما يراه “انحرافًا عن التوحيد”، وبدأت كلمات مثل “الشرك الأكبر”، و”القبوريين”، و”الطواغيت”، و”البدعة المكفّرة” تظهر بكثافة في خطابه، وتشكّل العصب الصلب لما سيُصبح لاحقًا: الدعوة الوهابية.
ولمّا عاد إلى الدرعية بعد هذه الرحلات، لم يكن كما خرج. لم يعد الابن الذي يرجو والده أن يخلفه في حلقة التدريس، بل صار الخصم الذي يرى في والده نفسه مداهِنًا في العقيدة.
وهنا، لم يعد العلم غاية، بل وسيلة… وسيلة للإقناع، ثم للإقصاء، ثم للإلغاء.
وفي قلب نجد، حيث القبائل تملأ الفراغ بالدم، كان العلم يُعيد تشكيل نفسه… على يد شابٍ نحيل، بوجهٍ حادّ، وكلمات كالسياط.
شابٍ… على وشك أن يرفع “قرن الشيطان”.

 مجلة روح الاسلام فيض المعارف
مجلة روح الاسلام فيض المعارف