شريعة على صهوة الخوف
28 سبتمبر، 2025
الوهابية ومنهجهم الهدام
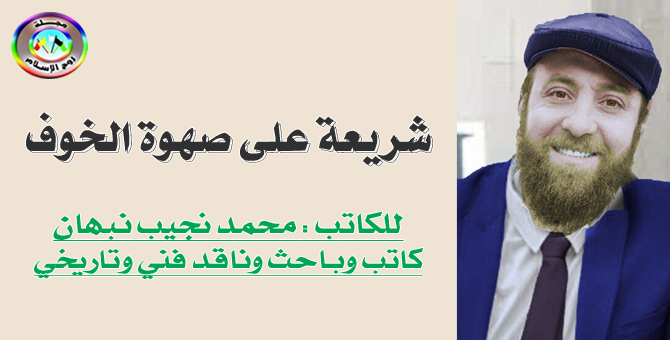
المقال التاسع من سلسلة رواية (قرن الشيطان)
للكاتب / محمد نجيب نبهان
كاتب وباحث وناقد فني وتاريخي
كانت الأخبار تأتيه محمولة على ظهور الخيول، مُثقلة برائحة الغبار والنار.
قرى تُهاجم، مساجد تُهدم، قباب تُسوّى بالأرض، أضرحة أولياء تُنبش، ونُسخ من كتب الفقه تُحرق لأنها تحوي أورادًا أو فصولًا عن الكرامات.
كل ذلك، باسم “نقاء التوحيد”.
وحين وصلته رسالة من قرية “فدك”، يقول فيها أحد شيوخها:
“لقد دخل علينا رجالكم، فسألونا: أتتبرّكون بالأولياء؟
فلما قلنا: نحبهم ولا نعبدهم، قالوا: هذا شرك.
فهدموا الضريح، وأخذوا منا كتاب الدعاء، وقالوا: هذا بدعة شركيّة.”
ووقّع الرسالة بعبارة: “من عبد الله بن عابد بن صالح، أحد محبّيكم، لا أعدائكم.”
وضع محمد بن عبدالوهاب الرسالة على الطاولة، وسكت طويلًا.
في بداية دعوته، لم يكن يتخيّل هذا المشهد.
كان يرى في الشرك خطرًا وجوديًا يُهدّد الأمة، وأن إزالة مظاهره – أيًّا كانت – هو أول شروط عودة الإسلام إلى صفائه الأول.
لكنه لم يكن يريد للناس أن يُؤخذوا على غفلة، أو يُطعنوا في قلوبهم وهم يصلّون.
لم يكن يتخيّل أن تتحول كلماته إلى سيوف تسبق الفهم، وسلاسل تُقيّد الضمير.
أراد أن يُزيل الغبش عن التوحيد، لا أن يُطفئ نور الرحمة.
مرّ بذاكرته أولى لحظات لقائه بابن سعود.
يومها، جلسا متقابلين، وكأنّ التاريخ يتنفس بينهما.
قال له محمد بن عبدالوهاب يومها: «يا عبدالعزيز، إنني أرى الناس يعبدون الله على جهل، ويتقرّبون إليه بما لم يشرع. ومن لم يُنكر المنكر فهو شريك في الإثم.»
قال له ابن سعود: «وهل يرضى الله عن هدم قلوب العوام إن لم يهدموا القباب؟ وهل تُنصر الأمة بسيف على أهلها؟»
أجابه محمد: «بل تُنصر بالحق، وإن كان مُرًّا. والسيف إن لم يكن في يد الحق، صار في يد الباطل.»
وتم الاتفاق:
الدعوة له، والسلطة لابن سعود.
وكلما وسّع هذا نفوذ السيف، وسّع الآخر نفوذ الكلمة.
لكن بعد سنين، لم يعُد الفرق واضحًا.
صارت الكلمة نفسها تُحمل على الرمح، والدعوة تُبشّر بالجنة من جهة، وتُهدّد بالنار من الجهة الأخرى.
في عامٍ من الأعوام، دخلت قوات الدولة الناشئة إلى الحجاز.
دخلوا الطائف، ثم مكة.
قُتل رجال، أُحرقت زوايا صوفية، صُودر مصحف منسوب إلى خطّ الإمام عليّ لأنه “بدعة” بلا سند، وهُدِمت بعض القباب التي كان يُقال إنها لأبناء الصحابة.
لم يكن محمد حاضرًا، لكنه تلقّى الأخبار مكتوبة بالتفصيل.
جاء في تقريرٍ من قائد الحملة:
«الحمد لله، لقد طهّرنا الأرض من الشرك. لم نُبقِ قبرًا يُزار، ولا مزارًا يُخشى. وقد أمرنا بإزالة كل ما يُشير إلى بدعة، ولو كان حجرًا كُتب عليه اسمٌ غير الله.»
قرأ محمد التقرير، ثم طوى الورقة بصمت.
في الليل، دخل عليه أحد أبنائه.
قال له:
«يا أبت، أحقًّا أننا على الحق وحدنا؟»
قال محمد:
«الحق لا يُعرف بكثرة السالكين، بل بدليله.»
فقال الابن:
«لكننا نُصلي، وهم يُصلون. ونُوحّد، وهم يُوحّدون. ونقرأ القرآن، وهم يقرأون.
فهل شققتَ عن قلوبهم يا أبت؟»
لم يُجبه محمد.
كان قلبه مشغولًا بسؤال آخر: “هل يُمكن للحق أن يكون عنيفًا إلى هذا الحد؟”
أعاد محمد قراءة بعض فتاواه القديمة.
وجد فتوى في تكفير من يذبح لغير الله عند قبر ولي.
ثم وجد أخرى في تحريم زيارة قبر النبي لمن اعتقد أن الزيارة تقرّب إلى الله، لا لمجرد السلام.
ثم وجد ملاحظات بخط يده:
«إذا اشتبه على المرء في فعل شركي، وجب تعليمه. فإن أصرّ، كان كافرًا.»
لكنّه لم يجد تفسيرًا لكلمة “أصرّ”…
هل المقصود الجهل العنيد؟ أم الجهل العفوي؟
وهل تقاس العقيدة بالمقاييس نفسها التي تُقاس بها الجريمة؟
كانت الرسائل تأتيه من علماء الأزهر، من الشام، من اليمن.
كلٌّ منهم يُعارضه، أو يُحذّر منه.
كتب أحد علماء اليمن:
«يا محمد، قد تكون مُخلِصًا، لكنك تستعجل الحصاد، وتقطع الزرع قبل أن ينضج.
التوحيد لا يُغرس بالنار، بل بالعلم، والحكمة، والصبر.»
وقّع الرسالة باسم: الحسن بن أحمد، رجل من أهل السنة، لا من أهل الشرك.
قرأ محمد الرسالة ثلاث مرات، ثم كتب على ظهرها:
«ومن قال إنني أقطع؟ إنني أُطهّر.»
لكنه لم يُرسلها.
ربما شعر للحظة أن “الطهارة” صارت تعني عند أتباعه الإبادة الرمزية للآخر.
في إحدى ليالي الدرعية، دعاه الشيخ ابن سعود لحضور اجتماع مع بعض وجهاء القبائل.
كان بينهم رجل من الحجاز، اسمه سعد بن سالم، ذو لحية كثيفة، ووجه صارم.
قال سعد: «يا شيخ، إنكم تدعون إلى التوحيد، ونحن معكم.
لكن أتباعكم لا يفرقون بين الجاهل والمبتدع، ولا بين الخطأ والشرك.
صار الناس يخافون من الذكر، من الصلاة في المساجد التي فيها قبور، من كتب الدعاء القديمة.
صار الدين رعبًا.»
ردّ محمد: «لو كنّا نُجامل في العقيدة، ما نهضنا أصلًا.»
قال سعد:
«لكنكم الآن لا تُعلّمون… أنتم تُهاجمون.
وهذا الدين جاء موعظةً، لا محكمة.»
عاد محمد تلك الليلة إلى غرفته.
جلس أمام محرابه، ولم يصلِّ.
أخذ دفتره، وكتب:
«كم من نفسٍ خافتني، ولم تخف الله؟
كم من قلبٍ حسبني باب النجاة، ولم يفتح قلبه لله مباشرةً؟
كم من جاهلٍ حسب سيفي شريعة، وهو لا يفرق بين العادة والعقيدة؟»
كتب في الهامش:
«إذا صارت الشريعة مطيّة للخوف… فهل تبقى شريعة؟»
كان الحبر لا يزال ساكنًا.
لكن الجمر تحته ازداد اتقادًا.
وكتب آخر سطر:
«اللهم، لا تجعلني باب فتنة، ولو كنتُ على الحق.»
ظلّ اللهب على الجدار:
كانت الشمس قد توارت خلف كثبان الدرعية حين دخل محمد بن عبدالوهاب مجلسه الأخير لتلك الليلة. لم يكن بانتظار أحد، ولم يُضِئ المصباح، وكأن العتمة باتت رفيقة تألفه، لا تخيفه.
جلس على الأرض. لا كتب حوله، لا تلاميذ، لا أوراق مبعثرة. فقط صمتٌ كثيف، وصوت الريح يضرب نافذة الطين، كأنها تذكّره: أن كل نارٍ، وإن اشتعلت بالحق، تُلقي ظلًا.
في أيامه الأولى، كانت الدعوة نارًا في قلبه. يرى في البدعة سوسًا ينخر الأمة، ويرى في التوسّل شركًا مغلّفًا بمحبة الأولياء. وكان يؤمن أن الإسلام قد تلوّث عبر القرون، وأن العودة إلى الصفاء الأول لا تحتمل التدرّج ولا التساهل.
لكنّه الآن، بعد عقود من الخطابة، من التأليف، من التحالف، من التكفير، من الحروب، من الدماء التي سُفكت، والقبور التي سُويت بالأرض، بدأ يرى أن للنار ظلالًا.
ظلّ لا يطفئه النقاء، ولا تُبرّره النيّة.
في إحدى أوراقه الشخصية، كتب منذ أعوام:
“لقد بدأنا من آية: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وانتهينا إلى فتوى تُحرِّم السلام على من يقرأ دلائل الخيرات، أو يضع وردًا على قبر. هل خسرنا الطريق بين الآيتين؟”
ثم مزّق الورقة.
كان مزّق كثيرًا غيرها، لأن الظل لا يليق برسائل تُكتب في النور.
في العيينة، حين كان في السابعة من عمره، زارت أسرته ضريحًا شهيرًا في الجبل المجاور. كانت أمه تمسك بيده، وتقول له: “قل: يا الله، لا تنادِ الميت.” لكنه رآها مساءً تبكي عند الضريح، وتقول: “يا شيخنا، اشفع لنا.”
حين كبر، أنكر التناقض. لكنه لم يفهم الألم. لم يفهم أن الناس حين تشتد بهم الحياة، لا يلجؤون إلى القبور لأنهم يعبدون أهلها، بل لأنهم تعبوا من جدران لا تُجيبهم.
في الخرافة ظلّ الأمل. وفي التوسّل ظلّ الوحدة. وفي حب الأولياء ظلّ الأمومة والأبوة والحنين إلى زمنٍ لم يعرفوا فيه الفقه، لكن عرفوا الطمأنينة.
في البصرة، في مجلس علمٍ ذات مساء، صرخ في وجه شيخ: “هذا شرك! هذا لا يرضي الله!” لأن الرجل مدّ يده إلى عصا يُقال إنها كانت للنبي.
قال له الشيخ: “يا بني، ليس كل انحراف شركًا. بعضه جهل، وبعضه حب، وبعضه إرث لا يعرف بديله.”
لكنه لم يكن يملك آنذاك رفاهية التفهّم.
كان يرى الوقت ينفد. والناس تنزلق. والدين يتهدّد.
حين عاد من رحلاته إلى نجد، بدأ يؤلف كتابه “التوحيد الذي هو حق الله على العبيد”. كان الكتاب خلاصة غضبه. صفحة تلو صفحة، كأن كل كلمة فيها تُكفّر عالمًا، أو تنقض طريقًا.
وحين كتب باب: “من تبرك بشجر أو حجر فقد أشرك”، كان لا يزال تحت أثر خلافٍ مع شيخٍ من الحجاز، دافع عن التبرك بآثار نبي.
سأل نفسه الآن: كم بابًا في كتبي وُلد من غضب؟ كم سطرًا حُبك من نزاع؟ كم حكمًا اجترأته لأني خفت أن يُقال: “تساهل محمد بن عبدالوهاب”؟
زارته وفودٌ من الأحساء، من مكة، من نجد، من المدينة. بعضهم جاء يبايع، وبعضهم جاء يستتيب، وبعضهم جاء يخاصم.
قال له أحد الفقهاء من اليمن:
“شيخنا، نحن لا نعبد القبور. لكنك جعلت كل من لم يُنكرها مشركًا.”
فردّ محمد: “إن لم يُنكر، فقد رضي. وإن رضي، فقد خلط الدين بالخرافة.”
فقال الفقيه: “وهل يُعذر الجاهل؟”
قال محمد: “يُعذر في العلم، لا في التوحيد.”
قال الفقيه: “لكن الناس ورثوا دينهم، ولم يعرفوا غيره.”
صمت محمد. ثم قال: “والله، لا أُكفّر العامة، بل العلماء الذين يسكتون.”
لكنه كتب في حاشية كتابه بعد تلك المناظرة:
“قد يُعذر الجاهل في بعض الأحوال، إن لم تُقم عليه الحجة.”
في الحروب التي خاضها تحالفه مع آل سعود، سقط كثيرون.
نساء، أطفال، شيوخ، فقراء، أئمة مساجد، طلاب علم.
كلهم أُدرجوا تحت وصف: “الموالون للبدعة.”
كلهم، في دفاتر الدعوة، كانوا من “أهل الشرك، إن لم يُظهروا التوبة.”
لكنه في خلواته، كان يقرأ حديث النبي: “هدم الكعبة أهون عند الله من قتل مسلم.”
وسأل نفسه:
هل تجرّأنا باسم الحق، حتى اختلطت أيدينا بالدم؟
وهل خسرنا قلب الأمة، لنربح صورتها؟
وهل يمكن أن يكون النقاء، إذا زاد عن حدّه، قاتلًا؟
في سنة من السنوات، دخل عليه أحد تلاميذه المخلصين، وقال له:
“يا شيخ، الناس يقولون إنك فتحت باب التكفير بلا ضوابط، وإن في نجد من صار يُكفّر أخاه لأنه زار قبر أمه.”
أجابه محمد:
“نحن لا نكفّر إلا بشروط، ولا نُبيح القتال إلا بعد إقامة الحجة.”
فقال التلميذ:
“لكنهم لا يعرفون الحجة. يعرفون فتاواك، ويحسبونها قرآنًا.”
صمت محمد.
ذلك الليل، كتب في دفاتره:
“الخوف من الشرك قد أورثنا رُعبًا من المحبة. والخوف من البدعة قد قتل فينا روح الرحمة.”
في الأيام الأخيرة، أُرسلت إليه رسالة من عالم مغربي كبير، يطلب منه إعادة النظر في أحكامه العامة.
قال في الرسالة:
“يا شيخ، لو طبّقنا منهجك حرفيًا، لما بقي من الأمة إلا طائفة. ولا سلم إمامٌ ولا مريد.”
ردّ عليه محمد برسالة قصيرة:
“يا سيدي، لقد جاهدت جهدي أن أُعيد الناس إلى ما كان عليه النبي وأصحابه، فإن كنتُ قد شدّدت، فلأن الزمان لا يحتمل التراخي.”
لكنه كتب بخطٍ صغير في أسفل الصفحة:
“اللين يُصلح ما لا يُصلحه السيف.”
خرج إلى مسجد الدرعية في آخر جمعةٍ حضرها.
صلّى في الصف الأخير، لم يتعرف عليه أحد. وكان صوته في السجود همسًا:
“يا رب، إن كنتُ فتحتُ باب فتنة، فاختمه بيدك، لا بيد خلقك.”
وفي السجدة الثانية، بكى.
لا من خوف الموت، بل من سؤالٍ أقدم من الموت:
“هل كنتُ سببًا في أن يخاف الناس من الله… أكثر مما يحبونه؟”
عاد إلى غرفته، وأشعل الشمعة.
كتب على الصفحة الأولى من دفتر جديد:
“اللهم إنك تعلم أنني أردتُ وجهك… فإن أخطأت، فاغفر لي. وإن أصبت، فاجعل قلبي لا يفرح إلا برضاك، ولا ينتشي بانتصارٍ يُغضبك، ولا يبني عقيدةً على أنقاض الرحمة.”
أغلق الدفتر.
وأطفأ الشمعة.
وفي العتمة، بقي ظل اللهب على الجدار… كأن كل دعوة، مهما سمت، لا تخرج من التاريخ طاهرةً كما دخلت.
وأن الحبر، مهما خلص، قد يسيل مع الرماد.
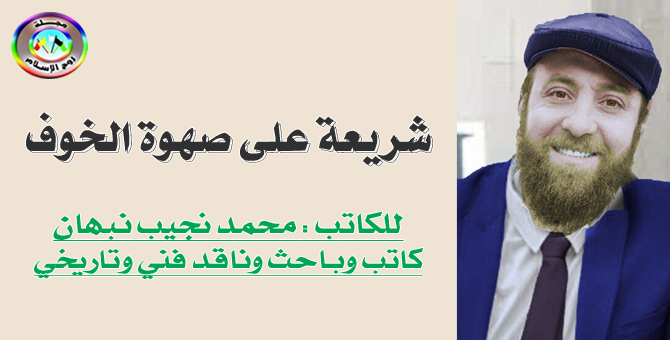
 مجلة روح الاسلام فيض المعارف
مجلة روح الاسلام فيض المعارف