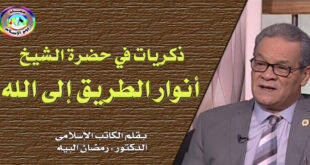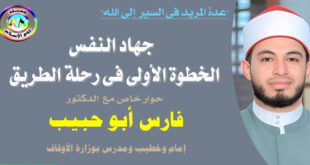فى هذا اللقاء نستكمل سلسلة ( عدة المريد فى السير إلى الله)
ونستكمل حوارنا اليوم
مع الدكتور : فارس أبو حبيب ( إمام ومدرس وخطيب بوزارة الأوقاف )
س36: يعترض البعض على مصطلح جهاد النفس عند الصوفية بحجة أنه يعطل وجوب جهاد أعداء الإسلام، أو أن الصوفية يتحججون بجهاد النفس حتى لا يجاهدوا أعداء الإسلام، فهل هذا المطعن صحيح؟
هذا الاعتراض غير صحيح، وينشأ غالبًا من سوء فهم للتصوف الحقيقي أو من النظر إلى تصرفات بعض المنتسبين إليه لا إلى أصوله ومقاصده.
بيان الرد:
1- جهاد النفس لا يُعارض جهاد العدو، بل هو شرط من شروطه.
قال الإمام الغزالي رحمه الله:
“من لم يُجاهد نفسه على الطاعة، خيف عليه أن يُجاهد في سبيل هواه لا في سبيل الله”. “إحياء علوم الدين”، ج3، صـ11.
2- التصوف الحق يرى أن النفس قد تُفسد العمل، وإن كان في ظاهره خيرًا، ولذلك لا بد من تهذيبها قبل الدخول في جهاد العدو.
3- الذين يعارضون التصوف بسبب هذا الفهم يتجاهلون أن النبي ﷺ قال: “المجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله”رواه الإمام أحمد في مسنده وهو حديث حسن.
4- واقع التاريخ الإسلامي يكذّب هذه الشبهة، فمشايخ التصوف وعلماؤه كانوا من أعظم المجاهدين، كما سيأتي في الإجابات التالية.
5- الجهاد نوعان:
جهاد أصغر: بالسيف والسنان.
جهاد أكبر: بالنفس والهوى.
وكلاهما واجب في موضعه، ولا تعارض بينهما.
الخلاصة: الصوفية لم يكونوا أبدًا دعاة إلى ترك الجهاد، بل يرون أن جهاد النفس هو إعداد للجهاد الأعظم ضد أعداء الدين، وأن النفس المهذبة هي القادرة على نُصرة الدين بحق.
37: وهل لمشايخ الصوفية أو مريديهم سوابق تاريخية في جهاد أعداء الإسلام؟
نعم، لمشايخ الصوفية ومريديهم سوابق عظيمة في ميادين الجهاد ضد أعداء الإسلام عبر التاريخ، سواء في صورة الجهاد القتالي، أو في صورة الإعداد الروحي والتربوي والتحريض على الجهاد، أو مقاومة المحتل، أو حماية الثغور، أو إنشاء الزوايا الربانية التي كانت حصونًا للتربية والجهاد معًا.
بل إن التصوف في كثير من مراحله التاريخية كان هو الرافعة الكبرى للجهاد الإسلامي، وكان كثير من المجاهدين الكبار تلاميذ لمشايخ التصوف، أو مرتبطين بطرق صوفية ذات نزعة إصلاحية جهادية.
ومن أبرز الأمثلة التاريخية:
1- الشيخ عبد القادر الجيلاني (ت 561هـ):
هو من أئمة التصوف المحققين، وشيخ الطريقة القادرية، وواحد من أبرز من جمع بين العلم والعمل والجهاد.
رغم أنه لم يحمل السيف بنفسه، فإنه مارس الجهاد بالكلمة والخطبة والتربية، وكان يدعو إلى الجهاد في عصر الحروب الصليبية، حين اشتد خطرهم على بلاد الشام والعراق وله خطب شديدة في هذا الشأن. راجع: فتوح الغيب”، خطبة رقم (38)، بتحقيق: محمود الشريف، دار القبة، صـ215.
فكان يحثّ أتباعه على التحرر من حب الدنيا، والصدق في نصرة الدين، ويُعدّ هذا الجهاد التربوي من أقوى أدوات الإعداد النفسي والمعنوي للمجاهدين.
2- الشيخ عز الدين بن عبد السلام،(577–660هـ) – دمشق ومصر:
وُصف بـ “سلطان العلماء”، وكان إمامًا شافعيًا، وصوفيًا محققًا في السلوك.
وقف في وجه التتار والصليبيين، وكان من قادة الجهاد العلمي والشرعي، فحرّض السلطان الصالح أيوب ثم الظاهر بيبرس على مقاومة الغزو الصليبي.
وأفتى ببيع أمراء المماليك في الأسواق لجمع المال لتمويل الجهاد، وقال: “إذا نزل العدو بساحل بلد، وجب على العالم أن لا يشغل نفسه بغير الدفع ولو بطل التدريس والتصنيف”.
“الدرر الكامنة” لابن حجر، ج2 صـ119، و”طبقات الشافعية الكبرى” للسبكي، ج8 صـ209.
3- الشيخ عمر المختار، (1862–1931م) – ليبيا:
قائد المقاومة الليبية ضد الاحتلال الإيطالي، ينتمي إلى الطريقة السنوسية الصوفية.
خاض أكثر من 100 معركة ضد الإيطاليين في الجبل الأخضر.
قال عنه أحد الضباط الإيطاليين: “لو كان لدينا عشرة من عمر المختار لهزمنا الجيش الليبي كله”.
حوكم وأُعدم وهو في السبعين من عمره، وقد قال عند إعدامه:
“إننا لا نستسلم، ننتصر أو نموت، وهذه ليست النهاية، بل سيكون عليكم أن تحاربوا الجيل القادم، والأجيال التي تليه”.
4- الشيخ محمد بن عبد الكبير الكتاني (1873–1909م) – المغرب:
من علماء الصوفية والمجاهدين ضد الاحتلال الفرنسي.
رفض الانبطاح السياسي، وحرض القبائل المغربية على الجهاد، وواجه الحاكم المستبد “عبد الحفيظ” الذي كان يميل إلى مهادنة فرنسا.
تم اغتياله وتمثيل جسده في فتنة سياسية بعد رفضه التنازل عن مقاومة الاحتلال.
“الشيخ محمد الكتاني: حياته ومواقفه” للدكتور محمد بن عزوز، صـ54–80.
5- الشيخ أحمد السنوسي وأحفاده – ليبيا وبلاد المغرب:
مؤسس الطريقة السنوسية، التي أصبحت حركة دعوية جهادية في شمال أفريقيا.
ساهم أبناؤه وأتباعه في مقاومة الاحتلال الإيطالي، ومنهم الأمير محمد إدريس السنوسي، الذي صار ملكًا على ليبيا فيما بعد، وكان من المجاهدين في صفوف الطريقة.
“الحركة السنوسية” لعلي الصلابي، دار المعرفة، صـ232 وما بعدها.
هؤلاء وغيرهم الكثير أمثال الشيخ الحداد الشاذلي في المغرب، والشيخ المجذوب في الجزائر، والشيخ عبد الحميد بن باديس، والسنوسي الكبير، كلهم من أعلام التصوف الذين قادوا الجهاد أو أعدّوا له في بلادهم.
الخلاصة:
الصوفية الحقيقيون لم يكتفوا بجهاد النفس، بل كانوا في مقدمة المجاهدين في ميادين العزّة، وجمعوا بين التهذيب الروحي والجهاد العسكري، لأن النفس المهذبة هي وحدها القادرة على الصبر والتضحية والإخلاص في ميادين القتال.
س38: وهل فريضة جهاد أعداء الإسلام هي أصل ثابت عند الصوفية؟
نعم، فريضة جهاد أعداء الإسلام أصل ثابت في التصوف الحق، وليست طارئة ولا ثانوية، بل هي مرتبطة تمامًا بجهاد النفس، لأن من أهم شروط الجهاد الخارجي أن يكون المجاهد قد جاهد نفسه أولًا، ليُجاهد لله لا لهواه.
وكل من تتبع تراث الصوفية من أهل التحقيق، وجد أن فريضة الجهاد تحتل مكانة كبيرة في خطابهم التربوي والعملي، لكنها لا تنفصل عندهم عن التربية الروحية، ولا تنطلق من مجرد الحماسة، بل من صفاء الباطن، وإخلاص القصد، وسموّ الهمة.
أدلة على أن الجهاد أصل عند الصوفية:
أولًا: أقوال كبار مشايخ التصوف
1- قال الإمام أبو حامد الغزالي (ت 505هـ):
“اعلم أن الجهاد أربع مراتب: جهاد النفس، ثم جهاد الشيطان، ثم جهاد الكفار، ثم جهاد أهل الظلم والبدعة. وكلها واجبة بحسب الطاقة، وجهاد النفس مقدمة على سائرها، لأنه الأصل”.
“إحياء علوم الدين”، ج3، كتاب “الجهاد”.
2- وقال الإمام السهروردي (ت 632هـ):
“المريد لا يُقبل منه أن ينقطع في الخلوات ويترك أمر الأمة، فالدين نُصرة، والجهاد باب من أبواب الجنة، وهو فرض قائم على أهل الطريقة والظاهرة”. “عوارف المعارف”، صـ137.
3- وقال ابن عطاء الله السكندري (ت 709هـ):
“من لم يطهر باطنه من الرياء، خيف عليه أن يُجاهد فيُقاتل لهواه، فكان هلاكه في الجهاد، وما هكذا يكون جند الرحمن”. “شرح الحكم العطائية” لابن عباد النفزي، ج2، صـ23.
ثانيًا: وظيفة الزوايا الصوفية في التاريخ:
كانت الزوايا الصوفية عبر العصور:
مراكز لتربية النفوس على الصدق والصبر والرباط.
مراكز لتجهيز المجاهدين في سبيل الله.
أماكن تعليم وتهيئة روحية وعسكرية للمشاركة في الجهاد.
وقد تحولت بعض الطرق – مثل السنوسية، والمريدية، والقادرية – إلى حركات دعوية جهادية كاملة، قاومت الاستعمار الأوروبي في شمال إفريقيا وغربها.
ثالثا: التوازن بين الباطن والظاهر:
التصوف لا يُنكر الجهاد الظاهر، لكنه يشترط:
تطهير النية.
التأكد من أن المجاهد لا يقاتل حمية أو طمعًا أو رياء.
أن يبدأ جهاده بجهاد نفسه، كما قال تعالى:
{وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا} [العنكبوت: 69].
الخلاصة:
فريضة الجهاد أصل راسخ في منهج الصوفية المحققين، لكنها عندهم ليست مجرد حركة عسكرية، بل هي:
فريضة شرعية تُقام بنية خالصة.
وسيلة لإعلاء كلمة الله.
مبنية على تهذيب النفس أولًا حتى يكون الجهاد نقيًّا من شوائب الهوى.
ولذا كان التصوف الحق جامعًا بين الجهادين: جهاد النفس، وجهاد الأعداء، وهما جناحان لا يفترقان.
س39: وهل فريضة جهاد أعداء الإسلام موجودة عند جميع الطرق الصوفية وفي كل عصور التصوف؟ أم قد تميزت به طريقة معينة في زمن معين؟
فريضة جهاد أعداء الإسلام كانت حاضرة في جميع طرق التصوف الأصيلة عبر العصور، لكنها برزت بقوة في بعض الطرق والحقب التاريخية تبعًا للظروف السياسية والعدوان الخارجي، فكان حضور الجهاد يتفاوت كمًا لا أصلًا، أي أنه لم يغِب أصل الجهاد في أي طريقة صوفية سليمة، وإنما تفاوتت درجة التركيز عليه والتفعيل العملي له بحسب الحاجة، والواقع السياسي، ومدى قدرة المسلمين.
أولًا: أصل الجهاد ثابت عند الجميع:
جميع مشايخ التصوف المتقدّمين تحدثوا عن الجهاد في كتبهم ومجالسهم، حتى الذين عُرفوا بالخلوات والذكر، لم يغفلوا أبدًا عن فرضية الجهاد ضد أعداء الله متى توفرت شروطه، وظهر خطر يهدد الأمة.
بل في كثير من كتب التصوف، كـ”الرسالة القشيرية”، و”الفتوحات المكية”، و”إحياء علوم الدين”، باب خاص عن الجهاد، وبيان آدابه، وشروطه، وتطهير النية فيه.
ثانيًا: الطرق التي اشتهرت بالجهاد في فترات تاريخية:
رغم ثبوت الجهاد في جميع الطرق، فقد برزت بعض الطرق أكثر من غيرها في هذا الميدان، ومن ذلك:
١- الطريقة السنوسية – ليبيا وشمال إفريقيا
أنشأها الإمام محمد بن علي السنوسي (ت 1859م)، وأسس زوايا كانت مراكز رباط وتربية وجهاد.
خرج منها قادة الجهاد الليبي ضد الاحتلال الإيطالي، مثل الشيخ عمر المختار.
كان أتباعها يبايعون على الجهاد، ويتمرّنون عليه.
2- الطريقة الشاذلية – مصر والمغرب لعبت دورًا مهمًا في الجهاد البحري ضد الصليبيين في العصور المتأخرة.
من أبرز أعلامها المجاهد الشيخ محمد الكتاني (ت 1909م)، الذي قاد المقاومة ضد الفرنسيين في المغرب.
3- الطريقة القادرية – العراق والمشرق رغم اشتهارها بالسلوك الروحي، فإن أتباعها شاركوا في الرباط على الثغور.
الشيخ عبد القادر الجيلاني حثّ على الجهاد كما مرّ معنا، وكان لمدرسته تأثير كبير في الروح الجهادية، خاصة في مواجهة المغول فيما بعد.
4- الطريقة التيجانية والمريدية – غرب إفريقيا
واجه أتباعها الاحتلال الفرنسي والبريطاني.
من رموزها المجاهد الحاج عمر الفوتي (ت 1864م)، الذي أنشأ إمارة إسلامية وكانت حربه ضد الاستعمار باسم الدين.
ثالثًا: متى قلّ حضور الجهاد؟
قلّ الكلام عن الجهاد في بعض الطرق المتأخرة، لا بسبب إنكار الفريضة، ولكن بسبب:
شدة الضعف العام في الأمة.
القمع السياسي.
التضييق على الزوايا الدينية.
اختلال الأولويات أحيانًا، حيث تحولت بعض الزوايا إلى مجرد مقامات للذكر، وابتعدت عن الإصلاح الشامل.
لكن هذا لا يُلغي الأصل، بل يدل على أن التصوف كغيره من العلوم الإسلامية، قد يعتريه ما يعتري الأمة من ضعف، ولكنه يظل يحتفظ بأصوله في كتبه وعند محققيه.
الخلاصة:
جهاد أعداء الإسلام لم يكن حكرًا على طريقة دون أخرى، بل هو أصل مشترك في جميع الطرق الصوفية السُّنية، وإن تفاوت ظهوره بحسب العصور والبيئات.
وكلما اشتد العدوان، نهضت الزوايا الصوفية والمشايخ والمريدون للمواجهة، فجمعوا بين السلاح والذكر، وبين الزهد والنصرة.
س40: نريد من فضيلتكم التدليل بحوادث تاريخية على ذلك (جهاد الصوفية لأعداء الإسلام).
الحوادث التاريخية التي تؤكد دور الصوفية في جهاد أعداء الإسلام كثيرة ومتنوعة، وهي مثبتة في كتب التراجم والتاريخ، وتتناول مشاركتهم في مقاومة الحملات الصليبية، والغزو المغولي، والاستعمار الأوروبي، إضافة إلى دفاعهم عن الثغور الإسلامية.
إليك أبرز هذه الحوادث، من عصور مختلفة:
أولًا: في زمن الحملات الصليبية:
الشيخ عبد القادر الجيلاني (ت 561هـ) – العراق
رغم أنه لم يشارك في الجهاد بالسيف، إلا أنه لعب دورًا كبيرًا في تعبئة النفوس للجهاد، وتهيئة قلوب المريدين لنصرة الإسلام.
كان يحرّض الناس في خطبه على التجرد من الدنيا والاستعداد للشهادة.
المصدر: “فتوح الغيب”، خطبة 38، صـ215.
ثانيًا: في مقاومة التتار والمغول:
الصوفية في بلاد الشام ومصر زمن الغزو التتاري (القرن 7هـ)
شارك العديد من مشايخ الصوفية في معركة عين جالوت (658هـ) التي قادها الظاهر بيبرس ضد التتار، وكان من خلفه علماء وزهاد ومتصوفة يحرضون على الجهاد ويقوّون الصفوف.
ومنهم الشيخ ابن عبد السلام (ت 660هـ)، وهو من أهل التصوف والعلم، وقد أفتى بجهاد التتار وألزم المماليك بدفع أموالهم لشراء السلاح.
المصدر: “الدرر الكامنة” لابن حجر، ج2 صـ119، و”البداية والنهاية” لابن كثير، أحداث عام 658هـ.
ثالثًا: في الجهاد البحري ضد البرتغاليين والصليبيين:
الزاوية الشاذلية في شمال إفريقيا أتباع الطريقة الشاذلية شاركوا في الجهاد البحري ضد الغزاة الأوروبيين، خاصة في المغرب وتونس، حيث كانت الزوايا مراكز تجنيد وتدريب ومرابطة.
ومنهم الشيخ أبو الحسن الشاذلي نفسه، الذي ربّى أتباعه على التوكل مع العمل والجهاد، وكان يقول:
“ليس التوكل أن تلقي بنفسك، بل أن تُعدّ ثم تتوكل”.”لطائف المنن” لابن عطاء الله، صـ59.
رابعًا: في مقاومة الاستعمار الحديث:
الشيخ عمر المختار (ت 1931م) – ليبيا، الطريقة السنوسية من أشهر رموز الجهاد الصوفي في العصر الحديث، قاد المقاومة الليبية ضد الاحتلال الإيطالي لأكثر من عشرين عامًا.
لم يكن مجرد محارب، بل مُربٍ صوفيٌ سنيٌ، شيخٌ للزاوية السنوسية في الجبل الأخضر.
قاتل أكثر من 100 معركة، وكان يُلقب بـ”أسد الصحراء”، حتى أُسر وأُعدم.
“عمر المختار، شيخ الشهداء” لمحمد الطيب الأشهب، صـ187.
الشيخ محمد بن عبد الكبير الكتاني (ت 1909م) – المغرب، الطريقة الكتانية
وقف في وجه الحماية الفرنسية، وحرّض القبائل على الجهاد، حتى قُتل ومُثّل بجثته.
“الشيخ محمد الكتاني” لمحمد بن عزوز، صـ72.
خامسًا: في إفريقيا الغربية:
الحاج عمر الفوتي (ت 1864م) – الطريقة التيجانية، غرب إفريقيا أنشأ إمارة إسلامية، وقاد الجهاد ضد الفرنسيين في السنغال ومالي.
كان من كبار العلماء الصوفية والمجاهدين.
“الحاج عمر الفوتي، المجاهد والمصلح” لمحمد المختار السوسي، صـ96.
الخلاصة:
هذه الحوادث التاريخية، وغيرها كثير، تُبرهن بوضوح أن الصوفية لم يكونوا يومًا دعاة خمول أو عزلة عن قضايا الأمة، بل كانوا في مقدمة صفوف المجاهدين حين دق الخطر أبواب الأمة.
وقد جمعوا بين:
جهاد النفس بالتزكية.
وجهاد العدو بالنصرة.
وجهاد الكلمة بالعلم والتعليم.
س41: وما هي الأمور المعينة على مخالفة النفس؟
مخالفة النفس هي اللبنة الأولى في بناء المريد، وهي أصعب مراحل السلوك إلى الله، لأن النفس ميّالة للراحة، ومحبّة للشهوات، ولا تستقيم إلا بالتربية والمجاهدة.
وقد اتفق أئمة التصوف على أن مخالفة النفس هي مفتاح السير الحقيقي، ولا يمكن للمريد أن يترقى في المقامات الإيمانية إلا إذا انتصر في معركته معها.
ولهذا حددوا أمورًا عملية وروحية تُعين على مخالفة النفس وتهذيبها، وهي تشمل:
أولًا: الصحبة الصالحة والشيخ المربّي:
وجود شيخ بصيرٍ بالطريق، يشخّص أمراض النفس، ويوجه المريد بلطف وحزم.
قال الإمام الجنيد:
“لا يتم السير إلى الله إلا بصحبة مَن يدلّ عليه”.
“الرسالة القشيرية”، صـ85.
وقال الله تعالى: {وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم} [الكهف: 28]
ثانيًا: كثرة الذكر، خاصة في الخلوة:
الذكر هو غذاء الروح وسلاح النفس، فإذا أقبل المريد على الذكر بصدق، تهاوت شهوات النفس، وسكنت رغباتها.
قال رسول الله ﷺ:”اجعل لسانك رطبًا من ذكر الله” رواه الترمذي (رقم 3375).
وقال ابن عطاء الله السكندري:
“لا تترك الذكر لعدم حضور قلبك فيه، فإن غفلتك عن وجود ذكره، أعظم من غفلتك في وجود ذكره”. “الحكم العطائية”، الحكمة رقم 5.
ثالثًا: الصيام والرياضات الشرعية:
الصيام يضعف سلطان النفس، ويهذب الشهوات، ويعوّد النفس الصبر والتحمّل.
قال ﷺ: “يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء” رواه البخاري (5065) ومسلم (1400).
وكان الصوفية يوصون المريد في بداياته بـ”صيام الاثنين والخميس، والأيام البيض”، لأنها تُليّن النفس وتفتح باب المجاهدة.
رابعًا: قيام الليل ومناجاة الله:
القيام يُربي النفس على الانكسار، ويُضعف تعلقها بالراحة والدعة.
قال تعالى: {تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفًا وطمعًا} [السجدة: 16].
وقال أبو سليمان الداراني: “أهل الليل في ليلهم ألذ من أهل اللهو في لهوهم، ولولا الليل ما أحببت البقاء في الدنيا”.”حلية الأولياء”، ج9، صـ256.
خامسًا: كثرة المحاسبة والمراقبة:
المحاسبة تُوقظ النفس من الغفلة، وتمنعها من التمادي.
قال عمر بن الخطاب:”حاسبوا أنفسكم قبل أن تُحاسبوا” “الزهد” للإمام أحمد، صـ145.
وقال الإمام الغزالي:
“المريد إذا نام عن محاسبة يومه، فهو من الغافلين، ويخشى أن يختتم له على غفلة”.
“إحياء علوم الدين”، ج4، كتاب “رياضة النفس”.
سادسًا: قراءة سير الصالحين والتأمل في أحوالهم:
النفس تُحب القدوة، وتتأثر بالحكايات والسير.
وكان أهل التصوف يجعلون “سير الأولياء” من أركان التربية، ويُوصون بقراءتها دائمًا.
الخلاصة:
مخالفة النفس لا تأتي بالقهر المجرد، بل تحتاج إلى منهج تربوي متكامل يتكوّن من:
ذكر.
خلوة.
صحبة.
صيام.
قيام.
محاسبة.
شيخ مرشد.
وهذا كله أسّسه النبي ﷺ لأصحابه، وسار عليه أهل التصوف كطريق عملي لتزكية النفس وتهيئتها لسلوك طريق الله تعالى.
س42: وهل تختلف تلك الأشياء التي يلجأ إليها المريد لمخالفة نفسه من شخص إلى آخر؟
نعم، وسائل مخالفة النفس تختلف من مريد لآخر، بحسب طبيعة النفس، ودرجة تعلقها بالشهوات، ونوع المعاصي المسيطرة عليها، ومقام السالك في الطريق.
وقد تنوّعت توجيهات مشايخ التصوف في هذا الباب، لأنهم يربّون لا ينسخون، ويعالجون لا يعمّمون.
فهم يدركون أن النفوس متباينة الطباع والميولات، ولذلك قالوا:
“مَن فقه عن شيخه نَجا، ومَن تعامل مع نفسه كمَن قبله ضلّ”.
أولًا: النفوس ليست سواسية؛
هناك نفس شديدة الشهوة، تحتاج إلى صوم دائم ورياضة قوية.
وهناك نفس تنجذب إلى الرياء والظهور، تُعالج بالإخفاء والخمول والابتعاد عن الظهور.
وهناك نفس كسولة تميل إلى الراحة، تحتاج إلى كثرة المجاهدة بالأعمال والوظائف.
وهناك نفس ذكية متفلتة، تُعالج بالعلم والمراقبة والتأمل.
قال الإمام الغزالي:
“فكما أن الطبيب لا يُعطي كل مريض دواءً واحدًا، فكذلك الشيخ لا يُعطي كل مريد سُلوكًا واحدًا”. “إحياء علوم الدين”، ج3، كتاب “رياضة النفس”.
ثانيًا: التربية الصوفية مبنية على الفراسة والتشخيص:
الشيخ المربّي ينظر إلى المريد، ويشخّص أمراض نفسه، ثم يصف له ما يُناسبه من أوراد وأعمال ومجاهدات.
قال الإمام السهروردي:
“النفس كالدابة، منها الجامح، ومنها الكليل، والمربّي لا يصلح للجميع بزمامٍ واحد”.”عوارف المعارف”، صـ118.
وقد يُكلّف شيخُ الطريق بعضَ المريدين بالصمت، وآخرين بكثرة الذكر، وآخرين بالخدمة، وكلٌّ على حسب حاله ومرضه.
ثالثًا: أمثلة من الواقع الصوفي:
1- مريد يُغلبه حب المال يُكلّف بالزهد، والصدقة، ومجالسة الفقراء.
2- مريد يُحب الظهور والسمعة يُمنع من الخطابة، ويُكلّف بالخفاء والخدمة.
3- مريد كسول في العبادة يُحث على قيام الليل والذكر المتواصل.
4- مريد متشدد مع نفسه حتى يوشك أن ييأس يُرطَّب قلبه بالأمل، والرجاء، ويُمنح شيئًا من التوسعة.
رابعًا: أقوال مشايخ الطريق:
قال الإمام الجنيد:
“السلوك طريق خاص، وكل عبدٍ له طريق خاص، فلا تسلك لغيرك ما لا يُصلح لك”.
وقال ذو النون المصري:
“الناس في أمراضهم كأبدانهم، فلا دواء واحد لهم جميعًا”.
“الرسالة القشيرية”، صـ97، و”طبقات الصوفية” للسلمي، صـ64.
الخلاصة:
التصوف الحقيقي منهج تربوي فردي، لا جماهيري.
ومخالفة النفس ليست وصفة موحّدة تُلقى على الجميع، بل علاج خاص لكل مريد، يضعه الشيخ المربّي بعد معرفة طبيعة النفس، ودرجة صدق المريد، ونوع العوائق التي تقف أمامه.
ولهذا كانت الحكمة في التربية من أبرز ميزات التصوف الحق، الذي ينزّل كل مريد منزلته، ويعامله بما يصلحه، لا بما يشتهيه.
يتبع ……………..
 مجلة روح الاسلام فيض المعارف
مجلة روح الاسلام فيض المعارف