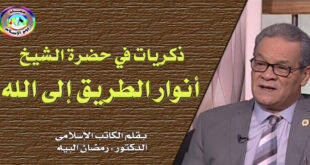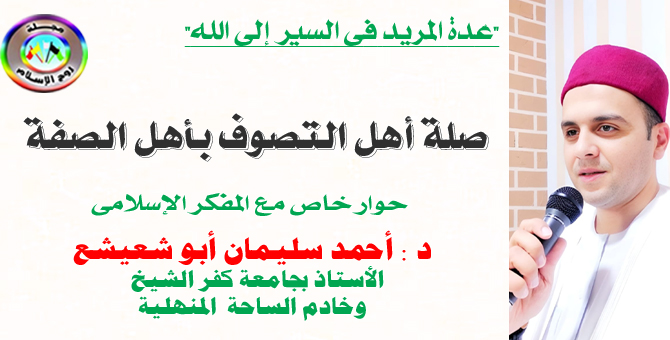
حوار خاص المفكر الإسلامى د: أحمد سليمان أبو شعيشع
الأستاذ بجامعة كفر الشيخ – وخادم الساحة المنهلية
استكمالا لسلسلة حواراتنا الصحفية عن ( عدة المريد فى السير إلى الله ) نستكمل حوارنا اليوم مع المفكر الإسلامى الدكتور : أحمد سليمان أبو شعيشع ( الأستاذ بجامعة كفر الشيخ – وخادم الساحة المنهلية )
س10: من هم أهل الصُّفَّة؟
س11: وما معنى مصطلح “أهل الصُّفَّة”؟
أولًا: من هم أهل الصُّفَّة؟
أهل الصُّفّة هم جماعة من فقراء الصحابة رضي الله عنهم، من المهاجرين خصوصًا، لم يكن لهم مأوى ولا أهل ولا مال، فكانوا يلازمون المسجد النبوي الشريف، وقد خصّص لهم النبي ﷺ مكانًا مظلَّلًا في مؤخرة المسجد، عُرف باسم “الصُّفّة”، فصاروا يُعرفون بها.
وكانت حياتهم قائمة على الزهد، والفقر، والانقطاع إلى الذكر، ومجالسة النبي ﷺ، وتلقّي العلم منه مباشرة، وبهذا كانوا نواةً لمقامات السلوك والتربية الروحية، ومثالًا عمليًّا على الإملاق الذي لا يقطع الصلة بالله، بل يزيدها وثوقًا.
من أبرزهم:
-
أبو هريرة رضي الله عنه (أشهر من لازم النبي ﷺ من أهل الصفة)،
-
سلمان الفارسي،
-
صُهيب الرومي،
-
وبلال بن رباح،
-
وعبد الله بن مسعود،
-
وعامر بن فهيرة،
-
وغيرهم، وقد قيل إن عددهم تراوح ما بين 70 إلى 400 رجل في فترات مختلفة ([1]) .
وقد كانوا يجاهدون مع النبي ﷺ، ويتعلمون منه، ويعيشون حالة من الزهد الجماعي المصحوب بالأنس بالله، ما جعلهم موضع نظر السماء، حتى قال عنهم النبي ﷺ: “اللَّهُمَّ اجْعَلْ رِزْقَ آلِ مُحَمَّدٍ قُوتًا ([2])” ؛ أي: يسيرًا يكفي حاجتهم، كما كانت حال أهل الصفة، يرضون بالقليل.
ثانيًا: ما معنى مصطلح “أهل الصُّفّة”؟
مصطلح “أهل الصُّفّة” مأخوذ من “الصُّفَّة”، وهي لغةً: المكان الظليل المرفوع في آخر المسجد؛
وفي الاصطلاح النبوي، أصبحت رمزًا لمقام مخصوص من أحوال الفقر والزهد والأنس، يعيشه أصحابه في ظلّ النبي ﷺ، مع شدّة فاقتهم، لكن عظيم قلوبهم، حتى صاروا يُمثّلون أعلى مراتب الفقر الذي لا يقطع عن الله، بل يُقرب إليه.
فـ”أهل الصفة” في المعنى الروحي هم: جماعة أرادوا الله فتركوا ما سواه، فاختاروا الظلّ في المسجد على دفء البيوت، واختاروا القرب من حضرة النبوة على متاع الدنيا، فرفعهم الله بعين التزكية قبل أن يرفعهم بين الناس.
قال الإمام ابن القيم عنهم:
” كانوا ضيوف الإسلام، وفقراءه، وعُبّاده، وأولياء الله في حضرة نبيّه” ([3]).
ملاحظات مهمة:
-
لم يكونوا متكاسلين أو متواكلين، بل كان فيهم من يعمل، ومن يخرج للغزو، ومن ينفق حين يجد.
-
وكان النبي ﷺ يكرمهم، ويواسيهم، ويشاركهم طعامه، ويحثّ الصحابة على التصدق عليهم، بل دعا لهم ولأمثالهم فقال:
“اللَّهُمَّ أَحْيِنِي مِسْكِينًا، وَتَوَفَّنِي مِسْكِينًا، وَاحْشُرْنِي فِي زُمْرَةِ الْمَسَاكِينِ” ([4]).
ولـــــذا: أهل الصُّفّة ليسوا مجرّد فقراء بلا مأوى، بل هم جماعة ربّاهم النبي ﷺ على الزهد والمعرفة والمحبة والمجالسة النورانية، وجعل منهم نواةً حيّة للأنموذج الروحي في الإسلام. ومصطلحهم يحمل في طيّاته دلالة حضورية وتربوية وسلوكية، تتجاوز المكان إلى المقام.
س12: هل أنكر النبي ﷺ على أهل الصفة زهدهم أو رقّة حالهم؟
لم يُنقل في كتب السيرة ولا دواوين السنّة أن رسول الله ﷺ أنكر على أهل الصفة زهدهم أو رقّتهم أو فقرهم، بل كان حالهم مرضيًا عنده، محمودًا في مقام السلوك إلى الله؛ بل بالعكس، كانت أحوالهم موضع عناية النبي ﷺ وبابًا من أبواب الرحمة الربّانية، وكان يواسيهم، ويُكرمهم، ويأمر الصحابة بإطعامهم ومشاركتهم.
ولم يُرَ رسول الله ﷺ يلوم أحدًا منهم على قلة ملبسه أو طعامه أو سكنه، لأن زهدهم كان عن رضا، لا عن اضطرار فقط، وكان فقرهم مصحوبًا بالتواضع والذكر ومجالسة النور.
وقد قال رسول الله ﷺ في الحديث الصحيح: “اللَّهُمَّ اجعل رِزْقَ آلِ مُحَمَّدٍ قُوتًا ([5])” (1)
وهذا دعاء يبيّن أن العيش الكافي البسيط أحبُّ إلى قلبه ﷺ من التوسّع في الدنيا، وهذا ما كان عليه أهل الصفة.
س13: ما هو موقع أهل الصفة من النبي ﷺ؟
موقع أهل الصفة من النبي ﷺ هو موقع القرب المعنوي والأنس الروحي والمجالسة التربوية؛ لم يكونوا في الهامش، بل كانوا في قلب النور، في مؤخرة المسجد لكن في مقدمة القلوب.
كان النبي ﷺ يجالسهم، يحدّثهم، يواسيهم، يُشركهم في طعامه وشرابه، بل قال في حديث أبي هريرة:”والذي نفسي بيده، لولا أن أشقّ على أمّتي، لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، ومع كل وضوء، ولأخّرت العشاء إلى ثلث الليل، ولأحببت أن أطيل الصلاة، فأسمع صياح الصبي وأتجوّز في صلاتي، رحمةً بأمّه”، وفي رواية: “وكنتُ أطيل الصلاة فأسمع بكاء الصبي، فيخفّفها رسول الله ﷺ، رحمة بأمه” (2) ([6])— وبهذا يظهر أن رحمته ﷺ تشمل كل من كان في حضرته، فما بالك بمن كان معه ليلًا ونهارًا؟
فهم لم يكونوا أصحاب حاجة فقط، بل أصحاب صحبة وسلوك، وأهل حالة وجدانية، لها مكانة مخصوصة في قلب النبي ﷺ.
س14: هل كانوا قريبِي الصلة بالنبي ﷺ؟
نعم، كانوا من أقرب الناس صحبةً ومجالسةً ومرافقةً للنبي ﷺ، بحكم مكثهم في مسجده الشريف، وتفرّغهم للعلم والذكر والعبادة، كانت حياتهم تدور في مدار حضرته، يستمعون إليه، ويصلّون خلفه، ويأخذون من أنفاسه ووجهه وهديه.
وقد قال أبو هريرة رضي الله عنه، وكان من أهل الصفة: “كنتُ ألزم رسول الله ﷺ لشبع بطني، فأحفظ ما لا يحفظه غيري”([7]) (3).
فهم لم يكونوا مجرد متلقّين، بل حفظةً، وشهودًا، ومرايا صافية تعكس تعاليم النبوة.
قال الإمام السيوطي:
“كان أهل الصفة من فقراء الصحابة، ولكنهم أغنياء بالعلم والصحبة والأنس، ولذلك كان النبي ﷺ يُفضّلهم بالذكر والتعليم والمجالسة. ([8])”
خلاصة جامعة عن أهل الصفة:
لم يُنكر النبي ﷺ على أهل الصفة زهدهم، بل كان يُحب حالهم، ويواسيهم، ويُكرمهم، ويشركهم في طعامه.
كان موقعهم منه موقع القرب الروحي والتربوي، لا الجغرافيا فقط.
وكانت صلتهم به ﷺ وثيقة، خفية في فقرهم، ظاهرة في قلوبهم، مستمرة بحضورهم حول نوره المبارك.
س15: وهل سار بعض أهل التصوّف سيرة أهل الصُّفّة من الزهد ورقّة الحال ولزوم المساجد؟
نعم، لقد سار كثير من أئمة التصوّف الحقيقيين على سيرة أهل الصُّفّة، مقتفيين آثارهم في الزهد، والفقر المختار، وترك التعلّق بالدنيا، ولزوم المساجد، والانقطاع للذكر والمجالسة في حلق العلم، والتفرّغ لتصفية القلب، بل إن الطريق الصوفي السنيّ الصحيح هو الامتداد الروحي الطبيعي لأهل الصفة، لا في الشكل فقط، بل في الجوهر والمقصد.
فكما كان أهل الصفة يعيشون في ظلّ النبوة بلا مال ولا جاه، لكن بقلوب عامرة بالله، كذلك كان أئمة التصوف يُربّون أنفسهم على الفقر لله، لا على الفقر من الناس، وعلى الزهد في الدنيا، لا على الكسل عنها، وعلى العزلة مع الله، لا عن الخَلق.
أولًا: الدليل من أقوال النبي ﷺ على فضل الفقر والزهد
قال النبي ﷺ:”اللَّهُمَّ أَحْيِنِي مِسْكِينًا، وَتَوَفَّنِي مِسْكِينًا، وَاحْشُرْنِي فِي زُمْرَةِ الْمَسَاكِينِ” ([9])
وفي هذا استحباب واضح للفقر المتواضع، لا عن عجز، بل عن اختيار وتفرّغ للقرب.
ثانيًا: نماذج من سير ومواقف أئمة التصوف
-
إبراهيم بن أدهم (ت. 160هـ): كان من أبناء الملوك، ترك القصور وسلك طريق الفقراء، قال: “طلبنا الغنى في الزهد، فوجدناه في الفقر.”
وكان يبيت في المساجد، ويأكل مما يجده في طرقات الشام، ولا يسأل الناس شيئًا.
وقد قال عنه الذهبي: “كان من أئمة القوم في الزهد، صاحب حال وسير وسفر، عاش على نهج أهل الصفة. ([10]) ”
-
الفضيل بن عياض (ت. 187هـ): كان لصًّا ثم تاب، ولازم المسجد الحرام، وقال يومًا: “كفى بالله محبًّا، وبالقرآن أنيسًا، وبالموت واعظًا، وبالقبور مستقرًّا.”
وكان يكره مخالطة الأمراء، ويحثّ على العزلة والورع.
-
سفيان الثوري (ت. 161هـ): مع كونه من أعلام الفقه والحديث، كان زاهدًا عابدًا، يُقال عنه: “كان يجلس في المسجد من الفجر حتى المغرب، ما له شُغل إلا الذكر والحديث.”
-
الجنيد البغدادي (ت. 297هـ): شيخ الصوفية في بغداد، وهو القائل: “الزاهد مَن زهد في كلّ شيء، ولم يزهد في الله.”
عاش حياته في خشوع وتقوى، لا يعرف له مال، ولا ضيعة، ولا جاه، وكانت داره بجوار المسجد، ووقته في الصحبة والمجالسة والمراقبة.
-
الشيخ عبد القادر الجيلاني (ت. 561هـ): مع أنه صار علَمًا في الوعظ والتدريس، إلا أن شبابه كان كله زهدًا وخلوة ومجاهدات، يقول عن نفسه: “دخلت بغداد وما معي سوى دراهم معدودة، فآليت ألا أسأل أحدًا شيئًا، وألا أطعم إلا من حلال.”
وكان يلزم المساجد، ويتنقّل من زاوية إلى زاوية، يقتدي في سلوكه بروح أهل الصفة.
ثالثًا: صلة أهل التصوف بأهل الصفة
ليس في التاريخ الروحي للإسلام خطٌّ أشبه بأهل الصفة من خطّ المتصوفة الأولين.
-
فقد اتخذوا من الزهد منهاجًا،
-
ومن فقر النفس مقامًا،
-
ومن المساجد بيتًا،
-
ومن التوكل طعامًا،
-
ومن الذكر حياةً،
-
ومن الصبر لباسًا.
ولذلك قيل:
“التصوف هو أخلاق أهل الصفّة، لكن بوعي وشريعة وسند.”
ولنعلم جميعًا: سار أئمة التصوّف الأوائل على نهج أهل الصفة، في زهدهم، وتركهم للدنيا، وملازمتهم للمساجد، بل زادوا على ذلك بالتأصيل العلمي، والتربية السلوكية، وبناء المدارس والزوايا لنقل هذا النور.
فأهل التصوف الصادقون لم يبتدعوا طريقًا جديدًا، بل جددوا المقامات الأولى، وذكّروا الناس بما كان عليه صفوة الصحابة.
([1])ابن حجر العسقلاني. (فتح الباري، ج1، ص 55).
([2])البخاري. (صحيح البخاري، كتاب الرقاق، باب القناعة والكفاف).
([3])ابن القيم الجوزية. (1991). مدارج السالكين (ج2، ص 215). بيروت: دار الكتاب
العربي.
([4])الترمذي. (سنن الترمذي، كتاب الزهد، باب ما جاء في معاش النبي ﷺ).
([5])البخاري. (صحيح البخاري، كتاب الرقاق، باب القناعة والكفاف).
([6])مسلم. (صحيح مسلم، كتاب الصلاة، باب تخفيف الصلاة لعارض من بكاء صبي أو نحو ذلك).
([7])ابن سعد. (الطبقات الكبرى، ج4، ص 330). بيروت: دار صادر.
([8])السيوطي، جلال الدين. (1998). تاريخ الخلفاء (ص 51). بيروت: دار الفكر.
([9])الترمذي. (سنن الترمذي، كتاب الزهد، باب ما جاء في معاش النبي ﷺ).
([10]) الذهبي، شمس الدين. (1990). سير أعلام النبلاء (ج7، ص 370). بيروت: مؤسسة الرسالة.
يتبع ……..
 مجلة روح الاسلام فيض المعارف
مجلة روح الاسلام فيض المعارف