حكم المصافحة عقب أداء الصلوات فى المسجد
12 أغسطس، 2025
شبهات حول قضايا التصوف
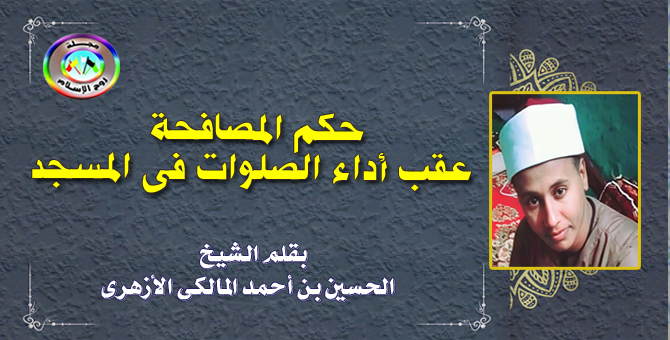
بقلم الشيخ : الحسين بن أحمد المالكى الأزهرى
الْمُصَافَحَة عَقِبَ الصَّلَوَاتِ
أوَّلا: وردت نصوص الشريعة الغراء بالترغيب في المصافحة بإطلاق من دون تخصيص لها بوقت دون وقت، ونذكر منها على سبيل المثال لا الحصر قوله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح: “ما مِن مُسلمَيْن يلتقيان فيتصافحان إلَّا غُفِرَ لهما قبلَ أن يَفْتَرِقَا”
فهل استثنى صلى الله عليه وآله وسلم من طلب المصافحة: أدبارالصلوات؟!..فلا حرج في المصافحة عقب الصلوات لأن الفعل هنا ينتظم ضمن طلب الشريعة العام بالمصافحة، وقد تقرَّر بأن المُطْلَق يجري على إطلاقه حتى يثبت في الشرع ما يُخَصِّصه، وكذلك إتيانه صلى الله عليه وآله وسلم ببعض أفراد العموم أو المطلق لا يقتضي تخصيص العموم ولا تقييد الإطلاق إلا إذا دل دليل على ذلك، فلا يجوز تخصيص المصافحة بحال دون حال أو مكان دون مكان أو زمان دون زمان إلا بدليل، فدعوى المخالف تخصيص الطلب المطلق هنا بما عدا أدبار الصلوات ليس إلا مجرد دعوى بلا دليل لا تنهض لمعارضة عموم المشروعية، ومآلها – عند التحقيق – إلى تضييق ما وسَّعه الشارع الحكيم وإبطال العمل بعمومات الشريعة، وبالتالي تبديل الأحكام الشرعية، وهذا هو بالذات سبيل البدعة الضلالة..
ثانيا: روى الإمام أحمد والبخاري واللفظ له: عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: “خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ [وآله] وَسَلَّمَ بِالهَاجِرَةِ إِلَى البَطْحَاءِ، فَتَوَضَّأَ ثُمَّ صَلَّى الظُّهْرَ رَكْعَتَيْنِ، وَالعَصْرَ رَكْعَتَيْنِ، وَبَيْنَ يَدَيْهِ عَنَزَةٌ” قَالَ شُعْبَةُ وَزَادَ فِيهِ عَوْنٌ، عَنْ أَبِيهِ أَبِي جُحَيْفَةَ، قَالَ: “كَانَ يَمُرُّ مِنْ وَرَائِهَا المَرْأَةُ، وَقَامَ النَّاسُ فَجَعَلُوا يَأْخُذُونَ_يَدَيْهِ فَيَمْسَحُونَ بِهَا وُجُوهَهُمْ، قَالَ: فَأَخَذْتُ بِيَدِهِ فَوَضَعْتُهَا عَلَى وَجْهِي فَإِذَا هِيَ أَبْرَدُ مِنَ الثَّلْجِ وَأَطْيَبُ رَائِحَةً مِنَ الـمِسْك”.
قَال الإمام الْمُحِبُّ الطَّبَرِيُّ من أيمة السادة الشافعية: ((وَيُسْتَأْنَسُ بِذَلِكَ [الحديث] لِمَا تَطَابَقَ عَلَيْهِ النَّاسُ مِنَ الْمُصَافَحَةِ بَعْدَ الصَّلَوَاتِ فِي الْجَمَاعَاتِ لَا سِيَّمَا فِي الْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ إِذَا اقْتَرَنَ بِهِ قَصْدٌ صَالِحٌ مِنْ تَبَرُّكٍ أَوْ تَوَدُّدٍ أَوْ نَحْوِهِ))
قال الإمام المحدِّث ابن عَلَّان الصِّدِّيقي الشافعي بعد أن أورد كلام الإمام المُحِب الطبري ((وأفتى حمزة الناشري وغيره: “باستحبابها [المصافحة] عقب الصلوات مطلقاً أي: وإن صافحه قبلها؛ لأن الصلاة غيبة حكمية فتلحق بالغيبة الحسية” اهـ. نقله الأشخر في فروعه، قال أبو شكيل في شرح الوسيط: “يظهر لي أنَّ تخصيص هذين الوقتين أي: العصر والصبح هو لما روي أن ذينك الوقتين لنزول ملائكة وصعود آخرين؛ إذ تَنزِل ملائكة الليل عند العصر وتصعد عندها ملائكة النهار، وتنزل ملائكة النهار عند صلاة الصبح وتصعد ملائكة الليل فاستحب المصافحة للتَّبَرُّك بمصافحتهم”. قلتُ: ولو قيل التَّخصيص بهما لمزيد فضلهما لما ذكروا أن العصر هي الوسطى، وقيل مثل ذلك في الفجر، وهما أوقات الفيوض فناسب تخصيصهما بنوع تكريم لكان أقرب والله أعلم، قال بعضهم: ومثل المصافحة عقب هاتين الصلاتين المصافحة عقب باقي الصلوات أي: ممن اجتمع به قبلها))
..
وجاء في فتاوى العلامة الشِّهاب الرَّملي الشافعي: (( (سُئِلَ) عَمَّا يَفْعَلُهُ النَّاسُ مِنْ الْمُصَافَحَةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ هَلْ هُوَ سُنَّةٌ أَوْ لَا؟ (فَأَجَابَ) بِأَنَّ مَا يَفْعَلُهُ النَّاسُ مِنْ الْمُصَافَحَةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ لَا أَصْلَ لَهَا، وَلَكِنْ لَا بَأْسَ بِهَا))
وسئل الإمام النَّوَوي: هل المصافحة بعد صلاة العصر والصبح فضيلةٌ أم لا؟ فأجاب: ((المُصافحة سنة عند التَّلَاقي، وأما تخصيص النَّاس لها بعد هاتين الصلاتين فمعدود في البدع المباحة، والمختار أنه إن كان هذا الشخص قد اجتمع هو وهو قبل الصلاة فهو بدعة مباحة كما قيل، وإن كانا لم يجتمعا فهو مُستحبٌ؛ لأنَّه ابتداءُ اللِّقاء))
ثالثا: روى عَنِ الدَّارِمِيِّ، قَالَ: “كَانَ الرَّجُلَانِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ [وآله] وَسَلَّمَ إِذَا الْتَقَيَا، وَأَرَادَا أَنْ يَتَفَرَّقَا، قَرَأَ أَحَدُهُمْ سُورَةَ: {وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ}، ثُمَّ سَلَّمَ أَحَدُهُمَا عَلَى الْآخِرِ أَوْ عَلَى صَاحِبِهِ ثُمَّ تَفَرَّقَا”)) قال الحافظ النور الهيثمي: ((رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ غَيْرَ ابْنِ عَائِشَةَ، وَهُوَ ثِقَةٌ))
فها هم الصحابة الكرام يلتزمون قراءة سورة العصر قبل الافتراق، وهو أمر لم يرد بتوقيف منه صلى الله عليه وآله وسلم في دليل خاص اللهم إلا عمومات الشريعة المرغبة في قراءة القرآن قياما وقعودا والتواصي بالحق والتواصي بالصبر وكذلك النصوص الواردة بالنهي عن فض المجلس بدون ذكر الله..
وهذا حتى مع ورود حديث “كفارة المجلس” المعروف عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ [وآله] وَسَلَّمَ: “مَنْ جَلَسَ فِي مَجْلِسٍ فَكَثُرَ فِيهِ لَغَطُهُ، فَقَالَ قَبْلَ أَنْ يَقُومَ مِنْ مَجْلِسِهِ ذَلِكَ: سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ، إِلَّا غُفِرَ لَهُ مَا كَانَ فِي مَجْلِسِهِ ذَلِكَ” فلا شك أن هديه صلى الله عليه وآله وسلم أكمل وأسد، ولكن اجتهاد الصحابة هنا يدل على أن في الأمر سعة وأنهم كانوا رضي الله عنهم يرون العمل بخلاف الأَوْلى في مثل هذه المسائل لا يقتضي تبديعا ما دام أصل العمل يندرج ضمن نصوص الشريعة العامة ولا يصادم أصلا شرعيا..
قال الشوكاني: ((وقد كان لهذه السورة [العصر] شأنٌ عظيمٌ عند السلف – رضي الله عنهم – فأخرج الطَّبراني في “الأوسط”، والبيهقي في “الشُّعَب” عن أبي مدينةَ الدَّارِمي، وكانت ما له صحبة قال: “” كان الرجلان من أصحاب محمد صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ إذا التقيا لم يتفرقا حتى يقرأ أحدهما على الآخر سورة العصر ثم يسلم أحدهما على الآخر”. قلتُ: ولعل الحاملَ لهم على ذلك ما اشتملت عليه مِنَ الموعظةِ الحسنةِ من التَّواصي بالحق والتَّواصي بالصبر بعد الحُكم على هذا النَّوْع الإنساني حُكْماً مُؤَكَّدًّا بأنَّه فِي خُسْرٍ، فإن ذلك مما ترجفُ له القلوب، وتقشعرُّ عنده الجلودُ، وتقف لديه الشعورُ، وكأن كلَّ واحدٍ من المُتَلاقِيَيْن يقول لصاحبه: أنا وأنتَ وسائرُ أبناءِ جنسنا وأهل جلدتنا خاسرٌ لا محالةَ إلَّا أن يتخلَّص عن هذه الرزيةِ، وينجُوَ بنفسه عن هذه البليةِ بالإيمان والعمل الصالحِ، والتَّواصي بالحقِّ وبالصبرِ، فيحملُه الخَوف الممزوجُ بالرَّجاء على فتح أسباب النَّجاءِ، وقَرعِ أبوابِ الالتجاءِ، فإن قلتَ: كيف وقع منهم تَخْصِيصُ هذه السورة بهذه المزيَّةِ دون غيرها من السُّوَر المختصرةِ؟ قلتُ: وجه ذلك ما قدَّمنا من اشتمالها على ما اشتملت عليه ترهيباً وترغيباً، وتَحذيراً وتَبشِيراً، وإنذاراً وإعذاراً، بخلاف غيرها من السُّوَر، فإنك تجدها غيرَ مشتملةٍ على ما اشتملت عليه هذه))
وعلى هذا الأصل قل في مسألة المصافحة عقب الصلوات ((وَيُرْوَى عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ – يَرْفَعُ الْحَدِيثَ – قَالَ: “تَصَافَحُوا، فَإِنَّهُ يُذْهِبُ الشَّحْنَاءَ، وَتَهَادَوْا”. وَقَالَ الْحَسَنُ: “الْمُصَافَحَةُ تَزِيدُ فِي الْوُدِّ”. وَقَالَ مُجَاهِدٌ: “بَلَغَنِي أَنَّهُ إِذَا تَرَاءَى الْمُتَحَابَّانِ، فَضَحِكَ أَحَدُهُمَا إِلَى الْآخَرِ، وَتَصَافَحَا تَحَاتَّتْ خَطَايَاهُمَا كَمَا يَتَحَاتُّ الْوَرَقُ مِنَ الشَّجَرِ”، فَقِيلَ لَهُ: إِنَّ هَذَا لَيَسِيرٌ مِنَ الْعَمَلِ؟، قَالَ: “تَقُولُ يَسِيرٌ وَاللَّهُ يَقُولُ: {لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ}
وقال الحافظ ابن عبد البَّر: ((فِي الْمُصَافَحَةِ أَحَادِيثٌ حِسَانٌ ذَكَرْنَا كَثِيرًا مِنْهَا فِي التَّمْهِيدِ مِنْهَا…: “مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ يَلْتَقِيَانِ فَيَتَصَافَحَانِ إِلَّا غُفِرَ لَهُمَا قَبْلَ أَنْ يَفْتَرِقَا”، وَرَوَيْنَا عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا الْتَقَوْا تَصَافَحُوا، وَقَالَ الْأَسْوَدُ وَعَلْقَمَةُ: “مِنْ تَمَامِ التَّحِيَّةِ الْمُصَافَحَةُ”، وَسُئِلَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ عَنِ الْمُصَافَحَةِ؟ فَقَالَ: “تَزِيدُ فِي الْمَوَدَّةِ”، وَرَوَى بن وَهْبٍ عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ كَرِهَ الْمُصَافَحَةَ وَالْمُعَانَقَةَ، وَكَانَ سَحْنُونٌ يَرْوِي هَذِهِ الرِّوَايَةَ وَيَذْهَبُ إِلَيْهَا، وَقَدْ رُوِيَ عَنْ مَالِكِ خِلَافُ ذَلِكَ مِنْ جَوَازِ الْمُصَافَحَةِ وَهُوَ الَّذِي عَلَيْهِ مَعْنَى الْمُوَطَّأِ، وَعَلَى جَوَازِ الْمُصَافَحَةِ جَمَاعَةٌ الْعُلَمَاءِ مِنَ السَّلَفِ وَالْخَلَفِ مَا أَعْلَمُ بَيْنَهُمْ فِي ذَلِكَ خِلَافًا إِلَّا مَا وَصَفْتُ لَكَ، وَلَا يَصِحُّ عَنْ مَالِكٍ إِلَّا كَرَاهَةُ الِالْتِزَامِ وَالْمُعَانَقَةِ فَإِنَّهُ لَمْ يُعْرَفْ ذَلِكَ مِنْ عَمَلِ النَّاسِ عِنْدَهُمْ وَأَمَّا الْمُصَافَحَةُ فَلَا..))
أَمَا الْقَوْل بِالاِسْتِحْبَابِ فَقَدِ اسْتَنْبَطَهُ بَعْضُ شُرَّاحِ الْحَنَفِيَّةِ مِنْ إِطْلاَقِ عِبَارَاتِ أَصْحَابِ الْمُتُونِ، وَعَمَّ نَصُّهُمْ عَلَى اسْتِثْنَاءِ الْمُصَافَحَةِ بَعْدَ الصَّلَوَاتِ، قَال الْحَصْكَفِيُّ: وَإِطْلاَقُ الْمُصَنِّفِ – التُّمُرْتَاشِيُّ – تَبَعًا لِلدُّرَرِ وَالْكَنْزِ وَالْوِقَايَةِ وَالنُّقَايَةِ وَالْمَجْمَعِ وَالْمُلْتَقَى وَغَيْرِهَا يُفِيدُ جَوَازَهَا مُطْلَقًا وَلَوْ بَعْدَ الْعَصْرِ، وَقَوْلُهُمْ: إِنَّهُ بِدْعَةٌ، أَيْ: مُبَاحَةٌ حَسَنَةٌ كَمَا أَفَادَهُ النَّوَوِيُّ فِي أَذْكَارِهِ، وَعَقَّبَ ابْنُ عَابِدِينَ عَلَى ذَلِكَ بَعْدَ أَنْ ذَكَرَ بَعْضَ مَنْ قَال بِاسْتِحْبَابِهَا مُطْلَقًا مِنْ عُلَمَاءِ الْحَنَفِيَّةِ بِقَوْلِهِ: وَهُوَ الْمُوَافِقُ لِمَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ مِنْ إِطْلاَقِ الْمُتُونِ، وَاسْتَدَل لِهَذَا الْقَوْل بِعُمُومِ النُّصُوصِ الْوَارِدَةِ فِي مَشْرُوعِيَّةِ الْمُصَافَحَةِ.
وَمِمَّنْ ذَهَبَ إِلَى هَذَا الْقَوْل مِنَ الشَّافِعِيَّةِ الْمُحِبُّ الطَّبَرِيُّ وَحَمْزَةُ النَّاشِرِيُّ وَغَيْرُهُمَا، وَقَالُوا بِاسْتِحْبَابِ الْمُصَافَحَةِ عَقِبَ الصَّلَوَاتِ مُطْلَقًا،.
وَاسْتَأْنَسَ الطَّبَرِيُّ بِمَا رِوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبُخَارِيُّ عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَال: “خَرَجَ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْهَاجِرَةِ إِلَى الْبَطْحَاءِ، فَتَوَضَّأَ ثُمَّ صَلَّى الظُّهْرَ رَكْعَتَيْنِ وَالْعَصْرَ رَكْعَتَيْنِ وَبَيْنَ يَدَيْهِ عَنَزَةٌ تَمُرُّ مِنْ وَرَائِهَا الْمَرْأَةُ وَقَامَ النَّاسُ فَجَعَلُوا يَأْخُذُونَ يَدَيْهِ فَيَمْسَحُونَ بِهَا وُجُوهَهُمْ، قَال أَبُو جُحَيْفَةَ: فَأَخَذْتُ بِيَدِهِ، فَوَضَعْتُهَا عَلَى وَجْهِي، فَإِذَا هِيَ أَبْرَدُ مِنَ الثَّلْجِ وَأَطْيَبُ رَائِحَةً مِنَ الْمِسْكِ” [ قَال الْمُحِبُّ الطَّبَرِيُّ: “وَيُسْتَأْنَسُ بِذَلِكَ لِمَا تَطَابَقَ عَلَيْهِ النَّاسُ مِنَ الْمُصَافَحَةِ بَعْدَ الصَّلَوَاتِ فِي الْجَمَاعَاتِ لَا سِيَّمَا فِي الْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ إِذَا اقْتَرَنَ بِهِ قَصْدٌ صَالِحٌ مِنْ تَبَرُّكٍ أَوْ تَوَدُّدٍ أَوْ نَحْوِهِ”
وَأَمَّا الْقَوْل بِالْإِبَاحَةِ فَقَدْ ذَهَبَ إِلَيْهِ الْعِزُّ بْنُ عَبْدِ السَّلاَمِ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ، حَيْثُ قَسَّمَ الْبِدَعَ إِلَى خَمْسَةِ أَقْسَامٍ: وَاجِبَةٌ وَمُحَرَّمَةٌ وَمَكْرُوهَةٌ وَمُسْتَحَبَّةٌ وَمُبَاحَةٌ، ثُمَّ قَال: وَلِلْبِدَعِ الْمُبَاحَةِ أَمْثِلَةٌ مِنْهَا الْمُصَافَحَةُ عُقَيْبَ الصُّبْحِ وَالْعَصْرِ قواعد
. وَنَقَل ابْنُ عَلاَّنَ عَنِ الْمِرْقَاةِ أَنَّهُ مَعَ كَوْنِهَا مِنَ الْبِدَعِ فَإِذَا
مَدَّ مُسْلِمٌ يَدَهُ إِلَيْهِ لِيُصَافِحَهُ فَلاَ يَنْبَغِي الإِعْرَاضُ عَنْهُ بِجَذْبِ الْيَدِ لِمَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ مِنْ أَذًى يَزِيدُ عَلَى مُرَاعَاةِ الأَدَبِ، وَإِنْ كَانَ يُقَال إِنَّ فِيهِ نَوْعَ إِعَانَةٍ عَلَى الْبِدْعَةِ وَذَلِكَ لِمَا فِيهِ مِنَ الْمُجَابَرَةِ
وَاسْتَحْسَنَ النَّوَوِيُّ فِي “الْمَجْمُوعِ” كَمَا نَقَلَهُ ابْنُ عَلاَّنَ – كَلاَمَ ابْنِ عَبْدِ السَّلاَمِ وَاخْتَارَ أَنَّ مُصَافَحَةَ مَنْ كَانَ مَعَهُ قَبْل الصَّلاَةِ مُبَاحَةٌ وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ قَبْل الصَّلاَةِ سُنَّةٌ، وَقَال فِي “الأَذْكَارِ”: وَاعْلَمْ أَنَّ هَذِهِ الْمُصَافَحَةَ مُسْتَحَبَّةٌ عِنْدَ كُل لِقَاءٍ، وَأَمَّا مَا اعْتَادَهُ النَّاسُ مِنَ الْمُصَافَحَةِ بَعْدَ صَلاَتَيِ الصُّبْحِ وَالْعَصْرِ فَلاَ أَصْل لَهُ فِي الشَّرْعِ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ، وَلَكِنْ لاَ بَأْسَ بِهِ، فَإِنَّ أَصْل الْمُصَافَحَةِ سُنَّةٌ، وَكَوْنُهُمْ حَافَظُوا عَلَيْهَا فِي بَعْضِ الأَحْوَال وَفَرَّطُوا فِيهَا فِي كَثِيرٍ مِنَ الأَحْوَال أَوْ أَكْثَرِهَا لاَ يُخْرِجُ ذَلِكَ الْبَعْضَ عَنْ كَوْنِهِ مِنَ الْمُصَافَحَةِ الَّتِي وَرَدَ الشَّرْعُ بِأَصْلِهَا
قُلْتُ: وَظَاهِرُ كَلَامِ ابْنِ عَبْدِ السَّلَامِ مِنْ الشَّافِعِيَّةِ أَنَّهَا بِدْعَةٌ مُبَاحَةٌ. وَظَاهِرُ كَلَامِ الْإِمَامِ النَّوَوِيِّ أَنَّهَا سُنَّةٌ. قَالَ الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ فِي شَرْحِ الْبُخَارِيُّ قَالَ النَّوَوِيُّ: وَأَصْلُ الْمُصَافَحَةِ سُنَّةٌ، وَكَوْنُهُمْ حَافَظُوا عَلَيْهَا فِي بَعْضِ الْأَحْوَالِ لَا يُخْرِجُ ذَلِكَ عَنْ أَصْلِ السُّنَّةِ. قَالَ الْحَافِظُ: وَلِلنَّظَرِ فِيهِ مَجَالٌ، وَبَعْضُهُمْ أَطْلَقَ تَحْرِيمَهَا. انْتَهَى. قُلْت: وَيَتَوَجَّهُ مِثْلُ ذَلِكَ عَقِبَ الدُّرُوسِ وَنَحْوِهَا مِنْ أَنْوَاعِ مَجَامِعِ الْخَيْرَاتِ)
المصادر :
١-صحيح البخارى
٢-مسند الامام أحمد
٣-سنن أبو داود
٤-سنن الترمذى
٥- الفتوحات الربانية لابن عَلَّان
٦- فتاوى الإمام النَّوَوي
٧-فتاوى الشهاب الرَّملي
٨-الفتح الرباني من فتاوى الشوكاني
٩-جامع العلوم والحكم لابن رجب الحنبلي
١٠-قواعد الأحكام
١١-المجموع للنووى
١٢-غذاء الألباب للسفارينى الحنبلى
١٣-الأذكار للنووى.
١٤-فتح الباري لابن حجر العسقلانى
١٥-الزهد لأبي داود السجستاني
١٦-شعب الايمان للبيهقى
١٧-الاستذكار لابن عبد البر
١٨- المعجم الأوسط للحافظ الطبراني
١٩-مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للهيتمى
٢٠-حاشية ابن عابدين
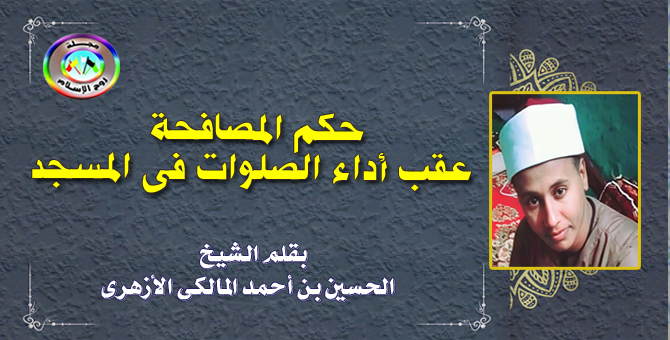
 مجلة روح الاسلام فيض المعارف
مجلة روح الاسلام فيض المعارف