محبة الأولياء
12 أغسطس، 2025
أولياء أمة محمد
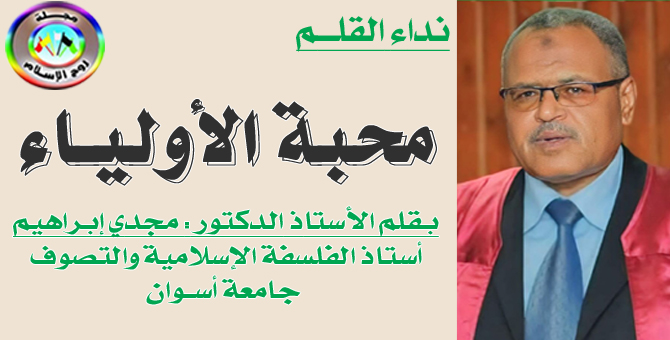
بقلم الأستاذ الدكتور : مجدي إبراهيم
أستاذ الفلسفة الإسلامية والتصوف جامعة أسوان
للإمام أبي القاسم الجنيد (ت 297 هـ) شذرة يقول فيها وهو يصف العارف إنه : (مَنْ إذا نَطَقَ عَنْكَ وَأنْتَ سَاكت!). وهو وصف مُوغلٌ في تجسيد الولاية كونها سرّاً ينطق عن السّر، وإنْ كان موغلاً في الوقت نفسه في البعد عن العقلانية التي يُشكَلُ معها النطق بالأسرار؛ لأنها تأخذ بالعموم ولا تأخذ بالخصوص، وتتوجّه إلى العقول ولا تتوجه إلى الأسرار، ولكن منذ متى تُقاس الولاية بمقياس العقول المحدودة بحدود ما تفكر فيه؟
الولاية بعيدة، بعيدة، عن حدود العقول المحدودة بحدود ما تفكر فيه، فما يطابقها أو ينطبق عليها في عملية البحث من حيث كونها منهجاً، ليس هو العقل بل البصيرة، أعلى من العقل وأرفع في ملكات الإدراك.
وإذن؛ فلابد من معرفة الجهة التي نتحدَّث فيها أو المنطقة التي ينطلق القول منها، ومعرفة ما يناسبها من عمليات الإدراك لكيلا نخلط بين حابل ونابل أو بين منهج ومنهج حين نحاكم أحدهما بالآخر في البحث والفحص والتنقيب.
وعليه؛ فلا يُفهم من قول الجنيد هذا ما يفهمه صاحب العقل المحدود حين يرى إشارته تتوغّل بعيداً عن العقلانية فيحكم بالعقل عن أشياء صدرت من منطقة الذوق والاستبصار، فلا يكون حكمه صواباً بالقياس إلى من يريد أن يقيس الشيء وهو في الوقت نفسه يجهل كيف يقاس.
وفي إطار قيم المعرفة، منهجاً وتحققاً، تجئُ صفة العارف متصلة بالإنسان حيث كان، ولكنها لا تتصل به حين تتصل إلا بالإنسان الأعلى من حيث مراقيه المعرفيّة لا من حيث هبوطه ونكوصه وترديّه.
تتجلى في المحبّة وحدة الخالق؛ لأنها فيما يقول الإمام أبو الحسن الشاذلي :”أخذت من الله لقلب عبده عن كل شيء سواه، فترى النفس مائلة لطاعته، والعقل مُتَحَصّناً بمعرفته، والروح مأخوذة بحضرته، والسّرَّ مغموراً في مشاهدته، والعبد يستزيد فيُزَاد، ويٌفاتح بما هو أعذب من لذيذ مناجاته، فيُكسىَ حُلل التّقريب على بساط القربة، ويمسّ أبكار الحقائق وثيّبات العلوم”.
لاحظ : المفاتحة لما هو أعذب من خطابات التأنيس، لا يمكن أن تكون إلا في رياض المحبّة بمقاماتها العلويّة وأحوالها الروحية العالية.
يظهر أولاً للوهلة الأولى في هذا التقسيم، غلبة التصوف السّني على الإمام أبي الحسن وخاصّة استعمال مصطلحات القشيري.
ثم ثانياً ظاهر في كلامه على التحقيق : وَحْدَة المحبوب والمعبود، إذْ تتمثل هذه الوَحْدَة في تجليات المحبّة والعبادة على القصد المُقرر في التوجه؛ فليس يُعْبَد حق العبادة إلا من يُحَب حق المحبة؛ فلئن كانت المحبّة أخذت من الله لقلب عبده عن كل شيء؛ فلأنها من أجلى تجليات المعبود، ولا شيء يدل قصداً على الإخلاص في العبادة أسمى من تنزلات المحبّة وأرقى ممّا يبذله المرء على الإخلاص سواء في المحبّة أو في العبادة، وكلاهما تجليات وحدة المحبوب والمعبود؛ فالنفس الماثلة للطاعة قوامها المحبة. والعقل المتحصن بالمعرفة أساسه المحبّة. والروح المأخوذة بالحضرة مشدودة بالمحبّة. والسرُّ المغمور في المشاهدة موصولٌ بالمحبّة.
وهكذا يصبح المحبوب والمعبود واحداً، وتصبح قوى العبد كلها (النفس، العقل، الروح، والسّر) موقوفة على تجليات الوحدة متصلة بها في أرفع قيمها العليا.
ومن أجل ذلك، قال أيضاً : أولياء الله عرائس، ولا يرى العرائس المحرومون، وهم مُخدَّرون محجوبون عنده في حجاب الأنس لا يراهم أحدُ في الدنيا ولا في الآخرة”. أو يقول، رضوان الله عليه، :”المحبة سّرُ في القلب من المحبوب، إذا ثبتَ قطعك عن كل مصحوب”.
وينبّه محذراً السالك لهذا الطريق؛ فيقول :”حرامٌ عليكَ أن تتّصل بالمحبوب، ويبقى لك في العالمين مصحوب”، غير أنه سبحانه إذا مَنَعَكَ ممَّا تحب، وَرَدَّك إلى ما يُحب، فهى علامة صحبته لك”.
إنّا لنلحظ في كلام الإمام ملاحظتين:
الملاحظة الأولى : أنّ الخطاب مُوجَّهٌ إلى هؤلاء الذين يريدون الصحبة لا إلى سواهم، ومن هنا كان خطاباً تأنيسياً، فهو ليس خطاباً لكل أحد ولا لأي أحد، ولكنه لمن يسير في طريق الأنس من طريق التحقيق طالباً له ومريداً، وإلى هذا الصنف من النّاس يتوَجَّه الخطاب ويمتنع بموجبه التوجُّه إلى غيره.
والمُلاحظة الثانية : أنّ إشارات الإمام الهمام الشاذلي في المحبّة لم تكن إلا تعزيز القول بأهمية معرفة هذا المصحوب؛ فصحبة الحق حجاب عن صحبة غيره ما في ذلك شك. إنّها لبديهة تتقرّر في كلام الإمام كما تتقرّر في كلام غيره من الأولياء. وهو سبحانه أغير الغيورين على صحبته من أن تتولاها رعاية سواه؛ فتحريمُ الاتصال بالمحبوب تفريغُ السّر له؛ لخصوصية هذا السّر بالبقاء دوماً مع الله. ولصحبة الحق شروط، وأقلُ شروطها هو الشرط الذي يمنعك من الاسترسال مع ما تحب من الأغيار؛ فهو إذا منَعكَ ممّا تحب وأعطاك ما يُحب، فقد صحت صحبتك له، وكنت من ثمّ أهلاً لموالاته. وبما أنّ الصحبة جزءٌ لا يتجزأ من الولاية؛ فصحتها بالشرط المُقرر فيها علامة على صحّة الولاية.
وعليه؛ فالوليُّ يأنسُ بالخطاب الإلهي، فيكون خطابه أنساً لغيره وموالاةً لمن يأنسُ به على من سواه.
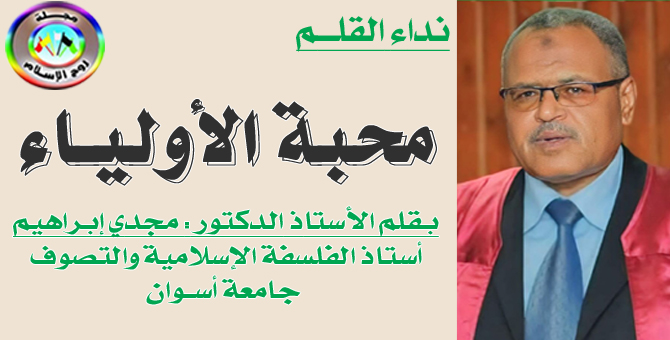
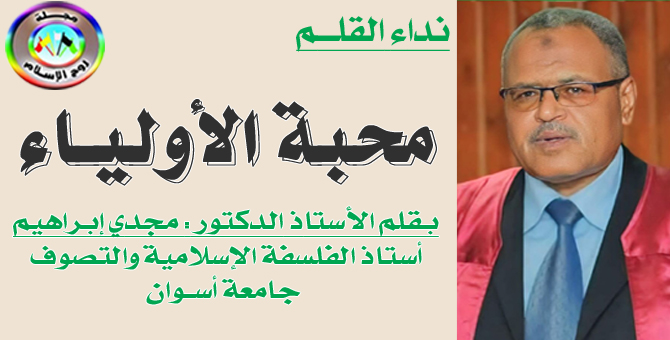
 مجلة روح الاسلام فيض المعارف
مجلة روح الاسلام فيض المعارف