الوهابية، حين تتحول العقد النفسية إلى أيديولوجيا جماعية
16 سبتمبر، 2025
الوهابية ومنهجهم الهدام
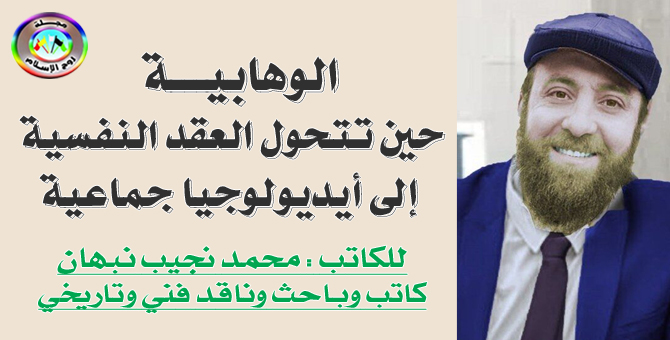
بقلم : محمد نجيب نبهان كاتب وناقد و باحث تاريخي
لم يعد ممكنًا اليوم التعامل مع الوهابية كحالة دينية فحسب، أو باعتبارها مجرد اجتهاد فقهي مشوه وقراءة سطحية غبية للنصوص، بل باتت ظاهرة نفسية اجتماعية فلسفية تقتضي مقاربة شمولية تعيد النظر في جذورها العميقة. إن استقطابها المستمر لشرائح من المجتمع، رغم انكشاف خطورتها فكريًا وسياسيًا، يشير إلى أن وراءها آليات نفسية وفلسفية أعمق من مجرد الحفظ والتلقين. لقد قمت بدراسة هذه الظاهرة عبر تتبع مسارات عدة نماذج واقعية، جمعت بين مقابلات شخصية وتحليل سلوكي واستعانة بنظريات علم النفس والفلسفة الحديثة، لأخلص إلى أن الوهابية ليست دينًا قائمًا بذاته بقدر ما هي مرآة جماعية لعُقد فردية لم تُحل، وأوجاع نفسية لم تجد من يداويها، وفراغ وجودي لم يجد من يملأه بالمعنى الأصيل.
حين ننظر إلى الطفولة بوصفها المرحلة المؤسسة للشخصية، نجد أن معظم من انجذبوا إلى الفكر الوهابي قد مروا بتجارب قاسية: أب قمعي، أم مغيبة، مجتمع يفرض العيب قبل أن يعلّم القيم، أو محيط مدرسي يعج بالتنمر والإذلال. إن فرويد يعلّمنا أن الأنا حين تتعرض لجرح مبكر تبحث عن آليات دفاعية لتعويض هذا النقص. وهكذا نجد أن الفرد الذي عاش القهر الأسري يجد في الوهابية إعادة إنتاج لصوت الأب، لكنه هذه المرة يلبس رداء النص المقدس. فالذي كان يُضرب ويُهان في صغره، يتحول عند بلوغه إلى من يضرب ويهين الآخرين تحت شعار “الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر”. إن التماهي مع الجلاد هنا يصبح أسلوبًا دفاعيًا يعيد للفرد شعورًا زائفًا بالقوة.
أما الفتاة التي تعرضت للتحرش أو التنمر على جسدها، فإنها تكبر وهي تحمل شعورًا دفينًا بالخطيئة والعار. لم تجد من يحتويها أو يرمم ثقتها بنفسها، فتسقط في أحضان خطاب وهابي يردد لها أن جسدها فتنة، وأن النجاة في محو ذاتها خلف حجاب مطبق أو عزلة اجتماعية خانقة. هنا يتجسد ما يسميه “فروم” بميكانزمات الهروب من الحرية: المرأة التي لم تحتمل مواجهة جسدها المقهور، فضّلت الهروب إلى يقين يجرّدها من ذاتها. لقد أعادت إنتاج عقدتها في صورة طهرانية صارمة. وفي هذه الحال يصبح القمع الذاتي عزاءً، وتتحول الضحية إلى شريكة في perpetuation القمع.
وإذا كان البعض يدخلون هذه الدائرة عبر الجروح، فإن آخرين يجدون فيها مخرجًا لنزعاتهم العدوانية. السادي المستتر الذي عاش عمره يبحث عن منفذ لنزواته في تعذيب الحيوانات أو السيطرة على أقرانه، يجد في خطاب الجلد والرجم والقتل شرعية سحرية. العنف الذي كان عيبًا صار طاعة، والنزعة المرضية صارت فضيلة. إن هذا يتوافق مع رؤية نيتشه حول “إرادة القوة”، ولكن في نسخة مريضة ومقلوبة، حيث تتحول القوة الداخلية إلى استعراض سلطوي مقنّع بالدين. وبذلك تعثر السادية على غطاء مقدس، وتصبح العقيدة مجرد وسيلة لتبرير الرغبة المكبوتة في الإذلال والتعذيب.
المراهق التائه في المقاهي والطرقات، الذي لم يجد في المدرسة أو الأسرة معنى لوجوده، ينجذب إلى خطاب يعده بأنه من “الطائفة الناجية”. فجأة يتحول من عابر بلا قيمة إلى جندي الله المختار. هنا يعمل ما يصفه “فيكتور فرانكل” في كتابه البحث عن المعنى: حين يعجز الفرد عن خلق معنى أصيل، فإنه يقبل بأي معنى زائف يملأ فراغه الوجودي. الوهابية هنا تقدم معنى سريعًا، يقينيًا، ومطلقًا، يعفي المراهق من مواجهة قلق الحرية، ويبدله بوهم التفوق والاصطفاء. إنها فلسفة اليقين السهل التي تجذب التائهين.
النساء المعنفات أيضًا يجدن في هذا الفكر ملاذًا. المطلقة التي لفظها زوجها، أو الأرملة التي أرهقها المجتمع بالوصم، أو الشابة التي عاشت صدمات الخيانة، كلهن قد يجدن في الوهابية وعدًا بتعويض مفقود: فهي تمنحهن “كرامة زائفة” قائمة على مراقبة الأخريات وإدانتهن. لقد تحولت بعض النساء اللواتي تعرضن للتهميش إلى أشد المدافعات عن الفكر الوهابي، لأنهن اعتقدن أن تحقير غيرهن يمنحهن سلطة معنوية لم يعرفنها في حياتهن الخاصة. ومن هنا نفهم كيف يتحول القهر الشخصي إلى أداة لإدامة قهر جماعي.
ولا يمكن إغفال فئة أخرى: أولئك الذين تعرضوا في صغرهم للتحرش الجنسي ولم يجدوا من ينقذهم. هؤلاء يكبرون محمّلين بالغضب والكراهية تجاه أجسادهم والمجتمع، وحين يجدون خطابًا دينيًا يجرّم اللذة ويقدس العقاب، يتماهَون معه بشدة. يظنون أنهم بذلك يطهّرون أنفسهم من دنس التجربة، لكنهم في الحقيقة يعيدون معاقبة ذواتهم مرارًا عبر التشدّد والكبت. إن هذا يعكس ما وصفه “لاكان” بمرحلة “المرآة” حيث يبني الفرد صورته عن ذاته في انعكاس الآخر، فإذا كانت هذه الصورة محطمة، فإنه يسعى لإصلاحها عبر مرآة مشوهة كالوهابية.
تفسيرات الفلسفة الوجودية تضيف بعدًا آخر: الإنسان، كما يقول سارتر، محكوم بالحرية، لكنه قد يهرب من قلقها إلى “سوء النية”، أي إلى الاحتماء بسلطات خارجية تبرر له كل فعل. والوهابية تقدم له هذا الملاذ: بدلاً من أن يواجه ذاته، يختبئ وراء يقين جماعي يحجب عنه مسؤولية الاختيار. أما هايدغر، فيتحدث عن “السقوط في القطيع”، حيث يفقد الإنسان أصالته ويندغم في الكثرة. والوهابية، في هذا السياق، هي التجسيد الأمثل للقطيع: فكر جاهز، يقين مطلق، وإلغاء للذات الفردية في سبيل هوية جماعية مغلقة.
التحليل النفسي، والفلسفة الوجودية، ونظريات الشخصية السلطوية كلها تشير إلى أن الوهابية تنجح لأنها تعيد صياغة العقد الفردية في صورة يقين ديني. القهر يصبح شريعة، السادية تصبح فريضة، العار يصبح حجابًا، الفراغ يصبح اصطفاءً، والتحرش يصبح مبررًا للكراهية. وهكذا نرى أن ما يبدو أيديولوجيا متماسكة، ليس إلا شبكة من الدفاعات النفسية والأمراض المعممة.
إن مواجهة هذه الظاهرة لا تكون بجدل فقهي عابر، ولا بردود من فوق المنابر، بل بمواجهة جذورها العميقة: حماية الأطفال من العنف الأسري، توفير ملاذات آمنة للنساء المعنفات، علاج الصدمات الجنسية مبكرًا، تقديم مسارات إيجابية للمراهقين لإيجاد معنى في الفن أو العلم أو العمل، وفتح فضاءات نفسية واجتماعية تسمح للإنسان أن يعيش حريته دون أن يسقط في قبضة يقين مريض.
الوهابية ليست نصوصًا جامدة، بل هي مشروع نفسي يعيد تدوير الألم الفردي في صورة مرض اجتماعي. ومن هنا خطورتها: فهي لا تقف عند حدود الفكر، بل تتسلل إلى البنية العميقة للذات المقهورة، لتصنع منها كائنًا يجد في القمع خلاصه، وفي الكراهية عزاءه، وفي إلغاء الآخر علاجًا لجرح لا يندمل.
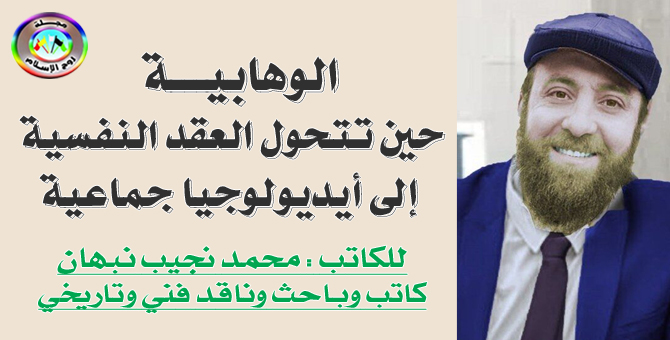
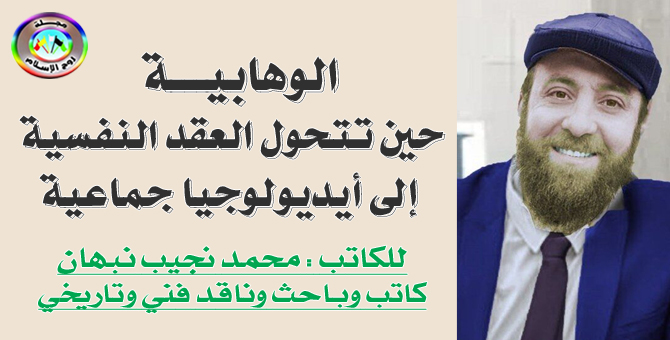
 مجلة روح الاسلام فيض المعارف
مجلة روح الاسلام فيض المعارف