التحالف المقدس
29 أغسطس، 2025
الوهابية ومنهجهم الهدام
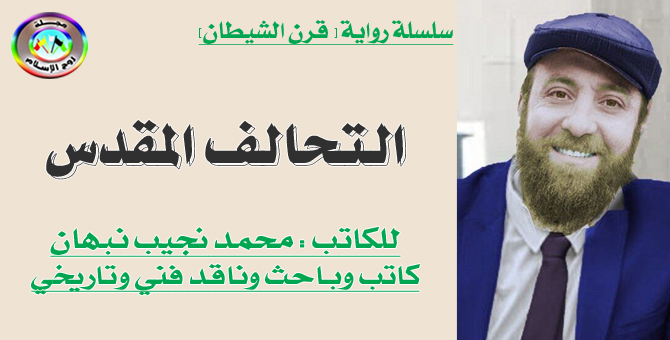
المقال السابع من سلسلة رواية (قرن الشيطان)
للكاتب / محمد نجيب نبهان
كاتب وباحث وناقد فني وتاريخي
غبار على قافلة الحجاز:
لم تكن قافلة محمد بن عبدالوهاب إلى الحجاز مجرد انتقالٍ جغرافي، بل كانت انفصالًا نفسيًّا عما تبقى من تردّد أو ارتباطٍ عاطفي بالأرض الأولى. كان الفتى النجدي قد شبَّ روحيًّا على مرجل الحنق واليقين، وصار في داخله عنف هائل يبحث عن صيغة للظهور. كانت دراسته في المدينة المنورة خطوة متوقعة لمن في مثل مكانته، لكنها بالنسبة له كانت بوابة لاختبار سلطته القادمة.
في الطريق إلى الحجاز، امتزجت مشاعر الترقب بالرهبة. كان الرمل يمتد كقدرٍ لا نهاية له، ورفاق القافلة ينشغلون بالاستعداد لموسم الحج والعلم والتجارة، فيما كان محمد غارقًا في مراجعة ما حفظه من كتب ابن تيمية وابن القيم، كأنما يريد أن يضعها درعًا على صدره حين يدخل “أرض السُنَّة”. جلس ذات مساء في محطّة استراحة، ووضع كتابًا صغيرًا على ركبته، وأخذ يقرأ بصوت خافت: “ومن لم يُكفّر المشركين أو شكّ في كفرهم فهو كافر مثلهم…”
سأله أحد الرفاق ممن حفظوا عنه صمته الطويل:
— ما هذا الذي تقرأه؟
أجابه بنظرة خاطفة:
— كلام من لا يُجامل في الحق.
— تقصد شيخ الإسلام؟
— بل أقصد الحق الذي لا يعرف إلا سيفه.
وصلت القافلة إلى المدينة أخيرًا. كانت المدينة المنورة آنذاك عاصمة العلم وملتقى الشام واليمن والحجاز والعراق، ومنارة فقهية تشع بالمالكية والشافعية، وفيها تيار صوفي مشبع بحب آل البيت وأحاديث الذوق الروحي.
أقام محمد في أحد منازل طلاب العلم، وكان مجلس شيخه آنذاك هو الشيخ محمد حياة السندي، الرجل الذي جمع بين الحديث الحنبلي والطابع السلفي الناقد للصوفية، لكن من دون حدّة أو تكفير. كان السندي قريبًا من الاتجاهات التي أحبها محمد، فدخل عليه في أحد المجالس وسلّم باحترام، ثم قال له:
— جئت من نجد ألتمس العلم على يدكم.
فأجابه السندي وهو يتأمله:
— العلم يُطلب كما يُطلب الماء… لكن الأهم: ما الذي تُريد أن ترويه به؟
لم يجب محمد، بل اكتفى بالابتسام.
في الأيام التالية، لزم الشيخ السندي، وشارك في حلقاته، لكنه كان أكثر حماسة من باقي الطلاب، وكان يُكثر من الأسئلة التي تكشف عن نزعة صدامية لا عن رغبة نقاش. سأله ذات يوم بعد درس طويل حول الشفاعة:
— ولكن يا شيخ، أليس طلب الشفاعة من غير الله شركًا صريحًا؟
رد الشيخ بهدوء:
— ليس الأمر بهذه البساطة يا محمد، هناك تفصيل في النيات والمقاصد، وقد فرّق العلماء بين الشرك الجلي والخفي، وبين الوسيلة والعبادة.
لكنه لم يقتنع. كان يرى في هذا الجواب تهاونًا، وكان يعتبر أن كل تأويلٍ هو مدخل لتمييع التوحيد.
وبعد بضعة أسابيع، بدأ محمد يزور بعض المساجد الكبيرة، لا ليصلي فقط، بل ليراقب. وجد في مسجد النبي صلوات لا تُشبه صلوات نجد، ورأى رجالاً يقبّلون المقام النبوي ويدعون عنده، ونساءً يبكين وهم يتمسّحن بجدران الحجرة النبوية. وقف بعيدًا وأطبق حاجبيه، ثم همس لنفسه:
— كيف يُستغاث بغير الله؟!
لكنه لم يكن بعدُ في موقع يُمكّنه من الاعتراض العلني. ومع ذلك، سجّل كل شيء في ذاكرته، كأنها سجلات اتهام مؤجلة.
في أحد الأيام، دخل في نقاش حاد مع طالب علم شافعي، حول مسألة التوسل بالأنبياء، فانتهى النقاش بمحمد يقول:
— أنتم لا تفهمون معنى التوحيد، أنتم تلبسون على الناس دينهم!
فقال له الطالب الشافعي:
— بل نحن نفهم أن لله رحمة، وأن في الإسلام سعة. أما أنت، فلا ترى إلا السيف.
غادر المجلس وهو غاضب، لكن ذلك الجدل ترك فيه يقينًا جديدًا: أنه لا بد من ثورة في الفهم، تبدأ من اقتلاع البدعة لا مهادنتها.
في خلواته الليلية، كان يعيد قراءة صفحات من كتب العقيدة، ويضع عليها خطوطًا حمراء، ويكتب هامشًا على بعضها:
ـ هذا مما أحدثه الناس، لا دليل عليه.
أو:
ـ يجب هدمه.
وذات مرة، وهو على السطح، جلس تحت ضوء القمر، وأخذ يتأمل المدينة. بدت له صامتة، نائمة، حالمة في سلامها. همس:
— لكن هذا السلام وهم، لأنه يقوم على شرك.
وقرر أن يكون لسان الحق، حتى لو صرخ وحده.
في أحد المجالس، قرأ بصوت مرتفع حديثًا عن “هدم القبور المشرفة”، فالتفت إليه أحد الشيوخ وسأله:
— يا فتى، هل تقرأ لفهم، أم لتجد ما يؤيد رأيك؟
قال محمد:
— وهل الحق بحاجة لتأويل؟
رد الشيخ:
— بل الفهم نفسه رحمة، لأن الله لم يجعل أحدًا ناطقًا باسمه في كل شيء.
خرج محمد من المجلس ساخطًا. كان يرى أن كل هؤلاء الذين يلبسون العمائم لا يملكون الجرأة على إعادة بناء الدين كما نزل. وكلما وجد نفسه وحيدًا، ازداد شعورًا بأنه على حق.
في تلك الأيام، وصلت المدينة بعثة علمية من اليمن، وكان معهم أحد شيوخ الطرق الصوفية، شيخ ستيني يُدعى عبدالرؤوف. سمع به محمد وقرر أن يحضر مجلسه، لا لينهل، بل ليناقض. وجلس المجلس وبدأ الشيخ يتحدث عن “مقامات السالكين” و”مراتب الوجد”، فتدخّل محمد فجأة قائلاً:
— يا شيخ، ما هذا الذي تقول؟ أتجعلون من الدين طُرقًا متفرقة؟ أما قال الله: ﴿وَأَنَّ هَـٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا﴾؟
رد الشيخ بلطف:
— يا بني، الصراط واحد، لكن النفوس تسلكه بقلوب مختلفة. والتجربة الروحية لا تُفهم كلها بالعقل، بل تُذوق.
فقال محمد:
— الذوق طريق الهلكة، والدين ليس مشاعر بل أحكام.
سكت الشيخ، وأُسدل الستار على الجلسة.
انتشر صدى المداخلة في المدينة، وبدأ البعض يتحدثون عن الفتى النجدي الذي لا يخشى أحدًا، ولا يتورع عن مواجهة الشيوخ.
في اليوم التالي، استدعاه شيخه محمد حياة السندي. دخَل عليه وجلس ساكنًا، فأشار إليه الشيخ بالاقتراب وقال:
— يا محمد، إن العلم يُثمر الحِلم، وإنّ الجدل يفسد النيّة. لا تكن خصيمًا للناس جميعًا، فالدعوة بالحكمة لا بالغضب.
أطرق محمد برأسه، لكن لم يُجب.
تابع الشيخ:
— تذكّر أن الذي يردّ الباطل بعنف، قد يكسره لا يُقنعه.
رفع محمد عينيه وقال:
— لكن يا شيخ، إن سكتنا عن الباطل، انتشر.
هز السندي رأسه وقال:
— فرقٌ بين السكوت، وبين الإحسان في البيان.
غادر محمد المجلس وهو يشعر أن كل من حوله يريد أن يُطفئ ناره. لكنه عزم على أن يُشعلها، ولو في صمت.
كان قد أمضى في المدينة أشهرًا، صار فيها أكثر حدة، وأشد يَقينًا بأن عليه مسؤولية أكبر من مجرد طلب العلم. لقد آمن في داخله أنه مُرسل، لا متعلم فقط، وأن طريق الإصلاح يبدأ من الكلمة، ثم الفتوى، ثم السيف إن لزم الأمر.
وفي إحدى ليالي ربيع الثاني، كتب في دفتره بخط ثابت:
ـ لقد رأيت الناس قد انحرفوا عن توحيد الله، وركنوا إلى القبور، وأشركوا في المحبة والطاعة، وليس أمامنا إلا إزالة هذه الجهالات، وإعادة الإسلام كما كان.
ثم أغلق الدفتر، ووضعه تحت وسادته، واستلقى على ظهره ينظر إلى سقف الغرفة الطينية، وهمس:
— ستعود يا نجد، بل ستعودين أكثر نقاءً.
وما كان يدري أن النار التي أوقدها في قلبه، ستأكل وجدان أمة بأكملها لاحقًا.
الطريق إلى اللاعودة :
في بزوغ فجرٍ رمليٍّ ثقيل على أطراف نجد، كان محمد بن عبدالوهاب يتهيأ لرحلته الأخيرة نحو قلب المواجهة، نحو حيث سيُعيد تشكيل الدين كما رآه، ويجعل من أفكاره قاعدةً لا تزول. لم يكن بعدُ شيخًا كبيرًا، ولا فقيهًا متّفقًا عليه، لكنه كان قد اجتمع في صدره حريقٌ لا يُشبه سوى زوابع الصحراء، لا تهدأ إلا إذا اقتلعت كل ما على طريقها.
كانت العودة إلى نجد من رحلته الطويلة في الحجاز، وقد قضى فيها أعوامًا متنقلًا بين الحرمين، بداية مرحلة جديدة من الصدام. رأى هناك من البدع – حسب تصنيفه – ما جعله يعتقد بأن الإسلام قد اختُطف، وأن الشرك يُمارَس في رحاب الكعبة تحت مسميات أخرى. فالموالد، والزيارات، والتوسلات، والطواف بالقبور، كلّها في نظره كانت شركًا صريحًا، وإن أنكر عليه بعض العلماء ذلك.
عاد إلى مسقط رأسه، العُيَيْنة، محمّلًا بحزمة من القناعات الصلبة التي لم يعد مستعدًا للتفاوض بشأنها. وفي ذهنه، لم يكن الناس بحاجة إلى موعظة رقيقة، بل إلى صدمة، إلى قطع جذري، إلى هدمٍ يسبق البناء. في الليلة الأولى لعودته، جالس والده الشيخ عبدالوهاب – وقد تقدّم به العمر – وسرد عليه ما شاهده في الحجاز. أطرق الوالد طويلًا، ثم قال له:
«يا محمد، الناس ليسوا على قلب رجل واحد، فلا تكن شديدًا فتكسرهم».
لكن محمدًا لم يكن ليستجيب لصوت الحكمة. رفع عينيه وقال:
«إنما الشدة في موضعها رحمة يا أبي. أأتركهم يعبدون القبور بدعوى اللين؟!»
هزّ الأب رأسه وقال: «ولكن التغيير لا يأتي بالصدام، بل بالحكمة».
فردّ محمد، وقد توهّج وجهه:
«وما الحكمة إن لم تُبْنَ على الحق المُفْرَد؟! الحق واحد، والمساومة عليه خيانة!»
لم يُطِل المقام بعدها في بيت أبيه. خرج، وبدأ يخطب في الناس، يدعوهم إلى العودة إلى التوحيد كما يفهمه. تحدّث عن هدم القباب، وحرّم الاستغاثة بالأولياء، ونهى عن الطواف بغير الكعبة. كانت خطبه نارية، لا تعرف المداراة، وكان بعض الناس يستمعون له بانبهار، وبعضهم ينفرون منه. لكن محمدًا كان يُؤمن أن الحق لا يقاس بعدد الأتباع، بل بمدى صلابته.
سرعان ما شاع خبره في أرجاء نجد، وأصبح «الشيخ محمد» حديث المجالس. وبدأت الوفود تأتيه، بعضهم طلاب علم، وبعضهم منافسون، وبعضهم متسائلون. كان يجلس في مجلسه، مرتّبًا كلماته بدقة، يشرح «كلمة التوحيد» بطريقة لم يعتدها الناس. لم يكن يكتفي بذكر أن لا إله إلا الله، بل كان يشرحها شرحًا سلبيًا، ينفي فيه كل مظاهر التوسّل، وكل ما عداه بدعة.
وما لبث أن خسر بذلك عددًا من المحيطين به. بعضهم تراجع، وبعضهم هاجمه علنًا. وكان من أبرز معارضيه شيخ فاضل من أهل بلدة قريبة، قال عنه في إحدى خطبه: «لقد خالف محمد بن عبدالوهاب أهل العلم، وجعل الأمة كلها في شرك». فردّ عليه محمد في رسالة شهيرة قال فيها:
«أما بعد، فإني لا أكفر أحدًا من المسلمين، ما لم يقع في الشرك الأكبر، وأما من عبد غير الله، فقد حكم الله عليه في كتابه، وليس لي فيه رأي».
ومع كل هذا، كان محمد يزداد إصرارًا، وكان الناس ينقسمون حوله كما ينقسم الرمل في الرياح. فكان في نظر البعض مصلحًا، وفي نظر آخرين متعجرفًا لا يفقه المداراة.
لكن نقطة التحوّل الكبرى لم تأتِ بعد.
في أحد الأيام، زار محمد بن عبدالوهاب بلدة الدرعية، وكانت آنذاك تحت حكم الأمير محمد بن سعود، رجل طموح وحاد الذكاء، وكان لديه تطلع لتوسيع سلطته في نجد. التقى الرجلان في مجلس ضيق، تحدّث فيه محمد بن عبدالوهاب عن رؤيته. صمت ابن سعود طويلاً، ثم قال:
«يا شيخ، إن دعوتك تُحرّك الأرض تحتنا، فإن تبعناك فماذا لنا؟»
أجابه الشيخ: «لك العزّ في الدنيا، والنصر في الآخرة، إن صدقت نيتك».
ابتسم الأمير وقال: «وهل تُحرّم علينا ما نأخذ من ضرائب على السوق؟»
فقال محمد: «إنها مكوس، والمكوس محرّمة».
قال ابن سعود: «أتعني أن تذهب خراجاتنا؟»
قال الشيخ: «ومن ترك شيئًا لله، عوّضه الله خيرًا منه».
كانت تلك الجملة مفتاح التحالف. أُعجب الأمير بصرامة الرجل، ووجد فيه مشروعًا دينيًا يلبّي طموحه السياسي. واتفقا على أن تكون الدعوة الدينية سندًا للدولة، والدولة حصنًا للدعوة.
ومن تلك اللحظة، بدأت ملامح الدولة السعودية الأولى في التشكّل، لا كإمارة قبلية فحسب، بل ككيان مؤسس على أيديولوجيا دينية صلبة. صار محمد بن عبدالوهاب، المؤسس الروحي، شريكًا في القرار، وموجّهًا للتشريع، ومُصدرًا للفتاوى التي تُكفّر من خالف دعوته.
وبينما كان يُعلّم الناس «التوحيد» على طريقته، كان جند ابن سعود يوسّعون الرقعة بالقوة. هُدمت القباب، وأُحرقت الكتب، وأُجبر الناس على البيعة. وكان كل من يُخالف، يُتَّهم بالشرك، ويُستباح ماله ودمه.
في تلك الأثناء، كتب أحد خصومه من العلماء:
«لم أرَ في دعوتهم نورًا، بل نارًا. ما دخلوا بلدة إلا خرّبوها، وما قابلوا خصمًا إلا كفّروه، إنهم لا يفرّقون بين التوسّل والشرك، ولا بين العابد والزائر».
لكن محمد بن عبدالوهاب، في نظر أتباعه، كان مجددًا، ومنقذًا للإسلام من الخرافة. وكان هو يُؤمن بذلك، بل يُصدّقه تمامًا. وكان يُكثر من ترداد عبارة:
«لقد جئتكم بدين جديد… لكنّه هو الدين الحق، كما نزل على محمد بن عبد الله، بلا شوائب ولا بدع».
وهكذا، اكتمل التحالف بين الدعوة والدولة، وتحولت نجد إلى مسرحٍ جديد لصراع قديم: صراع الحقيقة الواحدة ضد تعدد التأويلات.
وكان محمد بن عبدالوهاب قد بدأ الآن في كتابة رسائله الأشهر: «كشف الشبهات»، «الأصول الثلاثة»، و«كتاب التوحيد». لم تكن هذه الكتب شرحًا للعقيدة بقدر ما كانت سلاحًا أيديولوجيًا موجّهًا ضد المخالفين. فيها يقرّر أن كل من خالف هذه المفاهيم – في التوحيد والشفاعة والاستغاثة – فهو خارج عن الإسلام، أو في حده الأدنى، واقع في الشرك.
وفي ليالٍ قليلة، انتقل من أن يكون فقيهًا إلى أن يصبح إمامًا لحركة دينية كبرى، امتد أثرها إلى كل الجزيرة العربية. وصار الناس، شاءوا أم أبوا، مجبرين على التعامل مع هذه الحقيقة الجديدة: محمد بن عبدالوهاب لم يكن يطلب الإصلاح، بل كان يُقيم ثورة على الدين كما ورثه الناس.
وبذلك، لم يكن هناك عودة، لا في المعنى السياسي، ولا في المعنى الديني. لقد بدأ عصر جديد، وُلد من رحم التحالف بين التفسير الأحادي للنص، والسلطة المطلقة في السيف.
وكان الطريق إلى اللاعودة، قد سُفِر، وصار لكل من في الجزيرة أن يختار: أن يدخل في دعوة محمد بن عبدالوهاب، أو يُتّهم بالخروج عن الإسلام نفسه.
هكذا أُغلقت الأبواب خلفه، وانفتح التاريخ على صفحة جديدة، لا زالت آثارها تُرسم حتى اليوم.
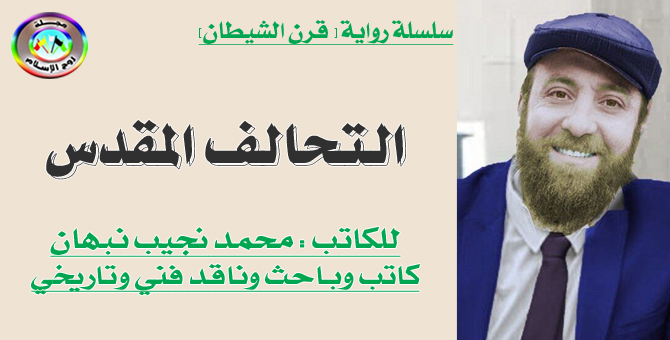
 مجلة روح الاسلام فيض المعارف
مجلة روح الاسلام فيض المعارف