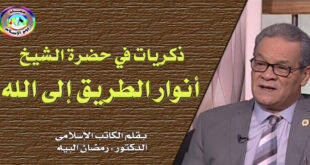( تزكية النفس أول خطوة فى درب الطريق ) حوار خاص المفكر الإسلامى د: أحمد سليمان أبو شعيشع
8 أغسطس، 2025
حوارات وتحقيقات
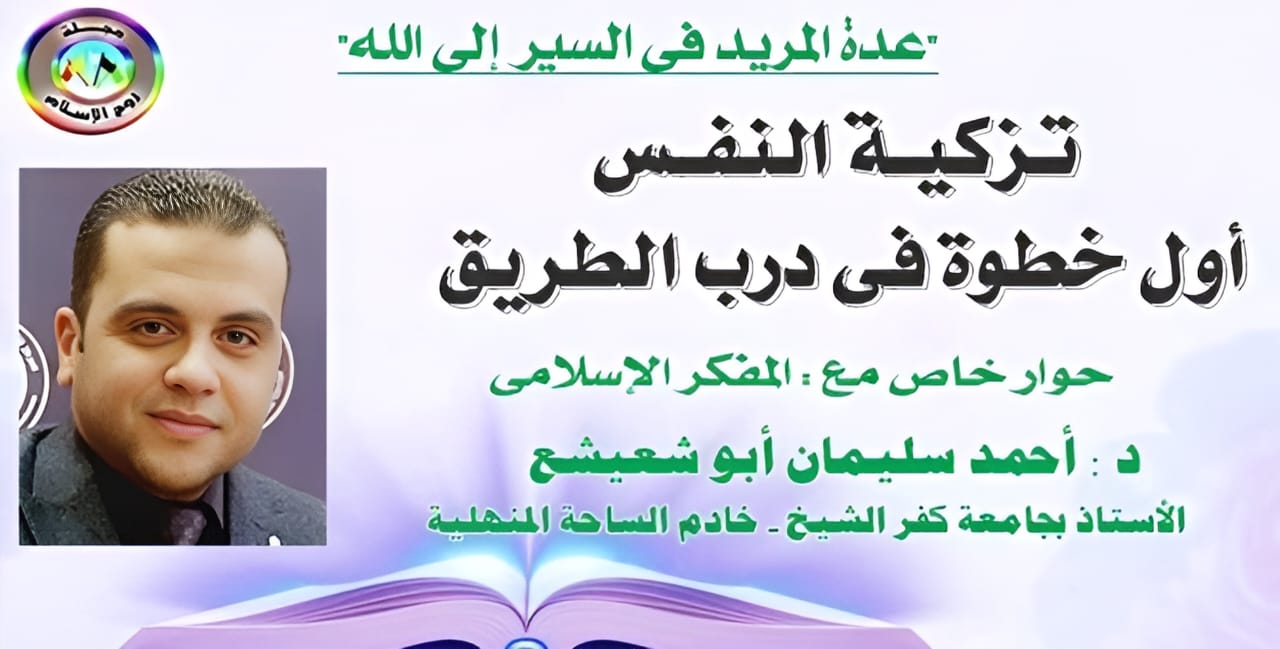
حوار خاص المفكر الإسلامى د: أحمد سليمان أبو شعيشع
الأستاذ بجامعة كفر الشيخ – وخادم الساحة المنهلية
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “أحبوا الله لما يغذوكم به من نعمه، وأحبوني لحب الله، وأحبوا أهل بيتي لحبي.
إن لله رجالًا قد اتخذوا من المحبة طريقًا لهم، فهاموا به شوقًا، وذابوا فيه وجدًا، لا يبتغون سواه محبوبًا، ولا يأنسون إلا بقربه. جعلوا قلوبهم مساكن لذكره، وأرواحهم مهاجرة إليه، فكان الله أنيسهم إذا استوحش الناس، وسندهم إذا خذلهم الخلق، ونورهم في ظلمات الطريق. أولئك هم أهل الله وخاصته، المحبون الصادقون.
وهؤلاء المحبون لم يسلكوا درب المحبة والإخلاص بين يوم وليلة ولكنهم شمروا عن سواعدهم وسارعوا سيرا إلى خالقهم فسلكوا طريق التصوف وتقدموا الصفوف الأولية ليدخلوا بين أهل الله وخاصته ولم يتوانوا فى المسير رغم صعوبة الطريق ومابها من إختبارات وإمتحانات ونور وظلمات ، فقد صعدوا درجات ودرجات من أجل الوصول ، فطريق الله لا يسلكها إلا المختارين من حضرته ، ولا ينجح فيها إلا الرجال المخلصين ، فكم من همم أعيت فى المسير ولكنها لم تكمل الطريق.
وكما قلنا فإن الطريق إلى الله تحتاج إلى الكثير من المجاهدات ، وبها العديد من الاختبارات ، وانطوت على العديد من المفاهيم المبهمة التى تحتاج إلى من يوضحها
وكما تعلمنا من ساداتنا أن خير العلم هو من نفع به العالم غيره وأفاده به ، ومن أجل ذلك تحت رعاية مجلة روح الإسلام وبكلمات وكتابات السادة المخلصين أولوا الفضل وأرباب الكلمة قمنا بعمل سلسلة من الدروس والشرح بعنوان ( عٌدة المريد فى السير إلى الله ) يشارك فيها كثير من السادة الفضلاء .
هذه السلسلة سيكون فيها العديد من المفاهيم التي أنطوت عليها الطريق ، والعديد من الشروحات عن التصوف الاسلامي الصحيح ..
داعين الله تعالى أن يتقبلها منا خالصة لوجهه الكريم وأن تكون سراجا منيراً للسائرين إلى الله ، وأن ينفعنا الله وإياكم بعظيم الكلام وأرفعه ، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم
ونبدأ باول حوار معنا مع المفكر الإسلامى الدكتور : أحمد سليمان أبو شعيشع ( الأستاذ بجامعة كفر الشيخ – وخادم الساحة المنهلية )
ما معنى تزكية النفس؟
تزكية النفس هي العمليّة الروحية المستمرة التي يتطهّر بها العبد من أدران طبعه، ويترقّى بها في مقامات القرب من الله، حتى يصير قلبه مرآةً صافيةً تعكس أنوار الحق، وتنطفئ فيه نار الشهوة والغفلة، وتشتعل فيه شموع المحبة والمراقبة والحياء.
ليست التزكية مجرّد “إصلاح أخلاقي” ولا “تخلّق اجتماعي”، بل هي سفرٌ داخلي نحو الحقيقة، تبتدئ بانكسار وتوبة، وتكتمل بالفناء في شهود حضرة الله.
قال تعالى:﴿ قَدۡ أَفۡلَحَ مَن زَكَّىٰهَا ﴾ (الشمس : 9) فربط الفلاح، وهو الغاية الكبرى، بتزكية النفس، لأن النفس بطبعها أمّارة، متقلبة، مشغوفة بالدنيا، لا تستقيم إلا بالمجاهدة والتهذيب والمراقبة.
وقال النبي ﷺ “ألَا إنَّ في الجَسَدِ مُضْغَةً، إذا صَلَحَتْ صَلَحَ الجَسَدُ كُلُّهُ، وإذا فَسَدَتْ فَسَدَ الجَسَدُ كُلُّهُ، ألَا وهي القَلْبُ ” ([1])
فالتزكية تبدأ من القلب، لأنه أصل الشعور، ومعدن النية، ومحلّ نظر الربّ سبحانه”إنَّ اللهَ لا يَنظُرُ إلى صُوَرِكُمْ، ولا إلى أجْسادِكُمْ، ولَكِنْ يَنظُرُ إلى قُلُوبِكُمْ”. ([2])
ويمكننا أن نقول: تزكية النفس هي تحريرها من سلطان الأنا، وغسلها بماء الذكر، وجعلها مرآةً لحضرة الله، حتى تصير مطمئنّة، راضية، مرضيّة.
فهي تعني:
-
التخلية من الرذائل كالكبر والرياء والغفلة،
-
والتحلية بالفضائل كالصبر والتواضع والإخلاص،
-
والمجـاهدة المستمرة حتى تصير النفس تحت سلطان الروح لا الهوى.
وقد قال الإمام الغزالي:
“تزكية النفس فرعٌ من معرفة عللها، فلا يزكّي نفسه إلا من أبصر فسادها، ومتى لم يعرف المريض علّته لم يصحّ علاجه”. ([3])
وهل توجد أدلّة شرعية من القرآن الكريم والسنّة النبويّة تدلّ على مصطلح “تزكية النفس”؟
نعم، مصطلح تزكية النفس ليس مصطلحًا طارئًا من اجتهادات المتصوفة أو علماء السلوك، بل هو مأخوذ بنصّه ومبناه من القرآن الكريم، ومؤيّد ببيان السنّة النبوية المطهّرة، فالتزكية في أصلها مفهوم شرعي إيماني، سابق للتقسيمات الفقهية والكلامية، قائم على دعوة الله لعباده أن يرتقوا من عبوديّة الهوى إلى عبوديّة الحق.
أولًا: من القرآن الكريم
ورد لفظ “تزكية النفس” ومعناه في عدّة مواضع، منها:
-
﴿ قَدۡ أَفۡلَحَ مَن زَكَّىٰهَا ﴾ (الشمس: 9)
دلالة قاطعة على أن فلاح العبد مرهون بتزكية نفسه، أي تطهيرها من أدران المعصية وتربيتها على الطاعة.
-
﴿ قَدۡ أَفۡلَحَ مَن تَزَكَّىٰ ﴾ (الأعلى: 14)
والتزكي هنا عامّ، يشمل طهارة الظاهر والباطن، والسياق يدلّ على أنّ ذلك سابق للدعاء والصلاة.
-
﴿ خُذۡ مِنۡ أَمۡوَٰلِهِمۡ صَدَقَةٗ تُطَهِّرُهُمۡ وَتُزَكِّيهِم بِهَا ﴾ [التوبة: 103]
فالزكاة المأخوذة تطهّر النفس من البخل، وتزكّي القلب بالإيثار والكرم، وهنا “تزكّيهم” بمعنى: تنمّيهم روحيًّا وتطهّرهم سلوكيًّا.
-
﴿ وَلَٰكِن يُزَكِّي مَن يَشَآءُ ﴾ (النور: 21)
إشارة إلى أن التزكية ليست مجرّد جهد فردي، بل هي توفيق من الله، يُعطى لمن صدق في المجاهدة وأحسن الظنّ بربّه.
ثانيًا: من السنّة النبوية
السيرة النبوية جاءت شارحة لهذا المفهوم، ومن الأحاديث:
“ثلاثٌ مُنجياتٌ: خَشيةُ اللهِ في السرِّ والعَلانِيَةِ، والعدلُ في الرِّضا والغَضَبِ، والقَصْدُ في الفَقرِ والغِنَى” ([4]) والمقصود أن هذه الصفات تُزكّي النفس وتطهّرها من التناقض والهوى والانحراف.
1- وجاء في دعاء النبي ﷺ:
“اللَّهُمَّ آتِ نَفْسِي تَقْوَاهَا، وَزَكِّهَا، أَنْتَ خَيْرُ مَن زَكَّاهَا، أَنْتَ وَلِيُّهَا وَمَوْلَاهَا” ([5])
دعاءٌ جامع، فيه إقرار بأن النفس لا تُزكَّى إلا بإذن الله، وأنه وحده سبحانه القادر على تصفيتها من شوائبها.
2- وقال ﷺ عن القلب:
“إذا صَلَحَتْ صَلَحَ الجَسَدُ كُلُّهُ، وإذا فَسَدَتْ فَسَدَ الجَسَدُ كُلُّهُ، ألَا وهي القَلْبُ ([6])
فالقلب محل التزكية، إذ لا يمكن أن تستقيم الجوارح دون أن يستقيم الباطن أولًا.
خلاصة:
تزكية النفس حقيقة قرآنية وسنّية، وهي من أركان الطريق إلى الله، بل من لوازم الإيمان الكامل، إذ لا يُتصوّر فلاح بدونها، ولا معرفة بالله دون تصفية ما بين العبد وربّه من حجب المعصية والغفلة.
وهل أثَر أن النبي ﷺ راضَى أصحابه، بمعنى ساس نفوسهم؟
نعم، ثبت في السيرة النبويّة أن النبي ﷺ لم يكن فقط نبيًّا مشرّعًا، بل كان سيّدًا للنّفوس، سائسًا للقلوب، مؤدّبًا لأرواح أصحابه رضي الله عنهم، يسوسهم بحكمة الوحي، ويعالج نوازعهم البشرية بأنوار الرحمة والعلم واللطف.
فالتربية النبوية لم تكن عشوائية ولا خطابية، بل كانت قائمة على فنّ السياسة الروحية، وهي أعمق من مجرّد التوجيه الأخلاقي، وهذا المعنى هو ما تشير إليه كلمة “راضى”، أي روّض النفس وساسها حتى خضعت واستقامت.
أولًا: بيان هذا المعنى في القرآن الكريم
قال تعالى واصفًا مقام النبي ﷺ: ﴿ لَقَدۡ جَآءَكُمۡ رَسُولٞ مِّنۡ أَنفُسِكُمۡ عَزِيزٌ عَلَيۡهِ مَا عَنِتُّمۡ حَرِيصٌ عَلَيۡكُم بِٱلۡمُؤۡمِنِينَ رَءُوفٞ رَّحِيمٞ ﴾ (التوبة: 128)
هذه الآية تُبرز أبعادًا نفسية وروحية في علاقة النبي ﷺ بأصحابه، فهو لا يعلّمهم فقط، بل يتألم لأجلهم، ويتلطّف معهم، ويحنو على ضعف نفوسهم، وكلها صفات المربّي الراسخ، الذي يسوس الأرواح ولا يتركها لجهلها أو نزقها.
ثانيًا: أمثلة نبوية لسياسته ﷺ لنفوس أصحابه
1- حادثة الشاب الذي جاء يستأذنه في الزنا:
روى أحمد أن شابًا جاء إلى النبي ﷺ فقال: “يا رسول الله، ائْذَنْ لي بالزِّنَى!”؛ فزجره الناس، أما النبي ﷺ فقال له بلطف وحكمة: “أترضاه لأمّك؟”
قال: لا.
قال: “ولا الناس يرضونه لأمهاتهم…” ثم وضع يده عليه وقال:
“اللهمّ اغفر ذنبه، وطهّر قلبه، وحصّن فرجه ([7])
فهذا ليس فقط ردعًا، بل سياسة تربوية نفسيّة، فيها احتواء للنفس، وفتح باب للفهم، ثم دعاء بالتحوّل الداخلي.
2- موقفه من حاطب بن أبي بلتعة:
حين أخطأ حاطب وكاد يُفشي سرّ التوجّه إلى مكة، أراد عمر رضي الله عنه قتله، لكن النبي ﷺ قال: “إنه قد شهد بدرًا، وما يدريك لعل الله اطّلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم، فقد غفرتُ لكم” ([8])
فكان ﷺ يسوس النفس بالعذر والتأويل والستر، ما دام القلب موصولًا بالإيمان.
3- حادثة ثمامة بن أثال:
أسرته الصحابة وربطوه في المسجد، فلم يعنّفه النبي ﷺ، بل تركه يرى حال المسلمين ويشهد صلاتهم، حتى قال في اليوم الثالث: “والله ما كان وجهٌ أبغض إليّ من وجهك، وإنه لأحبّ الوجوه إليّ.”
فهذه سياسة صامتة، لا تجري فيها الكلمات، بل تحكيها الهيبة، والرؤية، والمقام.
ثالثًا: معنى “ساس نفوسهم”
نقول: نعم، لقد راضى النبي ﷺ نفوس أصحابه بمعنى ساسها، وعلّمهم كيف يسيّرون أنفسهم بأنفسهم.
-
كان يعرف طبائعهم وأمزجتهم، ويكلّم كلّ واحد منهم على قدره،
-
يربّيهم بالحال والمقام، لا فقط بالمقال،
-
لا يكسرهم، بل يُلينهم حتى تلين قلوبهم لله.
وكما قال الإمام القشيري:
“النبيّ ﷺ أدّب أصحابه بالحال قبل أن يُعلّمهم بالمقال. ([10])
وفى الختام نعم، أثَر وتواتر أن النبي ﷺ راضى أصحابه وساس نفوسهم، وكان فيهم كالروح في الجسد، يُحيي قلوبهم، ويهذب غرائزهم، ويُخرجهم من ضيق النفس إلى سعة الروح، وهذه هي أعلى مراتب التربية النبوية، التي سار على منهاجها العارفون والمربّون من أهل الله.
([1]) مسلم. (صحيح مسلم، كتاب المساقاة، باب فضل الزرع والغرس).
([2]) مسلم. (صحيح مسلم، كتاب البر والصلة، باب تحريم ظلم المسلم وخذله)
([3]) الغزالي، أبو حامد. (1986). إحياء علوم الدين (ج3، ص 60). بيروت: دار المعرفة.
([4]) الطبراني، المعجم الكبير، حديث رقم 13648.
([5]) مسلم. (صحيح مسلم، كتاب الذكر والدعاء، باب التعوذ من شر النفس)
([6]) مسلم. (صحيح مسلم، كتاب المساقاة، باب فضل الزرع والغرس).
([7]) ” أحمد بن حنبل. (المسند، حديث الشاب المستأذن في الزنا).
([8]) البخاري. (صحيح البخاري، كتاب المغازي، باب بعث النبي ﷺ خالد بن الوليد إلى بني جذيمة .
([9]) مسلم. (صحيح مسلم، كتاب الجهاد، باب أسر ثمامة بن أثال).
([10]) القشيري، أبو القاسم. (2002). الرسالة القشيرية (ص 45). بيروت: دار صادر.
يتبــع ..
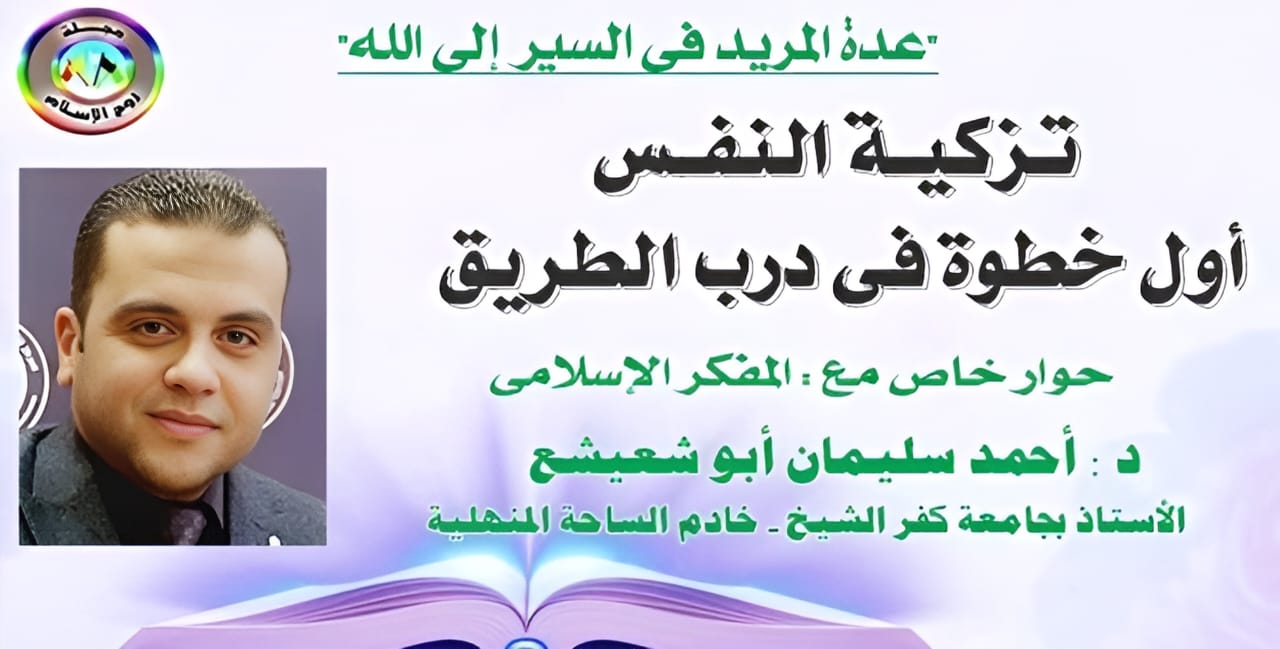
 مجلة روح الاسلام فيض المعارف
مجلة روح الاسلام فيض المعارف