ظلال الحيرة والتكوين الأول لشخصية ابن عبد الوهاب
6 أغسطس، 2025
الوهابية ومنهجهم الهدام
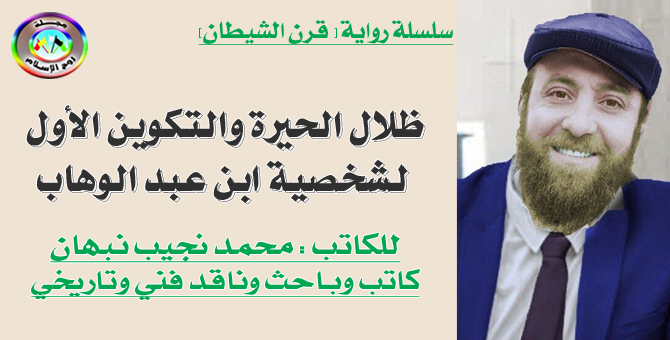
المقال الرابع من سلسلة رواية (قرن الشيطان)
للكاتب / محمد نجيب نبهان
كاتب وباحث وناقد فني وتاريخي
نار في العروق ـ صدى النار في العقل الصغير:
في مساءات الدرعية، لم يكن الصمتُ هادئًا، بل مثقلاً بما تخفيه العيون وتكتمه الأنفاس. فالأطفال، وإن بدا لعبهم صاخبًا، كانوا مرآةً صافية لما يعتمل في صدور الكبار، يعكسون مخاوفهم المكبوتة، وتناقضاتهم، ونزعاتهم الطائفية والدينية. وكان محمد، الفتى النجدِيّ، يحمل في وجهه المثلّث الملامح، عينين زجاجيتين لا تُظهران دهشة، بل تُقشِّران ما حولهما ببطء يشبه تأمّل الحيوان المفترس لفريسته. لم يكن الطفل طفلًا بالمعنى الدارج. كان عقله الصغير يضجّ بأسئلة أكبر من جسده، يراقب ويحسب ويستنتج دون أن ينطق، كأنما خُلق للنظر، لا للعيش.
لقد نشأ محمد في بيت علمٍ وتديُّن، حيث يختلط الحنبلية بالتقوى الصارمة، ويصير الفقه بابًا للخشية أكثر منه بابًا للرحمة. كان والده عبدالوهاب من فقهاء زمانه، يعلّم الناس في المسجد، ويفسر لهم المتون، ويُنزِل آراء ابن تيمية منزلة الوحي. وكان الصبي الصغير يجلس خلف الأب، ينصت لا للفهم بل للسيطرة: كيف يَخضع الناس؟ كيف تُروّض العقول؟ كيف يمكن لشيخٍ أن يجعل الرجال، أصحاب العمائم واللحى، يُومئون برؤوسهم في طاعةٍ تلقائية؟ تلك كانت أولى لمحات الافتتان بالسلطة الروحية في عقل محمد الطفل.
وفي البيت، كان الخوف ضيفًا دائمًا، خوفٌ من النار، من المعصية، من البدعة، من “الضلال”، من كل ما ليس هو. كانت أمّه تتحدث عن الجنّة والنار كما لو أنهما غرفتان في البيت. وكان إخوتُه الكبار يعيدون ما يسمعون في المجالس من آيات العذاب، يردّدون قصص الحرق والصلب واللعن كما يردّد الأطفال أسماء الألعاب. نشأ محمد بين أفواه تمضغ الجحيم، وتلوك العقاب، وتصبغ الدين بلون الدم والوعيد.
لكنه لم يكن سهلَ الانقياد. في عينيه بريق مقاومة لا يراه إلا من دقّق. لم يكن مطيعًا طاعة الخائف، بل طاعة المُترقّب. وفي الليالي الطويلة التي يقضيها وحده، كان يفكر: “لماذا كل هذا العذاب؟ لماذا نخاف الله أكثر مما نحبه؟ لماذا الجنة لا تُعرض إلا ببابٍ من نار؟”. ثم يُسرع بالاستغفار سرًّا، خشية أن يسمعه الله، أو يسمع وساوسه أحدُ الملائكة.
كان أبوه يأخذه إلى حلقات الدرس، يجلسه بين الرجال، وهو لم يتجاوز بعدُ العاشرة. وكانت مفاهيم “الولاء والبراء”، و”الجهاد ضد المبتدعة”، و”تكفير أهل الأهواء”، تُزرع في أذنه كالطعون، دون أن يُدرك أنها ستنمو يومًا ما شجرًا مسمومًا. وكان محمد يتلقفها بنهم، لا من باب القناعة، بل من باب الشغف بفكرة الحقيقة المطلقة، التي لا تقبل التأويل، ولا ترضى بالاختلاف.
كانت الدرعية آنذاك، برغم بساطتها، مشحونةً بتيارات صامتة. فالقبائل تتنازع خفية، والحكام الصغار يتربص بعضهم ببعض، والحجاز يُنظر إليه بريبة، والبصرة ببغضٍ مكتوم، واليمن يُلعن من فوق المنابر. وبين كل تلك الحدود المتخيلة، كان محمد الصغير يُدوِّن في ذاكرته “من هو نحن؟ ومن هو هم؟” دون أن يعرف أن تلك الأسئلة ستقوده إلى سيوف التكفير.
ذات يوم، وبينما كان والده يراجع مخطوطات قديمة، سمعه يتمتم بحديثٍ عن أحد أجدادهم الذين انزلقوا إلى “البدعة”، وكيف أنّ ذلك كان سببًا في قَطْع النسب الروحي عن السلف. لم يفهم محمد كل شيء، لكنّ كلمة “البدعة” ظلّت ترنّ في رأسه كما يرنّ الطبل في وادٍ فارغ. وبدأت تتكوّن في روحه فكرة أن الخطأ الديني ليس كأي خطأ: إنه جريمة، خيانة، رجسٌ يستوجب الإبادة.
وكان يقضي وقت فراغه في تصفّح كتب والده، يتنقّل بين الحواشي والمتون، يتوقّف أمام الفتاوى الغريبة، يخطّ بقلمه الصغير هوامش من الأسئلة: “لماذا؟ وهل هذا يعني كفرهم؟ وما مصيرهم؟”. وكان عقله يأبى التفسير اللين، ويميل إلى النص القاطع، السيفيّ، الذي لا يترك مكانًا للتأويل.
وذات ليلة، بينما كانت أمه تخبره حكاية عن أحد الأولياء الصالحين، انفجر قائلًا: – كيف يكون صالحًا وهو ميت؟ كيف تسمونه وليًّا وتستغيثون به؟ هذا شرك! ارتعدت الأم، وضربته على فمه، لكنها أدركت حينها أن روحًا أخرى سكنت جسد هذا الطفل، روحًا لا تُشبه إخوتَه، ولا أبناء الجيران.
في سن الثانية عشرة، بدأ محمد يرتاد المساجد الأخرى في الدرعية، لا ليُصلي فقط، بل ليراقب. كان يدوّن ملاحظاته في دفترٍ صغير: من يستغيث بمن؟ من يتوسل بمن؟ من يقبّل القبور؟ من يدعو الأموات؟ كانت ملامح مشروعه تظهر، لا كرغبة في الإصلاح، بل كهوسٍ بالمطابقة. الدين في ذهنه معادلة لا تقبل خطأً واحدًا. وكل انحراف، مهما بدا بسيطًا، هو بوابة إلى الكفر الأكبر.
ثم جاء اليوم الذي سمع فيه والده يقول أمام بعض تلامذته: “الناس ضلّوا الطريق، لكن لا بد من اللين في الدعوة، فليس كلُّ مبتدعٍ بكافر”. عندها شعر محمد بالغضب الصامت، ورأى في والده، لأول مرة، رجلاً متردّدًا، يخشى الناس أكثر مما يخشى الله، ويُراعي القلوب أكثر مما يراعي الحقيقة.
وهنا، بدأت أولى بذور القطيعة تنمو في صدره.
كانت طفولة محمد بن عبدالوهاب، كما تبدّت في هذه المرحلة، طفولة فريدة، لا تسير على نمط العادي، ولا تستسلم لمجرد التلقين. كان طفلًا ينظر إلى العالم على أنه ميدان معركة بين “حقه” و”باطل غيره”، وأنه المنتدب، المختار، المكلف بتطهير الأرض من الشوائب التي لوثتها عادات الناس، وبدعهم، وموروثاتهم التي تراكمت كالطين على وجه التوحيد.
وكان يرى في ذاته قدرة غريبة على التمييز، على الفصل، على القطع، على الحسم. لم يكن يكتفي بترداد ما يسمع، بل ينسج منه خيوط مشروعٍ داخلي، يتبلور تدريجيًا، كأنّ نبوءةً ما تولد فيه، تؤمن أن العالم بحاجة إلى نبي جديد، أو على الأقل إلى سيفٍ يُصلح ما أفسدته القرون.
وهكذا، كان صدى النار في العقل الصغير يتردد، يعلو، يتسع، حتى بدأ يحرق ما حوله من طمأنينة، استعدادًا لولادة الحريق الأكبر…
ولم يكن يعرف أحد بعدُ، أن تلك النار، ستغيّر وجه الجزيرة كلها
ظلال الحيرة والتكوين الأول:
لم يكن محمد بن عبدالوهاب حينذاك قد غادر الدرعية، ولا عرف من العالم إلا حدود نجد الرملية، ولا وطئت قدماه أرضًا أوسع من تلك الطرق المتعرّجة التي تفصل المسجد عن السوق، والبيت عن حلقة الدرس. لكن داخله كان قد بدأ يرحل. رحلاته الأولى لم تكن على ظهور الجمال، بل على أجنحة التساؤلات التي تنبض في صدره الصغير كدفعات قلب لا يستقر. كان ينظر إلى العالم من حوله كمن يكتشف شيئًا فاسدًا تحت غطاءٍ جميل. رأى القباب تُزار، والقبور تُمسح، والدعاء يُرفع إلى غير الله، فرأى في كل ذلك انحرافًا، خيانةً لنقاء التوحيد الذي ارتسم في عقله الصارم كمرآة لا تقبل الغبار.
الطفولة عند محمد لم تكن مساحة للدهشة أو البراءة، بل كانت أشبه بما يمكن أن يُسمّى “مرحلة التحفّز”. لم يكن يتفاعل مع الأقران، ولا يندمج مع لعب الصبية، بل كان كمن يجلس على حافة الطفولة، مراقبًا. كلّ شيء بالنسبة إليه كان يحتاج إلى فحص: سلوك الأم، طريقة والده في إلقاء الدرس، دعاء الخادمة، حركة الإمام عند رفع يديه، كيف يُغسل الميت، متى يُقبّل القبر، هل يُقال “يا رسول الله” أم لا. كل شيء قابل للتحليل. كانت الحياة لديه معادلة، لا قصيدة.
وفي المساء، حين تسكن الأصوات وتخفت الأضواء، كان يحدّق في سقف البيت الطيني ويعيد ترتيب الفتاوى في ذهنه. لم يكن ذهنه باحثًا عن تسلية، بل عن نظام، عن سلطة، عن هندسة صارمة للحق والباطل. في إحدى تلك الليالي، سمع حديثًا بين أبيه وزائرٍ مسنّ عن “كرامة” وقعت لشيخٍ في البصرة، حيث قيل إنه طار من مكانه إلى الشام في لحظة! بدا الضيف مندهشًا، وأخذ يكرّر: “سبحان الله!”، أما محمد فقد شعر بقشعريرة لم تكن إعجابًا، بل رفضًا. ما هذا التهريج؟! هل يُعقل أن الدين – الذي يُفترض فيه أن يكون منضبطًا كالهندسة – يُسلّم بالخوارق كأنها مزحة؟ ومنذ تلك اللحظة، بدأ يبغض الخرافة، لا من منطلق عقلاني، بل من منطلق سلطوي: لأن الخرافة تُضعف القبضة، تُرخي العقل، وتمنح الناس عذرًا في عبور التوحيد.
كبرت عيناه، ولم يكبر جسده بعد. أصبح صمته أكثر فتكًا من الكلام. وحين يتكلم، لم تكن نبرته خاضعة لصوت الأطفال. كان يتحدث ببطء، كأن كل جملة يحملها على كاهله، ثم يُسقِطها ثقيلة. نظرته للناس صارت تتغير. لم يعد يرى الوجوه، بل يرى “الانحرافات”. لا يوجد إنسان صالح بالكامل، لا يوجد مجتمع مستقيم، لا وجود لدين بلا شوائب. كان كل من حوله متّهمًا بالبدعة حتى تثبت براءته، ولم يكن يُصدر الأحكام علنًا، بل يبتلعها في صدره، يكتبها في وريقاته الخاصة، ويعلّقها في سويداء قلبه كأدلة على عالم ينبغي تقويمه.
ذات يوم، وهو في حلقة لأحد الشيوخ المحليين، سمع تفسيرًا لآية تتعلق بـ”الشفاعة”، وكان الشيخ يحاول تقريب المعنى، فجاء بمثال بسيط عن رجلٍ صالح يشفع لأهله في الآخرة. انفجر قلب محمد من الداخل. من هذا الذي يسمح لنفسه بتفسير القرآن بهذا التساهل؟ من الذي خوّله أن يجعل لأحدٍ سلطة بين الله وعبده؟ كان ما سمعه كضربة خنجر في ظهر يقينٍ يتكوّن. عاد إلى البيت، وفتح كتب ابن تيمية، وعاد يقرأ تلك الجمل التي كانت تشبه المقاصل: “من دعا غير الله فقد أشرك”، “الشفاعة لا تكون إلا بإذن الله”، “الاستغاثة بالمخلوق شرك أكبر”. وكلما قرأ، شعر أن النار في صدره تأكل شيئًا من الطفولة، وتبني فيه رجلاً لا مكان فيه للتسامح.
في البيت، لم يكن يجد كثيرًا من الأمان الروحي. كانت أمه ساذجة دينيًا، تخلط بين العادة والدين، تدعو الأولياء، وتبكي عند قبور الصالحين. وكان أبوه، رغم ما له من مكانة، متردّدًا في إشهار بعض الأحكام. رأى فيه محمد شيخًا ضعيفًا، يُراعي الناس أكثر مما يُراعي الحق. لم يقل له ذلك، لكنه بدأ ينفر من طريقته، ويُدخِل في وعيه أن المشايخ الكبار لا يعني أنهم الأقرب إلى الصواب.
ومع ذلك، كانت كتب الأب كنزًا لا يُقدّر. وبدأ محمد يقرأ كل ما تقع عليه عيناه: متون العقيدة، شروح الحديث، فتاوى علماء القرون الأولى، أقوال ابن تيمية، ومن بعده ابن القيم. وكان كل نص يُشبه لبنة جديدة في بناء داخلي، لكن هذا البناء لم يكن صومعة هدوء، بل قلعة قتال. بدأ يُدوِّن أفكاره كمن يكتب بيانًا أوليًّا لحرب قادمة. لم يكن يكتب ليفهم، بل ليُعدّ نفسه.
وحين وصل إلى سنّ المراهقة، صار أكثر انعزالًا. لم يعد يخرج إلا نادرًا. وكان بعض أبناء جيله يتهامسون: “إنه متكبّر”، وآخرون يقولون: “مجتهد”، لكنه لم يكن يهمه أحد. في داخله، كان يرى نفسه رسولًا مؤجّلًا، ينتظر لحظة الإعلان.
ومع تزايد قراءاته، بدأت تتكوّن في ذهنه صورة للمجتمع الكامل، مجتمع يخلو من القباب، ومن الذبائح لغير الله، ومن الحلف بالنبي، ومن الموالد، ومن القصائد التي تتغزّل بالأولياء. لم يكن يتخيّل الجنّة، بل يتخيّل مجتمعًا يُشبه المعسكر، طاعةٌ، خشيةٌ، صفوفٌ متراصة، وضبطٌ عقائدي صارم. لم تكن نظرته أخلاقية، بل إيمانية صلبة: الحق يُؤخذ لا يُناقَش.
ثم جاء يومٌ ألقى فيه خطبة في مسجد صغير، وكان الحضور من البسطاء، وقد ظنّوا أنه سيحدثهم عن التقوى أو الصلاة. لكنه فاجأهم بهجومٍ قاسٍ على “البدع”، على “زيارة القبور”، على “أولياء الطرق”، على “شرك الاستغاثة”. كان يتحدث كمن يحمل رسالة من السماء. وبعد الخطبة، انقسم الناس، بعضهم صمت، وبعضهم همس بأن الفتى متطرّف. أما هو، فقد شعر بنشوةٍ لا مثيل لها: أخيرًا قال ما يفكر فيه.
وفي الأيام التالية، بدأت النار تتّقد أكثر. كان كل حدث – صغير أو كبير – يُغذّي رغبته في إعادة تشكيل الدين. سمع رجلاً يُقسم بالنبي، فكره الأمر حتى المرض. رأى امرأة تبكي على قبرٍ، فكاد يصرخ فيها. في السوق، سمع الناس يمدحون “كرامات” الرفاعي، فشعر بأن القيح يسيل من الأذان.
كل هذا جعله يرى نفسه مكلفًا، لا عاديًّا. لقد بدأ يشعر أنه مسؤول عن توحيد الله في الأرض. أن الله اختاره لا بالوحي، بل بوضوح الرؤية. لقد فهم، والآخرون لم يفهموا، إذن عليه أن يهديهم، أو يُطهر الأرض منهم.
وهكذا، وبين جدران الطين، وتحت سقف القش، وفي قلب نجد، كانت النار تكبر. لم تكن نارَ محبةٍ ولا نارَ شغفٍ بالحقيقة، بل نارٌ تُراد أن تحرق، أن تُطهِّر، أن تُعيد خلق العالم وفق عقل طفلٍ صار يظنّ نفسه ميزانَ الحق والباطل.
وفي ليلة من الليالي، كتب محمد في دفتره الخاص:
“سيأتي يومٌ يُمحى فيه الشرك، وتُهدم القباب، ويُغلق باب كل وليّ، وتُخرَس ألسنة أهل البدعة. لن يُعبد إلا الله، كما أريد أنا، لا كما أرادوا هم.”
ثم أغلق الدفتر، ونام.
لكن الجزيرة لم تنم بعدها أبدًا…….
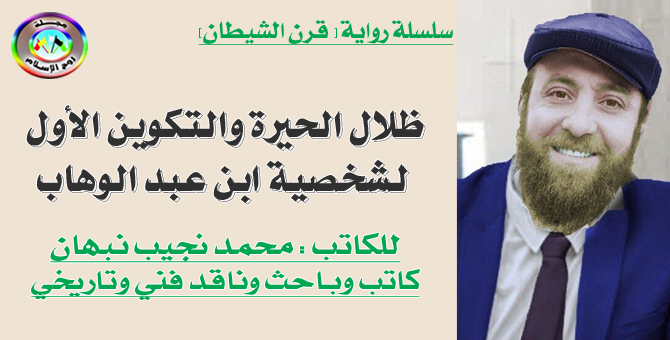
 مجلة روح الاسلام فيض المعارف
مجلة روح الاسلام فيض المعارف