الدم الذي يسيل من الكتب
16 أكتوبر، 2025
الوهابية ومنهجهم الهدام
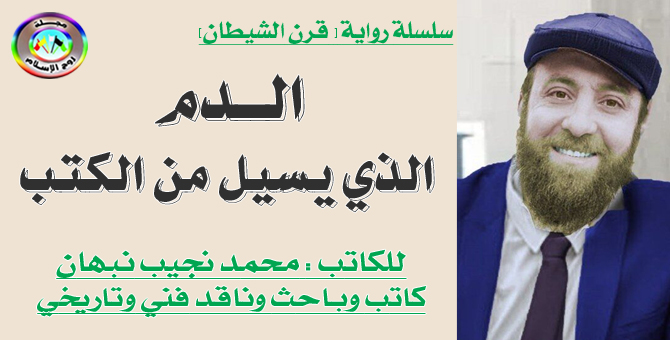
المقال العاشر من سلسلة رواية (قرن الشيطان)
للكاتب / محمد نجيب نبهان
كاتب وباحث وناقد فني وتاريخي
في فم الثعبان ـ نزاع بين الشريعة والروح:
حين أُغلقت أبواب المجلس في الدرعية، وظل محمد بن عبدالوهاب وحده مع أفكاره، لم يكن أمامه إلا أن يواجه نفسه، بمرآتها القاسية، تلك التي لا تزيّف ولا تجامل. لقد أصبح واضحًا أن مسار دعوته لم يعد يدور حول “الحق” و”البدعة”، بل بات يتقاطع بخيوطٍ حادّة مع مفهومٍ أقدم وأكثر تعقيدًا: السلطة.
صوت في داخله ظلّ يتكرر: – “أنت تُقاتل لأجل الله؟ أم لأجل نفسك؟”
الجواب لم يكن سهلاً. خصوصًا وقد بدأت معالم مشروعه تأخذ شكلًا سياسيًا أكثر مما هي وعظية أو إصلاحية.
كان يجلس يوميًا في بيته في حي الطريف، بعد مجالسه الصباحية، يستقبل الوفود من القرى المحيطة. البعض يطلب الفتوى، والبعض الآخر يسأله عن شرعية قتال جيرانه، أو إخراج الناس من ديارهم بحجة الشرك. وكانت أجوبته تزداد حدة، كما لو أن الشك الذي داخله لم يكن يضعف موقفه، بل يدفعه نحو مزيد من الإصرار، كأنّه كلما راوده صوت الروح، رفع صوته بالشريعة.
في تلك الفترة بدأت الدرعية تتحوّل من مجرد بلدة صغيرة في وادي حنيفة إلى مركز سياسي روحي، ومقر مشروع متصاعد. وكان محمد بن سعود، زعيمها، يدرك أن هذا الرجل القادم من العيينة، ذو العمامة البيضاء والجبين الحاد، ليس مجرد واعظ، بل زعيم أفكار، يُشعل القرى كما تُشعل الكلمة نارًا في هشيم.
في إحدى الجلسات بين محمد بن عبدالوهاب وابن سعود، قال له الأخير: – “أراك يا شيخ محمد تتحدّث كأنك حاكم، لا كأنك فقيه.”
ابتسم الشيخ وقال: – “الشرع حاكم يا محمد، وأنا خادمه.”
لكنّ ابن سعود لم يكن غافلًا. كان يعرف أن هذا “الخادم” قد بدأ يصوغ الشرع على مقاس دعوته، ويوجه الناس بما يشبه الأوامر لا الفتاوى.
في رسائله إلى بعض تلاميذه، بدأ الشيخ يطلب ما هو أكثر من البلاغ والدعوة:
“ينبغي على من علم التوحيد أن يُجاهد لنشره، ولا يُقعدنّه قومٌ يعبدون الله على جهل، فالعقيدة لا تكتمل إلا بجهاد من يُخالفها.”
لكن “الجهاد” هنا لم يكن عسكريًا خالصًا.
لقد بدأت النواة تتكوّن.
مشروع دولة، تُبنى على دعوة، تتوسّع باسم الدين، وتُساق تحت رايةٍ مكتوب عليها “لا إله إلا الله”، ولكنها تخفي سيفًا في غمد السياسة.
كان بعض علماء نجد قد كتبوا إليه مستنكرين شدّة تكفيره، وسهولة تبديعه للعلماء والناس، فردّ عليهم في رسالة قال فيها:
ـ “لا نُكفّر أحدًا إلا بعد إقامة الحجّة، ومن أصرّ على التبرّك بالقبور أو دعا غير الله من دون الله، فهو مشرك.”
لكن مع الوقت، أصبح معيار “إقامة الحجّة” يُختصر بزيارة قصيرة أو جدال من طرفٍ واحد.
وأصبح المقياس: من لا يقبل دعوتنا، فهو معارض لله ورسوله.
كان هذا التوسّع في المفهوم هو ما جعل العديد من وجهاء القرى يخشون الشيخ أكثر مما يخشون سيف ابن سعود. فالسيف يُفهم، ويُساوَم عليه. أما التكفير… فلا نجاة منه.
في إحدى الليالي، دخل عليه تلميذه حسين بن غنام، وكان من أبرز من رافقه في رحلته الفكرية، وقال له: – “يا شيخ، لقد صارت كتبنا تُدرّس في القرى كأنها قرآن. وأصبح المريدون لا يسمعون لغيرنا.”
ردّ الشيخ: – “أليس هذا نصرًا؟”
فقال ابن غنام: – “بل قد يكون فتنة.”
ولم يردّ محمد. بل أمسك قلمه، ودوّن في دفتره: “حين يُصبح النصر بابًا للغرور، فاعلم أن الله يبتليك.”
ومع ذلك، لم يغيّر شيئًا من مساره.
كانت بلدة العيينة قد أُعيد ذكرها في ذهنه، تلك التي طُرد منها قديمًا بعدما خاف شيخها عثمان بن معمر من بطش الدولة العثمانية. الآن، صارت العيينة تُرسل وفودها إليه خاشعة، تطلب رضاه، وتعلن التوبة عن “شركها”.
التحوّل لم يكن في القرى فقط، بل في قلب محمد نفسه.
بدأ يُراسل قبائل الشمال والشرق والجنوب، يدعوهم إلى “التوحيد”، لكنه يشترط عليهم السمع والطاعة، والتبرّؤ من الطرق الصوفية، وتدمير القباب والمزارات. وفي بعض الأحيان، كان يُرسل المقاتلين قبل الرسائل.
كتب عنه أحد أبناء الأحساء في مذكراته: “إنه لا يدعو، بل يأمر. ولا يُبيّن، بل يُهدّد. وقد صارت البلاد تخاف من دعوته أكثر من أن تحبّها.
لكن محمد لم يكن يرى في ذلك ضلالًا. بل اعتبره “حزمًا في الأمر”، وكتب في إحدى خطبه: “إن التوحيد لا يثبت في الأرض إلا إذا اقتُلِعَ الباطل من جذوره، ولا تُصلح العقيدة أنصافُ المواقف.”
في تلك المرحلة، كان الشيخ ينام أربع ساعات في اليوم، يقضي النهار في الإفتاء والمجالس، والليل في المراسلات والتأليف. لكنّ وجهه صار حادًّا أكثر، كأنّ عينيه لم تعودا تبكيان شيئًا.
ورغم الازدياد في نفوذه، لم يكن يفرح إلا نادرًا. كأنّ في داخله ألمًا لا يعرف كيف يسمّيه. أهو ألم الضمير؟ أم ألم القيادة؟
في إحدى لحظات تأمله، كتب: “لا أدري هل أُقيمُ دولةً أم أُقيمُ حجة؟ وهل يحسنُ بالفقيه أن يُغلق باب التوبة على الناس؟ أم أنّ الناس أغلقت باب الله قبل أن نطرقها؟”
ثم طوى الورقة، وقال: – “لن أنظر خلفي. فالخلف كان قبورًا، وأنا أُريد دارًا لا شرك فيها.”
لكنه كان يعلم، في قرارة نفسه، أن قبرًا واحدًا قد يهدمه، كفيل بإشعال قبائل كاملة.
وأن الدين، حين يُمسك به رجل يبحث عن يقين مطلق، قد يتحوّل إلى مطرقة لا عصا.
وهكذا، لم يكن الشيخ رجل دين فقط.
بل كان رجل مشروع، يرى في القرآن خارطة سياسية، وفي السنة مرآة لقيام الدولة، لا فقط لضبط أخلاق الفرد.
وكان يوقن أن الصراع الحقيقي، لم يكن بينه وبين المخالفين، بل بينه وبين تردده.
وحين انتصر على تردده، لم يعد هناك سلاح إلا استُخدم.
ولا نصّ إلا أُوِّل.
ولا خصم إلا وُصف بأنه “عدو التوحيد”.
وفي تلك اللحظة، دخل إلى “فم الثعبان”.
فلا هو عاد مصلحًا، ولا أصبح سلطانًا.
بل صار شيئًا بين الاثنين، لا يعرف كيف يعود، ولا يملك إلا أن يتقدّم… ولو على جمر.
الدم الذي يسيل من الكتب:
لم يكن محمد بن عبدالوهاب قد أكمل عقده الرابع حين بدأ يشعر أن الأفكار التي خطّها في دفاتره بدأت تنفلت من محبرته. كانت الكلمات التي دوّنها على وجل في الليالي الطويلة، والمفاهيم التي صاغها في حلقات النقاش، قد نزلت إلى الأرض. لكن لا كما أراد لها أن تكون. بل كما أراد لها أن تُستخدم.
صوت الكتب صار أعلى من صوت البشر. لكن رائحة الدم كانت أقوى من رائحة الحبر.
بعد أن تصاعد الخلاف مع بعض شيوخ نجد ومكة والمدينة، بدأت الأخبار تتسرّب إلى مجالس العلماء. الاتهامات تتطاير: هذا يُكفّر الأشاعرة، وذاك يُقصي الصوفية، وآخر يحرّض العامة على كسر القبور وهدم الأضرحة. وسرعان ما تحوّلت الحلقات الفقهية إلى جبهات مشتعلة، كل طرف يتسلّح بما يملك من نصوص، ومن خلف النصوص تتوارى النفوس، بعضها مضطرب، وبعضها جائع للسلطة.
ومع كل هذا، كان محمد بن عبدالوهاب قد بدأ يُعيد كتابة نفسه على صورة جديدة: صورة “المنقذ”.
لم يكن مجرد رجل دين يبحث عن إصلاح في العقيدة، بل رجل أدرك أن الإصلاح دون سلطة… مجرد أمنية.
في مجلس ضمّ بعض تلامذته المقرّبين، سألهم:
– “هل رأيتم يومًا كتابًا يُهزم جيشًا؟”
أجابه أحدهم باستغراب: – “العلم أقوى من السيف، يا شيخ.”
فقال محمد وهو يضم كفيه كمن يقبض على شيء غير مرئي:
– “ليس بعد اليوم. من أراد للعلم أن ينتصر، فعليه أن يحمل السيف أيضًا.”
هكذا خرجت دعوته من رحم المجادلات الفكرية إلى ميدان السياسة، ثم إلى رحى الحرب.
في ذلك الوقت، كانت كتب العقيدة تُنسخ وتوزّع على القبائل كما تُوزّع المناشير الثورية.
أرسل محمد رسائل إلى رؤساء العشائر في نجد والقصيم والأحساء، يقول فيها:
“من أطاعنا فهو أخونا، ومن خالفنا فقد استحق السيف.”
كان الخطاب واضحًا، لا لبس فيه: “العقيدة أولاً، والطاعة شرط، ومن خالف فهو مشرك.”
لم يكن ثمة مكان للوسط. لا في الدين، ولا في الولاء.
في تلك الأيام، بدأت الحوادث تتكاثر.
في بلدة “المجمعة”، اقتحم بعض أتباعه مسجدًا قديمًا فيه ضريح لأحد الأولياء المحليين. هدموا القبر، وكتبوا على جدران المسجد: “من تعظّم القبور فقد عبد غير الله”.
وفي “حريملاء”، وُثّق مشهد مؤلم لشيخ طاعن في السن يُطرد من حلقته لأنه رفض القول بتكفير زائر القبور.
قال لهم: – “لقد علّمني مشايخي أن نُحسن الظن بالناس، وأن الجهل لا يُكفّر، وأن الرحمة مقدمة على العقوبة.”
فقال له أحدهم: – “مشايخك كانوا أهل بدعة. أمّا نحن، فمشايخنا كتاب التوحيد وحده.
بدأ محمد يشعر أن ما خطّه في الكتب صار يُستخدم سلاحًا، لا مرجعًا.
وفي إحدى ليالي الدرعية، بينما كانت أصوات الجدل تملأ الدار من الداخل، سمع في الخارج صياحًا.
خرج، فوجد غلامًا مراهقًا يُعنّف رجلًا سبعينيًا، ويصرخ في وجهه:
– “قل إن زيارة القبور بدعة! قل إن أمك ماتت على الشرك!”
تجمهر الناس، والشيخ الكبير يهمس باكيًا: – “لكنها كانت تصلي وتصوم وتدعو الله ليلًا ونهارًا…”
فصرخ الغلام: – “وهل دعاها محمد أن تزور قبرًا؟”
اقترب محمد، ونظر في وجه الغلام.
كان يرى فيه صورته القديمة، لكنه مشوّهة.
رأى في عينيه الحماسة ذاتها، والجهل ذاته، لكنه ممزوج الآن بالبطش.
عاد إلى غرفته، وفتح أحد دفاتره.
كتب فيه:
“الدم يسيل من الكتب إذا قرأها الأحمق بعين الحقد، لا بعين الفقه.
إذا استُخدم العلم لتبرير الانتقام، صار السيف آية، وصار القبر جبهة، وصار الإنسان حطبًا.”
لكن الطريق إلى الوراء لم يعد متاحًا.
في ذات الفترة، بدأ محمد بن سعود، زعيم الدرعية، يلتفت لدعوة محمد بن عبدالوهاب كفرصة لا كقناعة.
قال لأحد خاصته: – “إنه يحرّك الناس كما يُحرّك الراعي غنمه، فلم لا نكون نحن السور الذي يحيط بالحظيرة؟”
تلاقت الرغبتان:
– عبدالوهاب يريد نشر دعوته، لا سيما بالقوة.
– وابن سعود يريد توسيع سلطته، ولو بالدين.
اتفقا أن يكون لمحمد بن عبدالوهاب “الفتوى”، ولابن سعود “الراية”.
وهكذا تم تدشين عهد جديد، كان ظاهرُه توحيدًا، وباطنُه توسّعًا.
وفي أحد دروسه بعد هذا الاتفاق، قال محمد بن عبدالوهاب لتلاميذه:
“اعلموا أن الله لا يقبل إلا دينًا خالصًا، والدين الخالص لا يقوم في أرض يكثر فيها القبور، ولا يقام في بلاد يعمّ فيها الجهل. فمن لم يطهّر الأرض من الشرك، فلا يدخلنّ الجنة، وإن صلّى وصام.”
كانت كلماته أكثر قسوة من ذي قبل.
وكان التلاميذ أكثر حماسة، والناس أكثر خوفًا.
في نهاية ذلك الأسبوع، وقعت حادثة في “الزلفي”، حين اجتمع بعض أتباعه على شيخ قال: – “أمي كانت تتبرك ببعض آثار النبي، فهل في ذلك حرج؟”
فما كان من أحدهم إلا أن قال: – “أمك مشركة.”
ثم أُخرج من المسجد بالقوة.
وصل الخبر إلى محمد بن عبدالوهاب، فصمت طويلًا.
سأله أحدهم: – “هل توافق على ما حدث؟”
فقال: – “لو سكتنا على الشرك من أجل مشاعر الناس، لمات الإسلام.”
ثم أضاف:
– “إن ديننا لا يقبل التجميل… إما أن يُؤخذ كله، أو يُترك.”
لكن في تلك الليلة، وهو وحده أمام محبرته، كتب:
“لقد أصبح الحبر دمًا، وأصبح القبر جريمة، وأصبح الحزن نفسه بدعة…
فمتى يعود الإنسان إنسانًا؟ ومتى تصير الدعوة حبًا، لا رعبًا؟
لقد تحولتُ من رجل يقرأ كتب الفقه، إلى رجل تكتب كتبه جرائم لم أقصدها.”
ومع اقتراب الفجر، وهو يسمع صوت المؤذن من بعيد، أغلق دفتره، وقال:
– “اللهم لا تجعلني سببًا في إراقة دمٍ باسمك.”
لكنه كان يعلم، في قرارة نفسه، أن الدم لم يعد يطلب إذنًا.
بل يسبق الدعوة، ويصير فتوى… ثم سلاحًا.
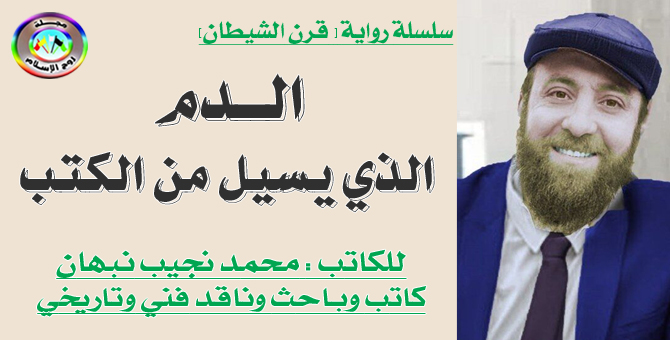
 مجلة روح الاسلام فيض المعارف
مجلة روح الاسلام فيض المعارف