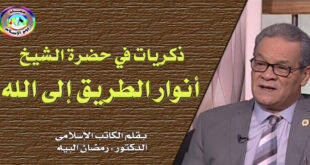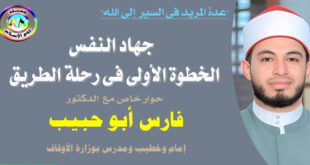حوار خاص مع المفكر الإسلامى د: أحمد سليمان أبو شعيشع
الأستاذ بجامعة كفر الشيخ – وخادم الساحة المنهلية
استكمالا لسلسلة حواراتنا الصحفية عن ( عدة المريد فى السير إلى الله ) نستكمل حوارنا اليوم مع المفكر الإسلامى الدكتور : أحمد سليمان أبو شعيشع ( الأستاذ بجامعة كفر الشيخ – وخادم الساحة المنهلية )
س16: وهل ساحات الصوفية لها أصل شرعي في السنة النبوية؟
نعم، ساحات الصوفية – بمعناها الصحيح لا المبتدع – لها أصل شرعي وروحي في السنة النبوية، وإن لم تُسمَّ بهذا الاسم، فإن الوظيفة التي تقوم بها كانت حاضرة في عهد النبي ﷺ، وتجلّت في المسجد النبوي وحلق الذكر والصحبة والمجالسة والمراقبة، وكلها أصول تأسست عليها هذه الساحات لاحقًا.
فليست ساحات التصوف الحقيقي مجرد مجالس للأناشيد أو الطقوس، بل هي مواطن لذكر الله، وتلاوة القرآن، وتعليم المريدين، وتربية النفوس، ومجالسة الصالحين، وهذا ما نجده صريحًا في السُنّة وسيرة النبي ﷺ.
أولًا: الأساس الشرعي من السنة النبوية
-
حلق الذكر في المسجد النبوي: عن النبي ﷺ قال: “إنَّ للهِ ملائكةً يطوفونَ في الطُّرقِ، يلتمسونَ أهلَ الذِّكرِ، فإذا وجدوْا قومًا يذكرونَ اللهَ، تنادَوْا: هلمُّوا إلى حاجتِكم، فيحُفُّونَهم بأجنحتِهم إلى السماءِ الدنيا ” “([1]) ؛ هذا الحديث يقرّ المجالس الجماعية للذكر، وهي أصل “الساحات” في بعدها الروحي، حيث يجتمع الناس لا على تجارة، ولا على جدل، بل على محبة الله ومراقبته.
-
جلوس النبي ﷺ مع أصحابه في المسجد: كان ﷺ يجلس مع أصحابه بعد الفجر، يحدّثهم، ويعلّمهم، ويذكرهم، وقد قال صلى الله عليه وسلم: “ما اجتمع قومٌ في بيتٍ من بيوتِ اللهِ، يتلونَ كتابَ اللهِ، ويتدارسونه بينهم، إلا نزلت عليهمُ السكينة” ([2]) ،أليس هذا وصفًا دقيقًا لما يحدث في الساحات الصوفية الأصيلة؟
فكلّ اجتماع يقوم على ذكر، وعلم، وأدب، وطلب وجه الله، هو في الشرع مأذون، بل محبوب.
ثانيًا: المقصد من الساحة عند الصوفية
الساحة الصوفية هي:
مجتمع روحي، يلتقي فيه الذاكرون والمريدون، تحت إشراف مربٍّ عارف، للتخلّق بأخلاق النبوة، وتزكية النفس، والتدرّج في مقامات السلوك.
فهي امتداد طبيعي لما كان في مسجد النبي ﷺ من:
-
تعليم
-
تذكير
-
مراقبة
-
صحبة صالحة
-
مجاهدة النفس
وقد شبّه بعض أهل العلم الساحات الصوفية بحال أهل الصفة، الذين لم يكن لهم دار إلا المسجد، ولا غذاء إلا الذكر.
ثالثًا: أقوال العلماء المؤيدين لمجالس الذكر الجماعي
قال الإمام النووي:
“الذكر الجماعي في المسجد سنة حسنة، ومأثورة عن السلف الصالح.” ([3])
وقال الإمام الغزالي:
“إن الاجتماع على الذكر والتواجد أمرٌ محبب، يزيد القلوب رقّة، والنفوس صفاء، وهو من السنن المهجورة التي ينبغي إحياؤها.” ([4])
رابعًا: شرط صحة الساحة الصوفية
لا تكون الساحة مشروعة إلا إذا:
-
خلت من البدع المخالفة للشريعة
-
وابتعدت عن الرقص غير المنضبط، أو خوارق العادات المفتعلة
-
واقتدت بهدي النبي ﷺ وسيرته في الذكر والتعليم والصحبة
فإذا اجتمع فيها الذكر، والقرآن، وتعليم المريدين، والآداب الشرعية، كانت من مواطن النور، لا من مواطن الابتداع.
خلاصة الإجابة على السؤال:
نعم، الساحة الصوفية – في جوهرها الصحيح – لها أصل شرعي في السنة النبوية، من خلال:
-
حلقات الذكر الجماعي
-
مجالس العلم والمراقبة
-
لزوم المسجد ومجالسة الصالحين
وهي امتداد عمليّ لروح النبوة في تربية القلوب، بشرط أن تظل منضبطة بالشرع، نقيّة من المبالغات، تبتغي وجه الله لا الرياء، واليقظة لا الغفلة.
س17: وهل توجد أوجه شبه بين المسجد في عهد النبي ﷺ وبين ساحات الصوفية؟
نعم، توجد أوجه شبه عميقة وجوهرية بين المسجد النبوي في عهد رسول الله ﷺ وبين الساحات الصوفية في صورتها النقيّة والمضبوطة، لأن كلاهما يُعتبر موضعًا لإحياء القلب، ومكانًا لاجتماع أهل الله، ومركزًا للذكر والتعليم والتزكية.
وإذا أمعنا النظر في وظيفة المسجد في زمن النبوة، سنجد أنها كانت تتجاوز حدود “العبادة الشعائرية” إلى أفق التربية الروحية والاجتماعية والتزكوية، وهذا هو الجوهر الذي تسعى إليه الساحة الصوفية أيضًا، متى كانت قائمة على العلم والذكر والتقوى والضوابط الشرعية.
أولًا: أوجه الشبه بين المسجد النبوي وساحات الصوفية
-
الذكر الجماعي وقراءة القرآن
-
في المسجد النبوي: كان الصحابة يقرؤون القرآن جماعة، ويتدارسونه مع النبي ﷺ، ويذكرون الله جهرًا كما ورد في الحديث:
“ما اجتمع قومٌ في بيتٍ من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم …” ([5])
-
في الساحة الصوفية: تُقرأ أوراد القرآن، وتُقام حلقات الذكر الجماعي، ويتربّى المريد على التلاوة والذكر، بنفس الروح، وإن اختلف الزمان والمكان.
-
التربية الروحية والتزكية
-
في المسجد: كان رسول الله ﷺ يزكّي نفوس الصحابة، يُعلّمهم الصدق، والصبر، والإخلاص، والورع، ومجاهدة الهوى، فكان المسجد “مدرسة السلوك” قبل أن يكون فقط مكانًا للصلاة.
-
في الساحة: يُربَّى المريد على يد الشيخ، ويُعلَّم السلوك، ويُؤدَّب في الحضرة، وتُطبَّق مفاهيم التخلية والتحلية والمراقبة.
-
الصحبة والمجالسة
-
في المسجد: كان يجتمع فيه أهل الصُّفّة، وهم نواة الصفاء الروحي والصحبة النبوية، يعيشون مع النبي ﷺ ليلًا ونهارًا، يتعلمون بالحال والمقال.
-
في الساحة: تكون الصحبة هي الأساس، ويُربَّى المريد بالمجالسة والأنس، ويتحقق معنى قولهم: “الصحبة مفتاح الطريق.”
-
شمول الوظائف وتعدد المقامات
-
المسجد النبوي لم يكن فقط للصلاة، بل كان:
-
مجلس علم
-
مقام تربية
-
محل قضاء
-
ملتقى اجتماعي
-
مركز انطلاق للدعوة والجهاد
-
-
والساحة الصوفية في أصلها النقي تقوم مقام:
-
التعليم الروحي
-
التزكية الأخلاقية
-
الذكر الجماعي
-
الاجتماع على الله
-
فكأنها وريث للمسجد من جهة الروح لا الشكل، ومن جهة الوظيفة لا المعمار.
ثانيًا: نماذج تؤكّد هذا الشبه
-
الجنيد البغدادي
كان يجلس في الساحة مثل مجلس المسجد، ويقول:
“نحن قومٌ جلسنا مع الله بالآداب، فوهب لنا مكاشفات المعاني.” ([6])
وكان مجلسه مجلس تعليم وسلوك، تمامًا كما كان مجلس النبي ﷺ.
-
عبد القادر الجيلاني
كان مجلسه في “الزاوية” ببغداد، تُقرأ فيه كتب الحديث، وتُذكر فيه الله، وتُربّى فيه النفوس.
وقد قال: “قِوام الطريق ثلاثة: علم، وذكر، وصدق صحبة.”
وهي نفسها ركائز المسجد النبوي في زمن النبوة.
ثالثًا: ما الفرق؟ يبقى الفرق في الشكل، لا في الروح:
-
المسجد النبوي كان جامع الأمة كلّها، والساحة الصوفية وُجدت في سياق الحاجة إلى مراكز خاصة للسالكين والمريدين، بعدما ابتعدت المجتمعات عن الروح النبوية الأصلية.
لـــذا : الساحة الصوفية – حين تكون منضبطة بالشريعة – تُعدّ امتدادًا روحيًا ووظيفيًا للمسجد النبوي في زمن النبي ﷺ.
فكما كان المسجد موطن الذكر، والتزكية، والتربية، كذلك الساحة في التصوف السنيّ النقيّ، تقوم مقام الحضرة الجامعة التي تُربّي وتزكّي وتُقرّب، لا فقط تقيم الشعائر.
فالاتصال بينهما ليس في الاسم، بل في المقصد، وهو: القرب من الله، وتهذيب النفس، وعمارة القلب.
الساحة المنهلية: نموذج معاصر للتصوف السني المعتدل على منهج أهل الله
في زمنٍ كثر فيه الالتباس بين معاني التصوف الحق، ومظاهر الانحراف الروحي، تبرز الساحة المنهلية كأنها واحة من نورٍ في صحراء التيه المعاصر؛ مشروعًا علميًّا وروحيًّا متكاملًا، يجمع بين صفاء العقيدة، ونقاء السلوك، وصدق السير إلى الله، تحت راية الكتاب والسنة، وبهدي أهل المعرفة الربانيين.
وقد تأسست الساحة على يد سماحة الدكتور أحمد سليمان أبو شعيشع، أستاذ بجامعة كفر الشيخ، ومفكر إسلامي بارز، وكاتب علمي وروحي في العديد من المجلات المتخصصة، وعلى رأسها مجلة الأزهر الشريف، ومجلة روح الإسلام، حيث يُعرَف بمنهجه المتوازن، الذي يصل بين تراث الأمة وروح العصر، دون إفراط ولا تفريط.
المرجعية الشرعية:
تستمد الساحة المنهلية منهجها من المرجعية الوسطية للأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية، وترتكز على وحدة الصف الوطني، وتُعلي من شأن التراث الإسلامي المصري المتصوّف، بوصفه حاضنًا أصيلًا للتدين السمح.
ملامح المنهج التربوي في الساحة المنهلية:
-
التوحيد الخالص والتعلّق بالله: يؤمن أهل الساحة أن لا مدد مطلق إلا من الله، فهو الرازق الشافي، بيده ملكوت كل شيء، يقول تعالى: ﴿ وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٖ فَمِنَ ٱللَّهِ ﴾ (النحل: ٥٣)، فالساحة لا تغلو في الأشخاص، ولا تعظّم إلا ما عظّمه الله.
-
التصوف على منهج السيدة نفيسة: المنهج الروحي للساحة قائم على الزهد الخالص كما عاشت السيدة نفيسة رضي الله عنها، من مجاهدة وعبادة وورع، ويترجِم عمليًّا قول النبي ﷺ: “ازهد في الدنيا يحبّك الله، وازهد فيما عند الناس يحبّك الناس” (ابن ماجه.
-
العقيدة على منهج الإمام أحمد بن حنبل: تعتنق الساحة عقيدة أهل السنة والجماعة كما قرّرها الإمام أحمد بن حنبل، بعيدة عن الجدل الكلامي والغلو العقدي، مؤمنة بأن الزهد والعلم صنوان لا يفترقان.
-
التمسّك بالسنة النبوية: تسعى الساحة إلى إحياء السنن المهجورة، وتعظيم ما صحّ من أقوال النبي ﷺ وأفعاله، مع التزام ظاهر وباطن بنهجه في الأخلاق والعبادة والمعاملة.
-
مجلس “منهل الخيرات”: قلب الساحة النابض؛ تعقد الساحة مجلسها الأسبوعي “منهل الخيرات” مساء كل خميس، وفيه تُتلى أنوار الصلوات على النبي ﷺ، بأسمائه الحسنى وصفاته العلا، ويُحيى فيه الذكر والدعاء، وتُتلى الأوراد المأثورة والمنهليّة التي أعدّها الشيخ أحمد سليمان، بعد مراجعتها من علماء متخصصين من الأزهر الشريف.
-
تزكية النفس ومجاهدات الطريق: تُعنَى الساحة بتطهير القلب من الكبر، والعُجب، والرياء، وسوء الظن، وتحثّ على التخلّق بالصدق، والصبر، والإخلاص، والرحمة، باعتبار أن السير إلى الله لا يُنال بكثرة الأعمال، بل بصدق الأحوال.
-
اتباع الصالحين دون غلو: تشجّع الساحة على محبة الصالحين والتعلّق بأهل الله، من غير تقديس أو غلو، بل بصحبة مبنيّة على العلم والأدب والاقتداء.
-
التزام صارم بالفتوى الأزهرية: لا تتلقّى الساحة منهجًا دينيًّا من غير ما أقرّه علماء الأزهر ودار الإفتاء المصرية، وترفض الفتاوى الخارجة عن هذا المسار، وتعتصم بكتب الحديث التسعة المعتمدة عند أهل السنة: من البخاري ومسلم، حتى الدارمي والإمام أحمد.
-
الابتعاد عن الجدل الديني والانقسام: تدعو الساحة إلى الوحدة والسكينة وترك الجدال العقيم، وتنهى عن المناظرات التي تفرق الصف أو تعكر صفو السير، فالهداية ليست في النزاع، بل في السكينة والاتباع، كما قال تعالى: ﴿ فَمَنِ ٱتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشۡقَىٰ ﴾ (طه: ١٢٣)
رسالة الساحة المنهلية في جملة:
“التصوف المعتدل… حياة مع الله”
ليس شعارًا دعائيًّا، بل مشروع حياة كاملة، يتصل بالله عبر الذكر، والعلم، والخدمة، والمجاهدة، ويبتعد عن الغلو والخرافة والكسل، جامعًا بين الشريعة والحقيقة.
في الختام:
الساحة المنهلية ليست مكانًا، بل مقامٌ روحي؛ هي امتداد صادق لما كان عليه أهل الصُّفّة في صحبة النبي ﷺ، مع وعي بالعصر، واستنارة بالعلم، ووفاء للتراث.
وقد وفّق الله مؤسّسها، الدكتور أحمد سليمان أبو شعيشع، أن يُعيد بعث هذا النور في قالب مؤسسي منضبط، يجمع بين الأصالة والتجديد، بين العرفان والعرف، بين السلوك والمجتمع، في زمان أحوج ما يكون إلى من يدلّ الناس على الله، لا على أنفسهم.
([1])البخاري. (صحيح البخاري، كتاب الدعوات، باب فضل الذكر).
([2])مسلم. (صحيح مسلم، كتاب الذكر والدعاء، باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن).
([3])النووي، يحيى بن شرف. (1996). الأذكار (ص 9). بيروت: دار الفكر.
([4])الغزالي، أبو حامد. (1986). إحياء علوم الدين (ج1، ص 390). بيروت: دار المعرفة.
([5])(1) مسلم. (صحيح مسلم، كتاب الذكر والدعاء، باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن).
([6])القشيري، أبو القاسم. (2002). الرسالة القشيرية (ص 109). بيروت: دار صادر.
يتبع ………..
 مجلة روح الاسلام فيض المعارف
مجلة روح الاسلام فيض المعارف